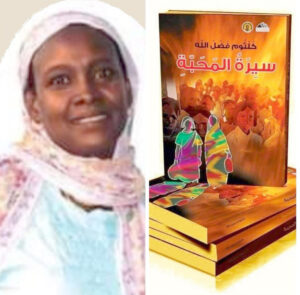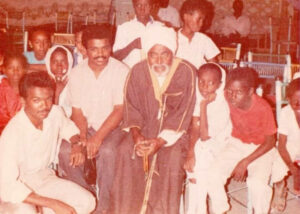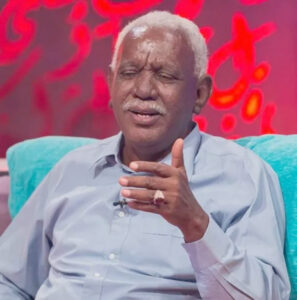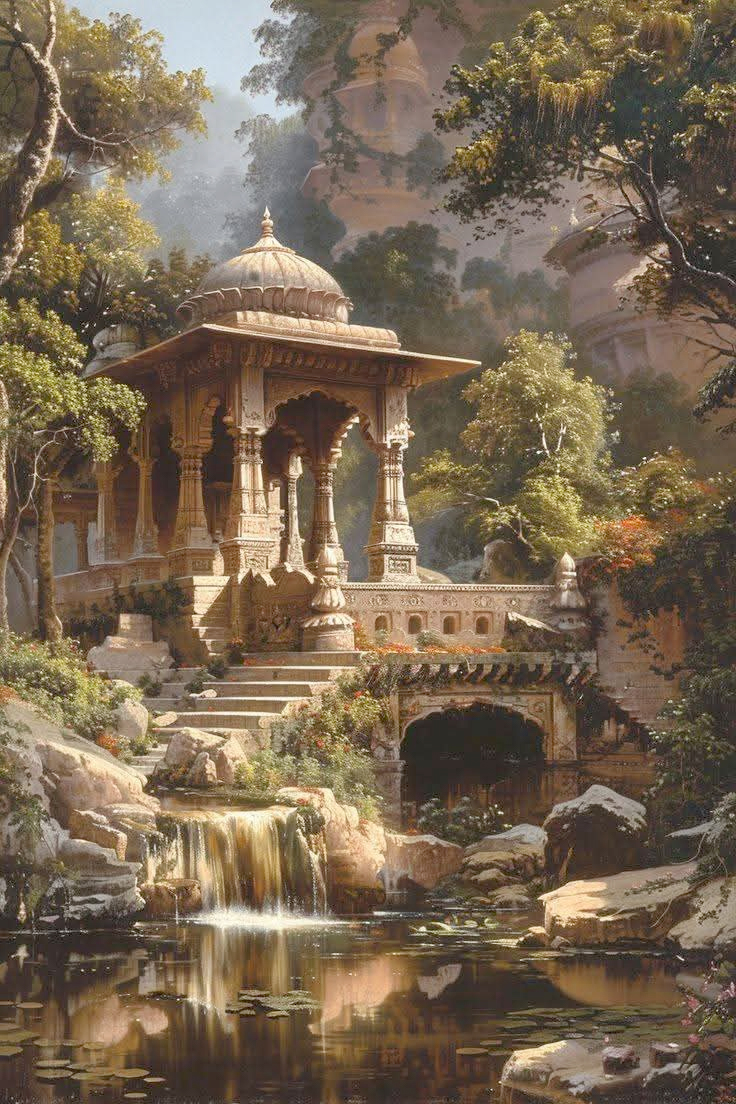

د. أسامة خليل
• منذ أن وطأت قدم الإنسان الأرض ظل يبحث عن سبل كسب العيش، وقد قادته سبل الكسب إلى التعرف على كيفية الحماية ومحاولات الارتباط بالأرض كموطنٍ ومكانٍ لميلادِ هُوية وثقافة تجمعه وأفراد أُسرته. قال بذلك علماء الأنثربولوجيا والفلاسفة وتوارثتها الأجيال من بعدهم. حيث بدأت مسيرة الإنسان على الأرض من خلال المعرفة التي كان أول اختبار تلقاه في حياته منذ أن خلقه الله تعالى «وعلم آدم الأسماء كلها».
والمعرفة هي التي سَمَتْ به فوق رتبة الملائكة كما ورد في النص القرآني وأكده في قوله تعالى:((وإذ قلنا للملائكة أسجدوا لآدم)). وعلى غير مايقوله رواد الفكر الغربي أنَّ الخطيئة هي التي أخرجت سيدنا آدم-عليه السلام- من الجنة، فإن القرآن الكريم في محكم تنزيله يقول:((وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة))، وهي خلافة سيدنا آدم في الأرض. ونعلم أن سيدنا آدم نزل إلى الأرض مسلحاً بالمعرفة التي نالها، ما يدحض فكرة الخطيئة التي ينبني عليها الفكر الغربي، وقد استخدم الإنسان المعرفة في الوصول إلى بناء التجمعات البشرية حتى يستطيع أن يتواءم مع الطبيعة من حوله فيعيش مع المطر والنَّار والسباع ويكتسي ويتزوج وينجب ويكِّون حضارة.
كما يخبرنا التسلسل التأريخي عند الغربيين-أيضاً- أن الإنسان بدأ حياته في الكهوف وغيرها من الغرائب التي تدور حول الإنسان الأول، حيث يرون أن المفهوم التأريخي لحياة الإنسان ولقيام المجتمعات المدنية كان بعد معاناته في الكهوف والغابات، وفي ثنايا ذلك نجده -أي الإنسان- حسب نظرية دارون للنشوء والارتقاء أن الإنسان أصله قردٌ. وكل النظريات التي حاولت أن تنال من الإنسان الذي كرمه الله سبحانه وتعالى وعلمه حتى نزوله إلى الأرض كان من أجل إقامة موقوتة لحكمة اقتضتها المشيئة الإلهية، وأصبح الاحتراب والتدافع والموت والحياة من سنن الحياة على البسيطة.
وندرك تماماً أنَّ الإنسان عندما نزل إلى الأرض كان يملك وسائل البعث الحضاري لإعمارها، ولايمكن أن يكون بهذه الصورة الشائهة التي رسمها الفكر الغربي عبر منابره الأكاديمية ومراكزه الثقافية والفكرية والتي لا تتواءم ونظرية المعرفة عند الإنسان عندما نزل إلى الأرض مسلحاً بها، لأن تكوينات الحضارة الإنسانية بدأت بنواة صغيرة تعيش حول نفسها تُعرف بالأسرة، سرعان ما اتسع أمرها نتيجة للتناسل، لتقيم مجتمعاً مصغراً حسبما وفَّر لها العقل الإنساني، تدافع عن نفسها ضد الأخطار والكوارث الطبيعية إلى أن وصلت إلى مرحلة الاحترام والتعايش فيما بينها في المجتمعات الكبيرة بعد ذلك.
وهنا يجب الإشارة إلى إن أغلب التجمعات البشرية التي نشأت فيها حضارات، قامت حول الأنهار ومصادر المياه، فحضارة الرَّافدين قامت على نهري دجلة والفرات وحضارة النَّيل قامت حوله، ومدن الصين إزدهرت على حوض نهر هوانج، والحضارة السُّلافية قامت على نهر الدانوب والفولجا، والأنجلو ساكسون والغالية على نهري السِّين والتايمز. وهكذا كان للماء أثره في تهيئة العقل الإنساني لإقامة المجتمعات البشرية وذلك تصديقاً لقوله تعالى:((وجعلنا من الماء كل شيءٍ حي)).
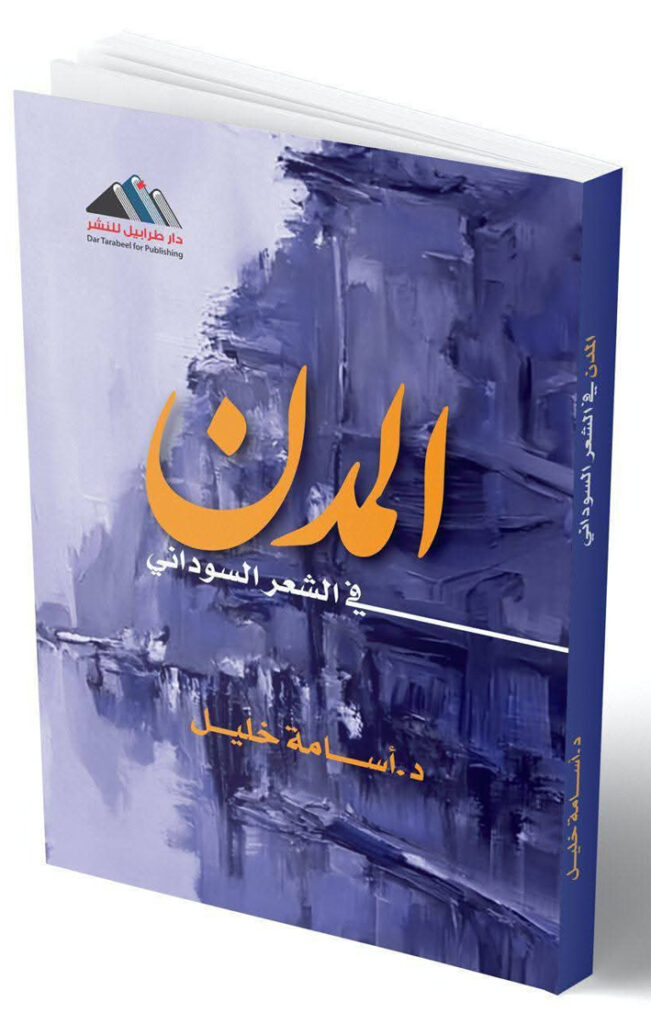
وحين ألزمته الحاجة إلى وجود قيادات تسنده كون ما يعرف بالعقد الاجتماعي؛ فنتجت من هذه النظرية نظرية الحاكم والمحكومين، وهي ماتحدث عنها فلاسفة أوربا من أفلاطون وحتى سيشرون وجان جاك روسو يقابلهم في الشرق المسلم الفارابي وابن رشد، إلا أن أشهرهم على الإطلاق كان مؤسس علم الاجتماع عبد الرحمن بن خلدون صاحب المقدمة، وعلى أساس هذا العقد جاءت المدن دولاً بأكملها.
وفي الغرب عرف الناس الإقطاعيات أو مايعرف بـ»Couty»، كما عرف الإنسان الإقطاعيات في شكل دول مثل أسبرطه وأثينا وروما، وعلى البحر الأبيض المتوسط دول قرطاجنه والكنعانيين في بعلبك والأشوريين في بابل، ولكن تظل دمشق ومدن النيل وطيبه ومدينة الشمس في هليوبوليس ثم كرمة في الجنوب وفرص وأكسوم من أقدم المدن على وجه الأرض. يشير هذا إلى أنَّ العقل الجمعي للإنسان قاده لخلق ثقافة بمعناها العام وهي جُمَّاعٌ لسلوك الإنسان في مجتمع ما في الزمان، ليلبس ثوب حضارة ما، سواءٌ كانت نيلية أو إغريقية أو آشورية أو بابلية وغيرها. بعد ذلك استقر الحال على ما يعرف بالإقطاع، وهو نوع من التعايش بين الحكام والمحكومين في مدينة ما، حاكمها هو المالك لكل شيء في الأرض من إنسان وزرع وضرع، ومن ثمَّ تطورت الإقطاعيات بفعل الحروب إلى تجمعات أكبر أفرزت فيما بعد ما يعرف بالدول، وظهرت نظريات الوطنية والقومية وما إلى ذلك.
وحينما كانت الدول في شكلها الذي يقارب وضعها الحالي، عرف الإنسان المدينة العاصمة وهي كُبرى المدن، وتُعرف عندهم بالمدينة الـ»City»، «Citydom»، ثم المدينة المحورية»Metropolitan»، وهي عاصمة الدولة المعنية.
ظهرت بعد ذلك الدول الكبرى التي أسسها الروم والفرس وأهل العراق وأقدم مدينة عرفها العرب بعد دمشق، كان فيها حاكم ومحكومين هي مدينة الحيرة التي كان يحكمها المناذرة، ثم تدمر في الأردن والقدس، وبعد ذلك ظهرت المدينة التي نعرفها اليوم وكان الدين ذا أثر عميق في تجمع الناس حول المدن، وكذلك أثر المعرفة والعلم في تكوين المدن وقيامها.
ظهرت المدن الغربية الحديثة عقب الانقلاب الصناعي في فجر القرن التاسع عشر كتبت سطرها الأول ألمانيا ودول غرب أوربا نتيجة لظهور الآلة وتأثير التبادل التجاري إلى جانب التقدم التكنولوجي الذي صاحب الثورة الصناعية؛ فأصبحت الصناعة العامل الأول في قيام المدن. وقد بدأت بظهور المدن الضخمة في بريطانيا وأشهرها مدينة لندن، ثم تبعتها باريس وغيرها من المدن الحديثة هناك.
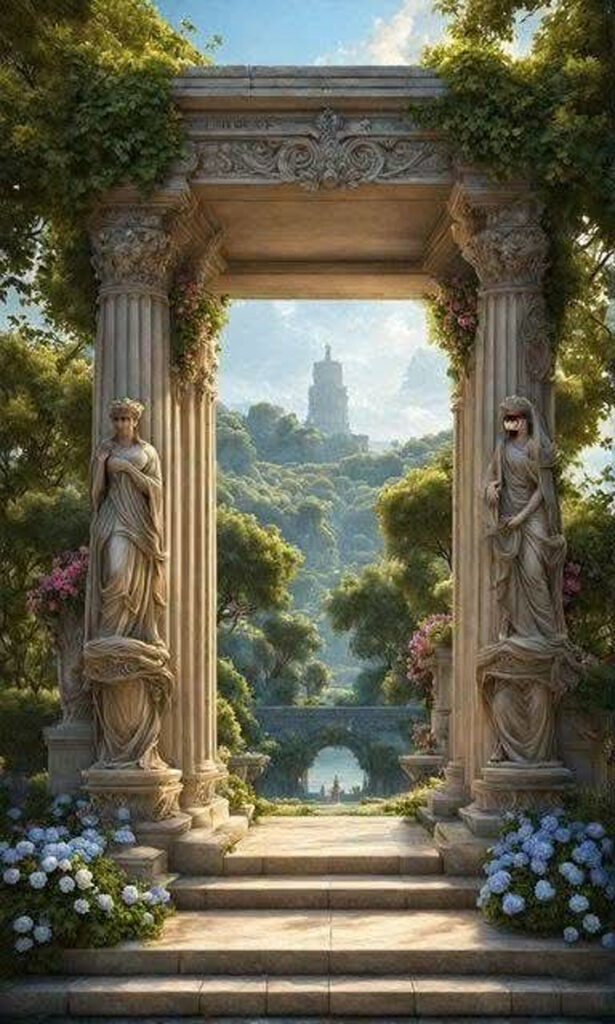
أما المدن في عالمنا العربي فهي إما مدنٌ للدين أو مدن تجارة. فدمشق كانت أهم مدينة تجارية في المشرق العربي ومدن النيل القديمة قامت حول معتقدات الفراعنة على اختلافها. وفي جنوب الجزيرة العربية كانت هناك مدينة صنعاء، أما الحيرة فكانت امتداداً للتداخل الفارسي في جزيرة العرب ومدن التخوم مثل اليرموك وتبوك ومؤتة وغيرها، كانت قواعد حربية حدودية تقف بين الروم والعرب أو الفرس والعرب.
إزدهرت المدن التي أفرزها العالم العربي أو الإسلامي عقب الفتح الإسلامي، ولعل بغداد تقف شاهداً على هذا النوع من المدن وكذلك دمشق والبصرة والكوفة والقاهرة والقيروان وغيرها. وبعكس ما ذكرنا تأتي مكة استثناءً فهي مدينة قديمة قدم التاريخ وموجودة قبل خلق سيدنا آدم عليه السَّلام أُختيرت لتكون منطلقاً للدين الإسلامي وموئلاً لنبينا الكريم سيدنا محمد صلَّى الله عليه وسلم، ولهذا ظلت هذه المدينة بالذات مركزاً تجارياً أفرز العديد من التجمعات من عهد سيدنا إسماعيل وقصته المشهورة. وكذلك المدينة المنَّورة على صاحبها أفضل الصلوات وأتمُّ التسليم والتي كانت تسمى قديماً بـ»يثرب»، ثم عُرِفَتْ بدار الهجرة والتي ظلت مركزاً تجارياً تربط بين الجزيرة العربية وبلاد الرافدين والشام وبين صنعاء والحبشة.
شارك المقال