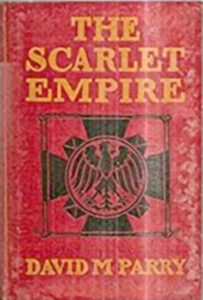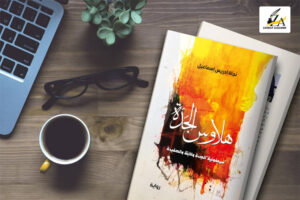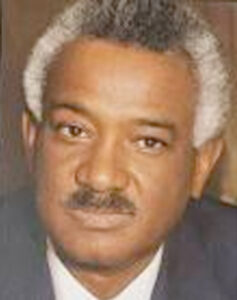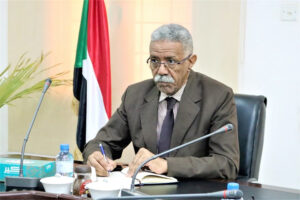حاوره : محمد نجيب محمد علي
• «من أراد أن يعيش سعيدا فى حياته وشاعرا فعليه بالحياة فى السودان» جاءت هذه الكلمات من الشاعر العراقى والكاتب الرحالة باسم الفرات فى فعالية ثقافية أقيمت فى إتحاد الكتاب والأدباء فى مدينة النجف ، وباسم فرات يعد من المع شعراء وكتاب العراق وله إصدارات عديدة فى الشعر وأدب الرحلات وكتابة السيرة ، وقد تناول تجاربه الكثير من النقاد ، وسبق له أن فاز بجائزة إبن بطوطة فى أدب الرحلات عام 2013 – 2014 بكتابه «مسافر مقيم .. عامان فى أعماق الأكوادور» كما حصل مؤلفه الحلم البوليفاري .. رحلة كولمبيا الكبرى بالجائزة الأولى لأدب الرحلات عام 2015 ، وترجمت أعماله إلى اللغة الإنجليزية والإسبانية ، وكان يعيش بالسودان منذ العام 2014 حتى قبل سنوات قليلة وصدر له ديوان « محبرة الرعاة من دار المصورات بالخرطوم ودارصهيل للأنباء والنشر بالقاهرة عام 2017 ، وتحتوى هذه المجموعة على عناوين عديدة إستلهمها من حياته بالسودان منها «سودانيون» «الخرطوم» «أمدرمان» «سوق السمك فى أمدرمان» «جبل البركل» «النيل الأبيض النيل الأزرق» «أتنيه» وعناوين أخرى يقول فى قصيدته الخرطوم
أحب هذه المدينة
نهرها وطرقها الترابية
عتاليها وباعتها
هوس سائقيها بالتمرد
والأطفال عند الإشارات الضوئية
حاملين سلال بؤسهم ليملأوها بالتوسلات
أحب باسقاتها يمشطن النسيم الخجول
بين أحضان النيل
أحب السيدات اللواتي تأزرن إفريقية
وعلى الطرقات يبعن الشاي
بالنعناع المتبل بالسكر
وفى قصيدته « سودانيون « يروى وهو يستمع لأقوال مزارع عجوز يفلح الأرض ويخاطبه :
يا عراقى
هنا جاء إدريس وجد يعرب
وفى قاع هذا النيل
كنوز سفن الغزاة وعطر عذروات
هل تشم ؟
ولباسم فرات حضور فى المشهد الثقافي السوداني فى الفعاليات والندوات .
إلتقينا وكان هذا الحوار عن التجربة والسودان والكتابة فى الشعر وادب الرحلات.

• قلت فى فعالية ثقافية لك فى العراق أن من يريد أن يعيش حياته سعيدا فعليه أن يذهب للسودان وأنت تعيش فى السودان منذ العام 2014 .. ترى ما الذى دفع الشاعر باسم فرات لذلك القول؟
– كان ذلك في اتحاد الأدباء والكتاب في العراق فرع النجف، وهي حقيقة فمنذ وصولي إلى السودان في الخامس من شهر آب/ أغسطس من عام 2014 ميلادية، وحتى الآن لم أجد إلّا الكرم والحفاوة والمحبة، ولا يعني هذا عدم وجود منغصات ولكن النصف الممتلئ من الكأس يكاد يكون في حقيقته تسعة أعشار الكأس.
• مجموعتك التى صدرت أخيرا بعنوان محبرة الرعاة عن دار «المصورات» بالخرطوم، ودار «صهيل» بالقاهرة تحمل العديد من العناوين «أمدرمان»، «الخرطوم» «سودانيون» «سوق السمك فى أمدرمان» «الشمس تستحم فى النيل» «طهارقا» «أتنيه» «كوستي» «جبل البركل» وعناوين أخرى. كيف تنظر إلى مفهوم المكان فى التجربة الشعرية وماذا عن التنوع الجغرافى داخل السودان ؟
– أنا ابن مدينة، وأظن أن هذا سببًا وجيهًا أن لا يجعلني أحمل ضغينة على المدن، أنا ابنها، فضلًا عن أن مدينتي لا تبعد عن الريف، بل يمكننا أن نسير على الأقدام لنصل إلى ريفها، وهذا ربما جعلني متصالحًا مع الأمكنة، فضلًا عن كثرة التنقل بين البلدان والثقافات؛ كل مكان عندي هو أليف، أزرع فيها ذكريات ومحبة، فأقطف ألفةً وحنينًا، والحنين نوع من الوفاء.
أما التنوع الجغرافي في السودان، فيمكنني القول بعد رؤية مساحات واسعة من السودان، إن مشروعًا سياحيًّا عملاقًا ممكن أن يجعل السودان أرقى مشاتي العالم، وسيكون المكان الأثير لكل شعوب البلدان التي تتميز بشتاء تكلله الثلوج، لقضاء عطلهم الشتوية فيه.
• كتبت فى مقال نشر لك أن المجتمع السوداني فى أعماقه متحف للتنوع اللغوي والعرقي وذهبت إلى أن هذا التنوع مصدر ثرائه وابداعه ؟
– كل تنوع ثراء إن كان بيئيًّا أو لغويًّا، والسودان بحق يستحق أن يوصف بأنه متحف للتنوع اللغوي والعرقي والاختلاف الواضح في السحنات وفي الأشكال وطبيعة الأجسام، هذه التي يميزها المهتم بعلم الإناسة «الأنثروبولوجي» وهو الذي منح السودان الطيب صالح ومئات من المبدعين الآخرين الذين وقف خجلهم وتواضعهم حائلًا دون الحصول على الشهرة المستحقاة على عربيًّا.
وهذا التنوع يستحق الاحتفاء به وإبرازه والتباهي به داخليًّا وخارجيًّا، أي على المستوى المحلي والمستوى الدولي، لأن في ذلك قوة ومتانة للمجتمع ولا أعني السودان فقط بكلامي بل أعني كل بلد متعدد اللغات والعقائد فهو يتمتع بثراء وقوة وانفتاح إنساني تصون المجتمع من الجدب والتقوقع والأحادية، لأن الفرد في هكذا مجتمعات ينمو وهو يرى ويلمس ويتعايش مع هذا التنوع الثر.
• زرت الكثير من المواقع الأثرية بالسودان وبعضها كان مصدر إلهام لك فى كتابة بعض النصوص الشعرية « كرمة، كريمة، مروي، المصورات، النقعة، نوري، وغيرها « وتحدثت عن الغبن الذي وقع على الحضارة السودانية في مقالاتك ؟
– لا شك أن رحلاتي للمناطق الأثرية في السودان كانت تجربة معرفية وجمالية، أدت إلى كتابة مجموعة من القصائد التي ضمتها مجموعتي الشعرية السابعة «محبرة الرعاة» وازددت ثقافة بالسودان وتاريخه، وآلمني أن الحضارة السودانية تكاد أن تكون مجهولة، أو على الأقل لم تحصل على ما تستحق من الشهرة التي حصلت عليها حضارات أخرى مجاورة أو بعيدة؛ وقد عملت عبر موقع التواصل الاجتماعي «الفيسبوك» أن أُعرّف بهذه الحضارة فنشرت عددًا كبيرًا من الصور التي التقطتها لهذه الآثار، بل وكتبت عدة مقالات عن السودان نشرتها في مجلات وصحف عربية.
وكلما تأتيني رسائل أو أقرأ ردة فعل القراء عبر التعليقات أيضًا، عن دهشتهم بجمال السودان وحضارته، ورغبتهم بزيارة السودان، أجدني في حالتين في آنٍ واحد، حالة الفرح أنني أقدّم صورة إيجابية يستحقها السودان، وحالة حزن أن هذا البلد الجميل مجهول من قِبل الآخر، فكثيرًا ما سألوني باستغراب: أوَهل ثمة أهرام في السودان؟ ويزداد استغرابهم حين أجيبهم أن في أرض النيلين 220 هرمًا.
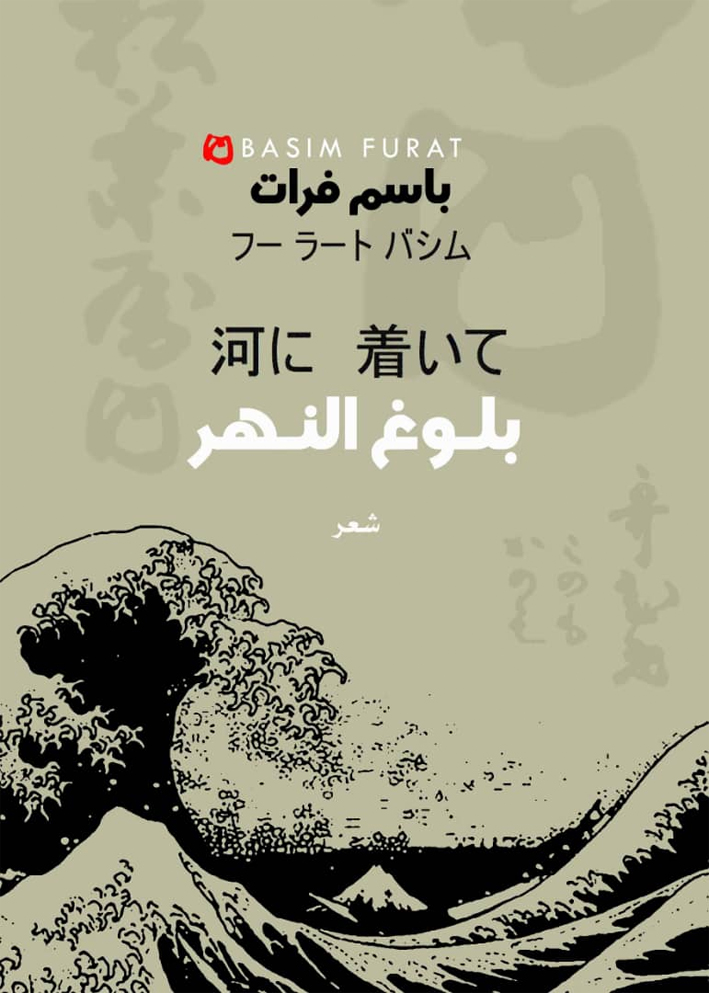
• عملت فى مهن مختلفة خبازا ، ثم فى صناعة التحف النحاسية ثم أخيرا بالتصوير الفوتوغرافي ، كشاعر كيف تنظر للعلاقة بين المهنة والكتابة ؟
– العمل المبكر وتعدد الحِرف تمنح خبرة وتجربة عميقة للشاعر والكاتب، في وضع يد المبدع على نبض الشارع، وأعماق المجتمع، وهذا لا يمكن أن يُتاح لمن يقضي أعوامه بين مقاعد الدراسة فقط ثم يتوجه للعمل في المكاتب المكيفة، وهذه التجربة الطويلة والتي ابتدأتها خبازًا وأنا في السابعة من عمري، منحت قصائدي عبق الحياة، ففيها نكهات وألوان وروائح الأسواق، ولم استغرب حين قرأت في مهرجان الجواهري (بغداد 2018) أن قال لي أحد الأصدقاء الأدباء «لو لم أعرفك لقلت إن شاعر هذه القصيدة لم يغادر يومًا العراق، وعاش كل مآسي الحروب والحصار والطغيان والظلم والتفتت والتشتت والتمزق الذي أصاب العراق وطنًا ومجتمعًا وهُوية».
إن العلاقة بين العمل في الأسواق ( خباز، حَذّاء، بائع أكفان، صناعة التحفيات النحاسية بكل ما تحويه من ماء النار والمواد السامة الخطيرة، والتصوير) والكتابة، تضخ روحًا دفاقة في كلمات النص الإبداعي، يشعر القارئ بصدق النص وتصله حرارة التجربة الحياتية عفويًّا بلا وسائط، وهنا يكمن فضل العمل الطويل والشاق الذي يأخذ سنوات طويلة من عمر الكاتب وفي المقابل يمحنه مصداقية عالية.
• أنت من كتاب قصيدة النثر وهناك من يرى أن قصيدة النثر لم تؤسس لمشروعها الإبداعي بعد رغم أنها بدأت فى عالمنا العربى منذ ردح من الزمان سليم بركات ، الماغوط وأنسى الحاج وآخرون؟
– لن ينتهي الحديث عن قصيدة النثر ومشروعيتها، ومهما قيل فلن يسكت المعارض ولن يتخلى عنها المؤمن بها، وستبقى تُحارب لعقود قادمة وتُتهم شتى الاتهامات، لكنها ماضية ولن تتراجع، والتهم الجاهزة بحقها مثلًا أن مئات اقترفوا كتابتها لسهولتها، وهذه تهمة واهية، لأن هؤلاء ليسوا بشعراء، وأن ما من شاعر حقيقي إلّا وستجده قارئًا للتراث ملمًّا بأصول الكتابة بما في ذلك أهمية وضع الفارزة والنقطة والتعجب والاستفهام وغير ذلك.
إذًا، لا يمكن أن يتم إقصاء هذا الجنس الإبداعي لمجرد أنه يخلو من الوزن والقافية ولأن آلافًا اقترفوا كتابته وهم غير مؤهلين، هذه مشكلتهم وليست مشكلة قصيدة النثر.
• هناك من يرى أن مرجعيتها غربية وليست عربية ؟
– علينا أن نؤمن بتلاقح الحضارات مثلما نؤمن بتلاقح الأجناس الأدبية، ومَن يريد أن يجعل من دعواه بأن مرجعيتها غربية دليلًا لإقصائها فهذه دعوة غير متّزنة، ولن توقف استمرارية قصيدة النثر.
• ماذا عن النقد الحداثي وهل استطاع أن يواكب التجارب الشعرية الجديدة ؟
– عادة ما أذكر حقيقة بل أذكّر بها، وهي أن عدد الشعراء قبل خمسين عامًا كان قليلًا وعدد النقاد كان أقل بقليل من عدد الشعراء، فأشبعوا نقدًا، ولكن مع ثورة التعليم في العالم العربي، رفعت من عدد المتعلمين بشكل لم يسبق له مثيل، فتضاعف عدد الشعراء مئات المرات، بينما لم يتضاعف عدد النقاد كثيرًا، ما أدّى إلى فجوة كبيرة، لا يمكن ردمها، بلا شك النقاد يملكون صك براءتهم، فما عساهم أن يفعلوا أمام هذا السيل الهادر من الشعراء باللغة العربية.
لا أتهم النقاد وأجد أن من الضروري محاولة أن تقوم الجامعات بخلق نقاد أكاديميين أكثر وأن ينفتح الدرس الأكاديمي على النقاد جميعًا لخلق نقاد يحملون مؤهلات أكاديمية وفي الوقت نفسه يحملون جمرة الإبداع في النقد.
• وأنت من دعاة التجريب فى الكتابة الشعرية ، وذكرت أن التجريب هو رفض للغة التداولية فى القصيدة ، ماذا تعني وما أهمية التجريب؟
– اللغة التداولية، هي اللغة التي أكثر الشعراء من تداولها في نصوصهم الشعرية، فأصبحت مكررة للغاية مثل «في الهزيع الأخير من الليل، واشتعل الرأس شيبًا، هزي إليك بجذع القصيدة» وعشرات الجمل التي كررها عشرات الشعراء، وهنا يكون التجريب الابتعاد عن كل هذه الجمل، وخلق لغة خاصة وجمل شعرية جديدة وأسلوب متفرد؛ بعبارة أخرى يمكن أن نوجزها: على الشاعر أن يكتب نفسه ولا يسمح بأن يُغرّد في حنجرته أحد سواه.
• صراع الهوية في عالمنا العربي يطرح أسئلة كثيرة، كيف تقرأ هذا الإشكال ؟
– صراع الهوية، إشكالية عالمية بامتياز، ولكنها تبرز أكثر في الدول الأقل استقرارًا ورفاهية وتفتقر إلى مقومات المجتمع المدني الديمقراطي المؤمن بحرية العقيدة، فلا تجد أسرة تغضب لترك أحد أفرادها عقيدة ما والانتقال إلى عقيدة مختلفة مثلًا، كذلك فإن أغلب الدول التي تعاني من صراع الهوية، تفتقر لمراكز بحوث كثيرة ورصينة، فضلًا عن افتقارها لتقاليد ثقافية عند النخبة وعند طبقة القراء، بالاهتمام بالتنوع اللغوي والديني والمناطقي.
وهذا يقود إلى تراكم الأخطاء، ومنح المتطرفين من فئات المجتمع كافة فرصة سانحة لتكريس خطاب ينحو نحو التطرف وقد يقود إلى التعالي والكراهية، فخلق أمجاد وماض عظيم، في منطقة شهدت هجرات عديدة وتنوع عرقي واختلاطًا على مدى التاريخ، يصبح من غير المعقول علميًّا أن مجموعة ما تنتسب دون سواها لحضارة من الحضارات التي سادت في منطقتها؛ إن الإقصاء الحقيقي حين ترفض الإيمان بأننا جميعًا ورثة ماضينا بكل زهوه ومجده وعظمته، وكذلك بكل دمويته وعنفه وأخطائه.
• قلت أن السودان بوابة العرب لأفريقيا ؟
– بل وبوابة إفريقية إلى العرب، وموقع السودان يجعله متفردًا حقًّا، راجيًا أن تدرس الجامعات ومراكز البحوث هذا الموقع الستراتيجي حتى يستغل أفضل استغلال، وهذا سيعود على السودان بالشيء الكثير، فعلى الرغم من وجود شعور عند عديد السودانيين ولكني أعتقد أن الأمر لو خضع للدرس الأكاديمي، وتوضع الخطط مثلًا ترجمات روائع الأدب من اللغات الإفريقية إلى العربية، وتعريف العالم العربية بإفريقية وهذه مهمة تتوفر لها قاعدة في السودان، والمطلوب كي يتم تفعيلها أكثر وبعلمية صارمة، وعلينا أن نتذكر أن السودان كان طريق الحجيج من غرب إفريقية إلى البحر الأحمر ومن هناك يركبوا البحر، أليس هذا الطريق يحتاج أن يتم الحديث عنه والتعريف به على نطاق العالمين العربي والإفريقي، لأني حين تحدثت بهذا الأمر لم أجد غير سوداني يخبرني بأنه قرأ عن هذا الطريق، وهو طريق يمكن أن يكون رمزًا للسلام والتعاون العربي – الإفريقي.
• هنالك من يرى أن أدب الرحلات هو ملتقى معارف متعددة ، وهو سجل تاريخي وجغرافي وثقافي، ترى كيف نجحت كشاعر بالفوز بجائزة أدب الرحلة لمرتين ، هل من علاقة ما بين الإبداع والتدوين؟
– أنا ابن ثقافة تدوينية، فالثقافة العربية تملك أكبر تراث تدويني بين لغات العالم قاطبة، أؤمن أن الشفاهي زائل والتدوين يبقى، مثلما أؤمن أن الخوض في عوالم الثقافات يمنح وعيًا عميقًا وثقافة موسوعية، وقد لاحظت التحفر الذي جرى في مخيلتي ووعيي وتفكيري بعد تنقلي بين بلدان عديدة وثقافات متنوعة، لكن يجب أن أعترف بأن كثيرًا من نقاط الوعي المضيئة والتي حسبتها قد تكونت نتيجة هذا الترحال والسفر، إنما هي بذرت بذرتها الأولى في مسقط رأسي، ونمت وترعرعت في المنافي، واكتشفت هذا الأمر حين عدت إلى العراق بعد غربة امتدت لسنوات طويلة.
إن التدوين وثيقة وبرهان على نشاط ما، إن كان هذا النشاط فرديًّا أو كان جماعيًّا، ففيه نستدل على الحقيقة أو على جزء منها، ومثلما منافٍ للعلم والحقيقة أن تنسب مجموعة سكانية «عرقية» نفسها لمدن وبلدات ما تم تدوينه قبل مائة عام كله أو معظمه ليس بلغتها، أو مجموعة شفاهية تزعم حقًّا قوميًّا أو تاريخيًّا بمدن وبلدات في بلد كتابي مثل العراق على سبيل المثال، كذلك أرى أن أحد شروط الإبداع هو التدوين، وأن العلاقة بينهما ضرورية لحفظ المنتج الإبداعي وحقوق مبدعيه، بل وحفظ حق الأجيال القادمة بالاطلاع على هذا المنتج الذي أبدعه الأباء والأجداد والأسلاف.
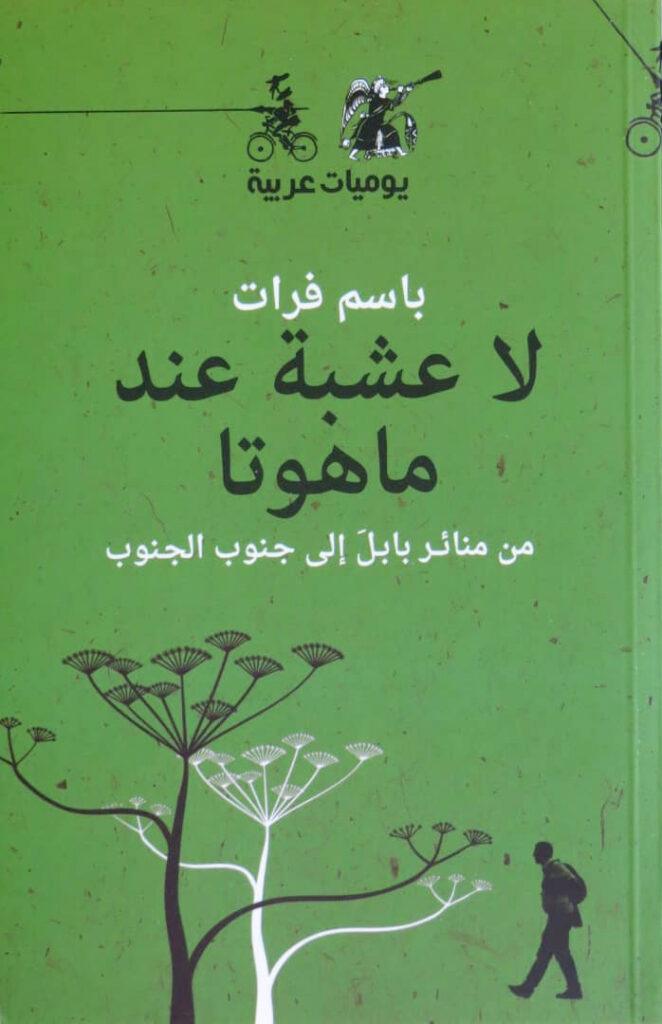
• من خلال تواجدك ومشاركاتك فى الحراك الثقافي والإبداعى السودانى كيف قرأت الإبداع السوداني ؟
– إبداع ثر بلا شك، ويحتاج إلى التسويق، فقد قرأت واستمعت لشعراء يملكون تجارب طيبة، وكذلك قرأت وسمعت لقصاصين وروائيين ونقاد، والشباب بعضهم تجاربهم على الرغم من أنها غضة ولكن تستحق الإشادة راجيًا أن لا تخفت جمرة الإبداع ويخفت معه حماسهم.
شارك الحوار