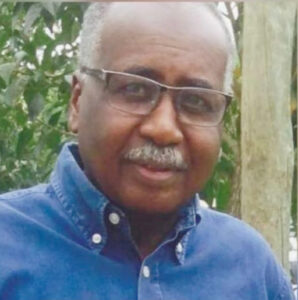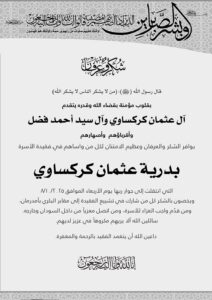حوار: نجيب محمد علي – عامر محمد أحمد
• على عتبات الكتابة الجديدة في تقنيات الخطاب وفلسفة الحياة، تمضي الكاتبة الدكتورة إشراقة مصطفى في مشروعها السردي والشعري والترجمي. تتوسع الكاتبة في بحثها وتستند في سيرتها الذاتية على تصميم للوصول إلى محطات النجاح، ولها من ذخيرة ثقافية ما يقود خطاها.
التقيناها وتجاذبنا معها أطراف الحوار، فإذا بها تقف على المتون كلها برؤية واضحة وعميقة ومعبرة عن عوالم مدهشة تملأ الأفق بجمال الفكرة.
• نبدأ بملامح من السيرة الذاتية؟
– إشراقة مصطفى حامد، من مواليد كوستي 16 سبتمبر 1961، درست المراحل الدراسية الأولى في كوستي، وتشكّل وجداني وحديقة وعيي المشوّكة والشائكة في هذه المدينة المعروفة بتعددها وتنوعها. درست بجامعة أم درمان الإسلامية وتخرجت بدرجة الشرف في الصحافة والإعلام في يونيو 1989، ثم أنجزت الدبلوم العالي بكلية الدراسات العليا – معهد الدراسات الإضافية بجامعة الخرطوم. هاجرت مضطرة بعد أن ضاقت بي البلاد الواسعة لأجد نفسي في فضاء أبرة مواجهة الذات في النمسا، حيث واصلت الماجستير في كلية الإعلام وعلوم الاتصالات وأنجزته في الوعي البيئي عند المرأة السودانية خلال جهاز الراديو، ثم تابعت الدكتوراه بكلية العلوم السياسية بجامعة فيينا وأنجزتها في العام 2006، وعملت في ذات الكلية كمحاضرة غير متفرغة لمدة خمسة سنوات. أعمل الآن ممثلة الأدب العربي للقلم النمساوي وأنسق مشاريع إبداعية مرتبطة بالكتابة. هذه هي السيرة المتعارف على تداولها، ولكن يبدو لي أن سيرتي مرتبطة بروح بعيدة، منسربة وضاربة بجذورها في أعماق البحار، ولا تنفصل عن مخلوقات الله من شجر وريح وماء. سيرة لا ولن تكن دون الإنسان، وتحديداً إنسان السودان العظيم.

• لماذا الكتابة؟
– وكأن السؤال: لماذا الحياة؟! الكتابة مشروع حياتي، ولا يمكن أن أتخيل نفسي بلا كتب وكتابة، بلا أقلام وأوراق. سؤال «لماذا الكتابة» يرتبط بسؤال أساسي هو «لماذا القراءة؟» فالقراءة تعني عندي حبوب لقاح الكتابة، ولولاها لما كتبت. الكتابة هي مشروع الوعي وثقابه الذي يقود إلى التغيير. الكتابة هي سؤال وجودي وجدواه، هي سؤال الانعتاق. استحضر محمود درويش: (نُؤرِّخُ أيامنا بِفَراش الحُقُول، هَبطْنا سَلاَلم أَيَّامِنَا صعدْنَا على مَا يغيبُ من السِّنْديَان. تركْنَا غِيَاباً لأوْهَامنَا وَسِرْنَا إلى الشِّعر نَسْأَلهُ أَنْ يُجدِّدَ أرْضاً لإلْهَامنا فَسَدَّ عَلَيْنا جهَاتِ الرَّياح، وَصار هُويَّةَ أَصْنَامِنَا سَنَكْتُبُ منْ أَجْلِ ألا نَمُوت… سَنَكْتُبُ)… وأقول: أكتب لأحيا، أتنفس، أفرح، أتوزان. الكتابة ليست ترفاً بل حيوات نتحرك في مداراتها وتخرج بنا من وإلى مغارات النفس القصية.
• سيرتك الذاتية «أنثى الأنهار» وجدت قبولاً واسعاً، نرى ما هي مرجعيتك الثقافية في كتابة السيرة؟
– مرجعيتها هي الواقع الذي ولدت وعشت فيه، تلك البيئة التي شكلت وجداني ودرّبتني على الحياة وعلى مواجهتها. سيرة استمدت طاقاتها من سيرة الناس وتفاصيلهم، أشواقهم وحنينهم، تصالحهم رغم الإفقار.
مرجعيتي هي هذا الثراء المعرفي المُبهج من سيرة الحبوبات المنسيات، سيرة النساء المسكوت عنها وكفاحهن اليومي، كفاح الآباء والأجداد، السيرة الشفاهية من الحكايات اليومية، تفاصيل الخبز والمحبة والسلام النفسي، تفاصيل شكلت مرجعيتي منذ أن كنت طفلة تكتشف طريقي وتتلمسه. حكايات ربات البيوت ساعة القهوة وقلي البن، نقرشة الفناجين في ذاكرتي ظلت كل هذه الأعوام ولم تقف فيينا بكل جمالها واختيارها للمرة السابعة كأفضل مدينة في العالم تصلح للعيش، أن تحجب عني تلك الذاكرة وتلك الروائح، رائحة القهوة والحلومر والبيوت القديمة.
• يرى البعض من النقاد أن للمرأة خصوصيتها في الكتابة التي تختلف عن الرجل؟
– بالطبع لها خصوصيتها، فالكتابة لا تهبط من السماء بل هي انعكاس الواقع، استلهام تفاصيله واستشراقه في أحلام وأشواق النفس البشرية. فلو ألقينا نظرة إلى وضع النساء منذ كنا صغيرات وما تعرضن له من تمييز وأمامنا المواد الدراسية، منذ أمل وبدر، أمل التي يتم إعدادها منذ ذلك العمر لتكون أقل من بدر الذي تقوم هي ذاتها في مقبل الأيام بغسيل ملابسه. القيود المضروبة عليها من المجتمع وحركة نضالاتها الطويلة جنباً إلى جنب مع الرجل المؤمن بحقها في الحياة الكريمة وأن حقوقه كإنسان لا تنفصل عن حقها كإنسانة. من هنا تأتي خصوصية كتابتها وطرحها لأحلامها وأشواقها، هواجسها وحنينها للأمان.
> يقولون إن هناك انفجاراً روائياً.. وأن الرواية أصبحت ديوان العرب؟
– صحيح هناك انفجار روائي خاصة في السودان في السنوات الأخيرة، ولكن يظل الشعر سر الروح السادر في الوجدان ويظل الجمرة التي تحتفظ بلهيبها دون انطفاء.
• هل تشعرين أنك حرة في الكتابة والتعبير عن نفسك وعن قضايا المرأة وأنت خارج الوطن؟
– الحرية؟ المكان بالتأكيد يلعب دوراً وصحيح أن لا رقابة هنا ولكن الرقابة الأخطر هي رقابة الذات، وهذه قد تكون مسيطرة على البعض حتى وهم خارج السودان. بدأت في فرد ريش حريتي منذ أن بدأت أعي ضرورة الكتابة وأكون نفسي حين أبدأ أكتب، أكتب ولا أفكر إلا في الكتابة. لا أرهن متعة حريتي في هذه اللحظة الفريدة لأي كان. لقد هزمت كل أشكال الخوف وتدربت على المجابهات، وحين أكتب لا أبالي إلا بالفكرة الشاردة في خيوط عناكب النص الذي يعتقني أو أعتقه لحظة اندلاق الحبر. شرطي الرقابة الذاتية روضته فصار طيعاً أكثر من عناد الكتابة نفسها. هي لحظة حريتي حين أقرأ وحين أكتب، وفي هذا متعة روحية تنعكس على البدن حيوية ونهوضاً وتنطلق إفراسه نحو الحياة الفاعلة والمتفاعلة.
أما إذا كان الأمر يتعلق بالنشر، فبالتأكيد هنا أجد براحات أوسع وفقاً لواقع الحراك الثقافي في النمسا كمثال، حراك مسنود بقانون ديمقراطي عادل، لا توجد لجنة نصوص وحتى اللجنة المناط بها تقييم النصوص حين تتقدم إحدى الكاتبات أو الكتاب للحصول على منحة يتم تقييمها فنياً. بالتأكيد مساحة الحرية المكفولة بالقانون هنا تشكل سلامة للنفس وطمأنينة، فلا شيء يُزهر بلا ديمقراطية.
• تكتبين الشعر والقصة والرواية والسيرة وتمارسين الترجمة، البعض يرى تشتت الجهد الكتابي ما رأيك؟
– كلها فضاء واحد، كلها تنمي لي ريشاً وتجعل روحي محلقة في فضاءات اللامرئي. تشحذ مخيلتي لتمضي مراكبي في ذات النهر.. نهر الإبداع ومنطلقي إيماني بوحدة الفنون.
وضع خطة واضحة ومحكمة تنظم الزمن هي الضمانة الوحيدة لإنجاز المشاريع التي ننوي تنفيذها.
أشير إلى أني حتى الآن لم أنشر رواية رغم أن هناك ثلاثة مخطوطات أعمل عليها من سنين وربما ترى إحداهن النور قريباً. أشير هنا إلى ما عندي من مخطوطات سواء أدبية أو بحثية لم تجد طريقها للنشر لأن النشر بالعربية مكلف عكس النشر بالألمانية الذي يعود عليك بنشر الكتاب مجاناً وفي بعض الأحيان يكون هناك عائد رمزي ولكنه يعني الكثير، يعني اعترافاً بك وبمشروعك الإبداعي.
• هناك من يقول أن الكاتب المبدع الذي يعيش خارج وطنه لا يعرف قضايا الفرد في وطنه؟
– في هذا ظلم كبير ويقسو كثيراً على من حملوا الوطن في وجدانهم تميمة تحرسهم وتحفزهم من أجل الإسهام في التغيير الاجتماعي المنشود.
ليس بعيداً عن هذا الرد الذي يبدو عاطفياً أقول إن الميديا الاجتماعية سهلت التواصل اليومي والمتابعة الدقيقة، إضافة إلى أن كثيراً منهم ومنهن لم ينقطعوا عن السودان… فكيف يكونوا بعيدين عن قضايا الفرد وهم الداعمين نساءً ورجالاً لأهلهم وأسرهم مادياً ومعنوياً وبذلك يتحملون الكثير من النفقات التي كان على الدولة أن تتحملها. في المقابل يمكنني أن أطرح فرضية بحثية مفادها أن الكاتب المبدع الذي يعيش خارج وطنه أكثر التصاقاً بوطنه الأم وتفاصيله الأولى وحنينه لأمكنة شكلت وجدانه أكثر من التصاقه بالموطن الجديد؟!
• النص المفتوح الذي يحوي بداخله كثيراً من المسميات الإبداعية من قصة ورواية وشعر، ألا يساهم ذلك في تغييب صورة كل إبداع على حدة؟
– يعتمد على الموضوع وعلى روح النص وكيفية كتابته، هناك روايات مثلاً مثل رواية (لوليتا) لواسيني الأعرج لا تعرف إن كانت رواية أم قصيدة، أو قواعد العشق الأربعون لإليف شافاق، أو الأسود يليق بك لأحلام مستغانمي رغم أن الثلاثة مصنّفات كرواية. أحب النصوص المفتوحة والتي تفضي إلى آفاق لا حد لها وتترك لي حرية الحراك.
• هناك حديث كثير عن الترجمة وخصوصاً ترجمة الشعر، هل يترجم الشعر إذا وجدنا أن الشعر في لغته الأم يعتمد على التأويلية له ظاهر وباطن؟
– من تجربتي المتواضعة والتي ساهم القلم النمساوي في صقلها أقول إن الترجمة عملية إبداعية تساهم بشكل واضح في أنسنة عوالمنا، حيث تغوص في روح الشعر وليس ترجمة حرفية يمكن العمل عليها لتأخذ ملامح القصيدة. الترجمة فعل إبداعي متكامل مستند على أفق معرفي لثقافة اللغة المنقول منها أو إليها. أذكر هنا مثالاً بسيطاً، فحين ترجمت (في محبة الحياة) للشاعر المصري عمر حاذق كنت أرجع أحياناً إلى البعد الثقافي لبعض المفردات الموغلة في الثقافة المصرية، وحين بدأ زميلي الشاعر النمساوي كورت مراجعتها وسبكها حتى تصل إلى قارئات وقراء الألمانية، بدأت معه الكثير من الأسئلة وانعكس اختلاف الثقافات في حوار ثرٍّ لا أزال أحتفظ بنقاطه للتوسع في الكتابة حوله. مثلاً (وضحك البحر).. البحر هنا له ثقافة مختلفة عن التي عندنا، رغم أن الصورة الشعرية التأويلية يمكن قبولها، ومع ذلك تطفو للسطح بقوة أن الترجمة لا يمكن أن تكون إن لم نكن ملمين بثقافة اللغتين ومرجعيتهما، فهي ليست محض (نقل) بل عوالم وكائنات.
• الترجمة لم تستطع على مدى سنوات كبيرة نقل اللغة العربية ومبدعيها إلى الصفوف الأولى في الكتابة، أين الخلل؟
– كما ذكرت سابقاً أن الترجمة تفاعل بين لغتين بكل حمولاتهما الثقافية والفكرية، ولابد أن يكون المترجمة/المترجم ملمّاً بهذه الثقافات وأبعادها. فثراء اللغتين ومعرفة سياقاتهما التاريخية وتطورهما تتيح لمن يترجم حرية التنقل بين حالات إنسانية تتناغم حتى تصل إلى نص موازٍ في الغالب مع محاولة الحفاظ على روح النص الأصلي. هذا الثراء المعرفي بالأبعاد الثقافية للغتين يتيح فرصة كبيرة لتجسير الثقافات وفتح فضاءات للحوار الثقافي الذي يتناول قضايا مختلفة تقرّب بين الشعوب.
التمويل عقبة أساسية سواء بالنسبة للترجمة، النشر أو التوزيع.
• هل كل من يملك لغة أجنبية يعد مترجماً.. وما تعريف المترجم؟
– لا أعتقد أن كل من يملك لغة أجنبية يعد مترجماً، لأن الترجمة فن وعملية إبداعية، يمكن أن يكون عاشق الأدب مترجماً ولكن الهواية وحدها لا تخلق مترجمة/مترجماً، إذ لابد من صقلها بالتعلم وكسب المعارف وتبادل الخبرات كما يحدث هنا في النمسا وعبر الاتحاد العام للمترجمات والمترجمين النمساويين في المجال الأدبي، إذ تقوم عبر شبكة واسعة لتبادل الخبرات والمعلومات التي تخص دورات تعليمية أو مؤتمرات أو ورش عمل إلخ…
فكرتي في الترجمة ليست فعلاً أحادياً إنما فعلاً جماعياً كلما تقوم صديقات وأصدقاء بمراجعة ترجمتي وفي طقس سوداني حميم على وقع رائح الطبيخ والبخور السوداني، كل هذا يفتق حوارات عميقة كم استفدت منها وكم اكتشفت جهلي وكم ساعدتني لأنظر للأشياء، كل الأشياء، بمنظور مختلف وأن أكون متقدة الذهن على الدوام لتقبل الرأي الآخر بمحبة واحترام. إنهم أو إنهن لا يصححن فقط ما أكتب إنما المثابرة والاجتهاد أيضاً من جانبهم لمعرفتنا بعمق، معرفة (العنقريب)، ذلك السرير البلدي في السودان فترجمته إلى ما يعادله باللغة الألمانية مثلاً يفقده بعده الثقافي والاجتماعي وسر طقوسنا المرتبطة به، فنحن نولد فيه ونرحل إلى ضفتنا الأخيرة محمولين عليه ويشكل حياتنا من المولد إلى الممات، فهل لما يعادله في اللغة المقابلة يقوم بنفس الطقوس؟ قطعاً لا.
أو (آبري، أي الحلومر) فهو ليس محض مفردة وإنما طقس ثقافي كامل وليس له هنا ما يقابله، لذا تركته كما هو Apri مع شرح لماهية الآبري، أو العنقريب، وبالتالي نقلت القراء من حالة إلى حالة، إلى طقوس مختلفة وحيوات مختلفة، وهذا هو الثراء الإنساني الذي أهدف إليه في مشروعي.
شارك الحوار