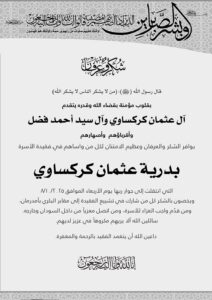تجليات “الأنا” في مسارها الشعري أو ليلة العرس المقدس: قراءة تحليلية في قصيدة “أنشودة الجن” للتيجاني يوسف بشير
Admin 30 أغسطس، 2025 405
د. مدني أحمد عثمان أبو نيران
كاتب صحفي
مدخل:
ولد الشاعر أحمد التيجاني يوسف بشير محمد الإمام جذري بأم درمان عام 1912، ولقب بالتيجاني تيمناً بصاحب الطريقة المعروفة العارف الشيخ أحمد التيجاني، بدأ تعليمه بخلوة عمه الشيخ محمد القاضي الكتيابي، فحفظ القرآن ثم رسم طريقه إلى المعهد العلمي بأم درمان متلقياً دروسه في اللغة العربية والفقه، ثم اتصل بالصحافة ثم انقطع متنقلاً يبحث عن العمل في مجالات أخرى، كان قارئاً جيداً في شتى ضروب المعرفة، وقد حق له استيعاب كتب الأدب القديم، التصوف والفلسفة، كما كانت له متابعات متميزة لرموز المدرسة الرومانسية في شعراء أوروبا كوردزورث، كلوريدج، غوتة، وفيخته وغيرهم ممن ممثلوا المدرسة الرومانتيكية في الأدب العالمي، ولم يتوقف عن القراءة والكتابة حتى وهو على فراش المرض، وقصيدته على فراش الموت دليل على ذلك، حتى توفي عن عمر لم يتجاوز الخامسة والعشرين، رحمه الله.
المنهج:
إن نقد النص يستغرق مفهوم وسلطة النص، لأن النقد من جهة استكشاف للمفهوم ومن جهة أخرى تفكيك لسلطة النص، فالدخول إلى فضاء النص كقارئ ناقد يجب أن تحيطه المساءلة والاستنطاق عبر آليات الحفر والتفكيك، لأن النص في علاقاته الدلالية ورمزيته بات يشكل منطقة من مناطق عمل الفكر حسب مقولة نظريات النقد الحداثي وما بعدها، هذا ما يستوعبه المنهج النقدي المتبع في هذه الدراسة من ناحية الوافد من النظريات، ولكن للموروث الثقافي آليات تستطيع أن تكشف ما وراء ظاهر النصوص الأدبية، وأعني بذلك القدرة التأويلية كمنهج ديني يمكن توظيفه في فك طلاسم المسكوت عنه داخل النص الإبداعي، لذا فالمنهجية المستخدمة في نقد النصوص ومنها هذا النص الجاري، هو محصلة تزاوج الوافد كمستوعب داخل إطار الموروث الذاتي الذي لا غنى عنه في تطوير مفاهيم النظرية النقدية والأدبية لتواكب تيار الفكر العالمي.
الرموز الدالة في النص:
الجن:
الجن مخلوقات نارية خلقت للعبادة كما الإنس، وهو من المسميات المرنة التي تنسحب على الرقائق اللطيفة غير المرئية، والجن لغة يأتي من اشتقاق الكلمة جن بمعنى استتر، جاء ذلك عند الفيروز أبادي، وقد قال ابن منظور في الحديث: جن عليه الليل أي ستره، وبه سمي الجن لاستتارهم واختفائهم عن الأبصار، ومنه سمي الجنين لاستتاره في بطن أمه، ولكنه من المؤكد أن عدم رؤية الجن تأتي لسببين جوهريين، هما رقة أجسامهم ولطافتها، ثم ضعف أبصارنا ولو أن الله أراد لنا أن نراهم لقوى أبصارنا أو جعل أجسامهم أكثر كثافة.
والشاعر في هذه القصيدة استعاد لفظة أنشودة الجن، كمعادل موضوعي يقوي به الدلالة على رهافة الحس ولطافة المعنى المنشود داخل النص في حالته الغنائية.
الخمر:
الخمر من الرموز التي عرفت انتشاراً كبيراً عند الشعوب، وذلك لارتباطها بالقدرة التحويلية الهائلة الكامنة فيها والتي جعلت الكثير من الشعوب القديمة ذات مصدر إلهي، فهي رمز العبور بين عالمي المادة والروح، بسبب حُميا سكرها التي يجعل الشارب يدخل في بعد مختلف عن الأبعاد الأخرى المألوفة لوجوده، مع الإحساس بالتحرير والانطلاق والفرح، وللخمر علاقة بالدم واضحة من ناحية اللون وبالذات خمر العنب الذي يشار إليه بدم العنب، وقد انتبه الصوفية إلى رمزية الخمر ووظفوها كثيراً للتعبير عن حالة الوجد التي تنتاب السالك، عندما يبلغ منه العشق الإلهي مبلغاً يغيب فيه عن شهود المحس من نفسه، مثلما يغيب السكران عن كل ما يحيط به كما قال أحدهم:
شربوا بأقداح الصفا لما صفوا ** سكروا فلاحت منهم رقصات
ظهرت عليهم من بواطن سره ** كاسات بشر كلها راحات
أخيراً تبقى خمرية بن الفارض أجمل ما قيل في رمزية الخمر، كتعبير عن معاني التحول والغياب والعشق والفناء في الذات الإلهية.
شربنا على ذكر الحبيب مدامة ** سكرنا بها من قبل أن يخلق الكرم
المغزى:
في البدء لا بد من إشارة، أحسب أنها تسهم في رفد المعنى المراد استنطاقه داخل النص المراد تحليله (أنشودة الجن)، هذه القصيدة تقع تقريباً، في منتصف متن القصائد الواردة في سفر الديوان (إشراقة)، هذا من الناحية المكانية والزمانية، ولكن هنالك انتصاف فكري تمثله القصيدة وهي وقوعها في المجال الفكري للشاعر، بين رؤيته الفلسفية وتصوفه السني، وما يتبعهما من تأرجح بين الشك واليقين في مسار حركته الفكرية وبين قصيدته في الموحي والتي أعتقد أنها كانت هي بلسم عنائه الفكري وواحة استظلت بها شوارده النفسية، حيث التأمت بها أناه المنشطرة بين الأنا الوافدة (قلب الفيلسوف) والأنا الموروثة (الصوفي المعذب)، لذا تعتبر قصيدة (أنشودة الجن) بمثابة ليلة العرس المقدس والتئام الذات الشاعرة كمدخل تزاوجي تنعم به رؤيا الشاعر، وبؤرة التقاء الرؤى المختلفة التي التقت في معين فلسفة وحدة الوجود عند الشيخ الأكبر محيي الدين ابن عربي رائد التصوف الفلسفي.
فطرير الشباب المستدعى بصيغة الأمر، هو أنا الذات المتقدة وجداً بخمر عرفان حقيقتها بعد مخاض سلكته تمهيداً للتحرير من كثافة الجسد والانطلاق لخوض مقام الإسراء عبر البراري للتغني بنشيد الغزل الإلهي لحظة سريان خمرة الحب المسكوب بدم العاشق، ليتم الفرح وتكتمل الرؤيا المنشودة من خلال استمرارية فعل الأمر الذي ظل مبتدأ به في كل أبيات القصيدة، والتغني بأنشودة الجن دلالة رافدة إلى الحالة الشعورية التي تسكن الشاعر، حالة العرس المقدس الذي يتطلب غناء خاصاً هامساً طرياً ومستتراً كحال لطافة الجن واستتاره، فالأنا المتحدة/ قرين الشعر والقناع عند الشاعر تنطلق لتجوب الصحاري والغابات وما فيها من معابد ومرابد وأبنية وجبال وكناري، لتكون في حالة رقص مصاحب لهذا الفرح، حتى يشهد الأعراب روعة هذا المشهد الذي تم استنفاره كموكب كرنفالي يرقص على موسيقى الغناء الكوني.
بعد ذلك ينقلنا الشاعر إلى حالة شعورية هي أقرب إلى حالة العروج الشعري بعد أن استنفد رحلة الإسراء الشعري، التي تم فيها التقاط الصور الشعرية بعدسات الشعور المهموس رجعاً وترديداً، فالشاعر يخاطب أناه التي تمثلت تلك الصور والمشاهد بأن تتحد بجسده رسماً وتصوراً على مناطق الحس والأعصاب حتى يتذوق هذا الجمال الكوني الذي صار جزءا من وجوده المنشود، ولكي يتحقق ذلك لابد من تزاوج آخر بين الأنا المتحدة في صراعها الآني مع الآخر (المجتمع/ الطبيعة) حتى تتحرر الذات من جملة الصراعات والانشقاقات وتكون حاضرة في صفائها الروحي لتستقبل لحظة التجلي لتحقيق الوجود المغاير (الفردوس المعوض) من خلال عبقرية الشعر التخيلية، وهو ما سوف نشهده محققاً في قصيدة (في الموحى) التي تمثل غاية المغزى الشعوري للشاعر من خلال توليد الطاقة الشعرية بخيالها المجنح.
قم لمحاك في الدجى بين صحوان ندى وبين سهوان ساكر
ينفخ الله في مشاعرك اليغظى وجوداً فخم التصاوير فاخر
ويفجر لك الغيوب وينشر بين عينيك عالماً من ذخائر
فتخير وصف وصور رؤى الوحي وصغ واصنع الوجود المغاير
المشار إليهم:
التيجاني يوسف أراد في مساره أن يحقق وجودا مغايرا كفردوس معوض لفردوس مفقود عبر الخطاب الشعري، هذا الفردوس المفقود الذي يعتبره خطيئة الكون الأولى منذ سقوط آدم نتيجة عدم الالتزام بالأمر الإلهي.
إن استخدام فعل الأمر المتكرر يعكس الحالة الشعورية للشاعر التي تلتزم ضرورة التغني والتغزل بالحب الإلهي عن طريق النشيد الهامس الشفاف كمنولوج داخلي غير مرئي أو مسموع بعد الجلوس على النفس.
الزمان في هذه القصيدة عند الشاعر لا يتخذ مساراً خطياً يميز فيه ما مضى من الحاضر أو مما سيأتي، بل الزمان كتلة دائرية متجمعة أو ما يشبه الدائرة، فهو يروح ويجيء في الأعم والأغلب عند الحاضر الذي هو نقطة التقاء الزمن الماضي بالرؤيا المستقبلية، وهذا واضح في أن القصيدة بدأت بخطاب الأنا ثم تحركت لخطاب الآخر ثم عادت إلى خطاب الأنا مرة ثانية في مقطعها الأخير بإحساس دائري عند لحظة حاضرة.
المراجع:
1-ديوان إشراقة.
2-كتاب نظرية النقد الحديث – د. محيي الدين صبحي.
3-عالم الجن – د. السيد الجميلي.
4-قراءة صوفية لإنجيل يوحنا – د. مظهر الملوحي.
5-المصطلح أشار إليه د. محمد عبد الحي في دراسته عن الشاعر (الرؤيا والكلمات).
شارك المقال