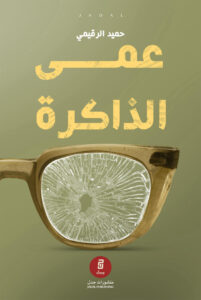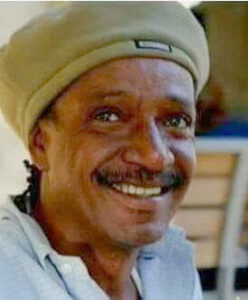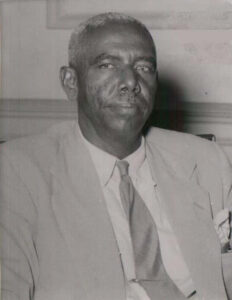سلطة المعرفة في السودان: المثقف بين دور التأثير ومحنة الصمت

تحقيق : نبوية سرالختم
مسارات المثقف خلال الحرب – بين الانكسار والتحوّل
• حين تعمّ الفوضى، ويغدو الخراب نظاماً، لا يُستدعى المثقف ليشهد فقط، بل ليُعيد ترتيب الفوضى ذاتها. دوره لا يُقاس بترف اللحظة ولا رفاهية الاستقرار، بل بقدرته على صوغ المعنى من داخل الفقد، وإعادة بناء الوعي حين تتفكك البنى الاجتماعية، السياسية، والمعرفية.
لكن هذا الدور لم يكن دوماً على هذا النحو الدفاعي أو الهامشي. فالمثقف السوداني، قبل الحرب، كان يتمتع بموقع خاص داخل الحقل العام: كان منتجاً للسرديات، وصاحب رأي في السياسة والاجتماع، وحارساً معرفياً ضد السلطوية والتزييف.
من قاعات الجامعات، إلى صفحات الصحف، إلى منصات النقاش العام، لعب المثقف دوراً مركزياً في نقد الدولة، وفي إعادة مساءلة الخطابات الرسمية والمعارضة معاً. بل كان – في كثير من الأحيان – هو من يصوغ المصطلحات، ويؤطر النقاش، ويقترح البدائل.
غير أن اندلاع الحرب في أبريل 2023 قلب المعادلة رأساً على عقب. تفككت الدولة، وتلاشت المؤسسات، وسقطت الحريات العامة، ووجد المثقف نفسه فجأة في زمن بلا مركز، بلا منابر، بلا جمهور متماسك، وأحياناً بلا لغة قادرة على وصف ما يحدث.
فهل ما زال له سلطة معرفية في هذا الواقع الجديد؟ أم تحوّلت سلطته إلى مجرد سلطة أخلاقية – يُحترم فيها كرمز، لا كمؤثر؟ هل يستطيع أن يؤدي دور «الضمير» وسط الفوضى؟ أم يُطلب منه الصمت، أو يُضغط عليه ليتحوّل إلى تابع لهذه الجهة أو تلك؟
هذا التحقيق لا يكتفي بطرح الأسئلة، بل يحاول استقصاء تحولات موقع المثقف السوداني، ما بين ما كان عليه قبل الحرب، وما صار إليه في قلب الخراب: من بقي مخلصاً للمسافة النقدية؟ من تحوّل إلى واجهة لخطاب مسيّس؟ من صمت؟ ومن بقي يكتب، رغم أن لا أحد يقرأ؟
الصدمة كحدث تأسيسي جديد
في الواقع السوداني، المثقف يعيش في بيئة سلطوية هشة: الدولة مفككة، والمؤسسات غير مستقرة، والسلطة السياسية متذبذبة بين قوى متعددة متصارعة. ضمن هذا السياق، يصبح المثقف عرضة لانكشاف هشاشته: فهو لا يمتلك حماية مؤسسية فعلية، ولا جمهور مستقر، ولا حتى خطاباً معترفاً به بشكل شامل.الصدمة إذن، ليست فقط كسراً للواقع الخارجي، بل انكشاف للحالة السلطوية الهشة التي يحياها المثقف. فمثلاً، انسحاب المثقف يعكس حالة يأس تكمن في الشعور بأن خطابه لم يعد قادراً على مقاومة السطوة القسرية للمؤسسات الحربية والسياسية.هشاشة السلطة المعرفية هنا تعني أن المثقف يفقد أفق التأثير، ويُترك وحيداً أمام العاصفة، مما يولّد حالة من العزلة والانكسار.
الحرب التي اندلعت في أبريل 2023 شكلت «صدمة وجودية» لكل مكونات المجتمع السوداني، وبالأخص المثقفين. فجأة، وجد المثقف نفسه أمام مشهد تفكك الدولة وانهيار مؤسساتها، وتحلل القيم المجتمعية. بالنسبة للبعض، كانت هذه الصدمة بمثابة قطيعة جذرية عن ما سبق،هذا الانقطاع أو الاستمرار بشروط جديدة يعكس تماماً ما يصفه بول ريكور في مفهوم «الحدث» كعامل يعيد تشكيل كل الأطر السابقة، وهو ما يشكل تحدياً معرفياً وجودياً للمثقف السوداني.الحرب لم تكن مجرد صدمة عسكرية أو سياسية، بل هي حدث وجودي يضع المثقف في مواجهة مع إعادة بناء هويته ومساره. هذه الصدمة ليست فقط في الحدث نفسه، بل في كسر النسق الذي كان يضبط ويشكل سلطته المعرفية.
من المثقف العضوي إلى المثقف العابر للحدود
في مواجهة انهيار المركز وانقسام الجغرافيا، بدأ بعض المثقفين السودانيين في إعادة تعريف أدوارهم، من الانتماء للمؤسسات الوطنية إلى العمل كأفراد أو كيانات مستقلة تتجاوز الحدود. ظهر هذا في مبادرات رقمية، أو تحالفات معرفية مع مثقفين من دول أخرى، أو في مشاريع توثيق عابرة لحدود الدولة، تحاول توسيع أفق الخطاب خارج القوالب الرسمية.فالعديد من الصحفيين الشباب والكتاب مثلاً الذين غادروا السودان إلى عدد من دول الجوار أصبحوا يديرون منصات رقمية للنشر والتحليل السياسي تجمع بين المثقفين في السودان والمنفى.لكن هذا التحول لم يكن سهلاً،هذا التحوّل، وإن بدأ واعداً، يطرح أسئلة حول صلة المثقف بجمهوره المحلي، وقدرته على التأثير في واقع مشتت و مشرذم. هل يمكن لخطاب عابر للحدود أن يعوّض غياب المؤسسات المحلية؟ أم أن ذلك يقود إلى نوع من الانفصال عن الأرض؟ هل يمكن للمثقف أن يحتفظ بسلطته المعرفية وهو معزول عن الواقع المباشر؟ وهل تصل خطاباته إلى الجمهور داخل السودان وسط انقطاع الاتصالات وضعف البنية التحتية الرقمية؟ كل هذه التساؤلات ترمي إلى ان هذا التوسع الكوني قد يُفقد المثقف خصوصية سياقه المحلي، ويُعيد إنتاجه في صورة مستهلكة، تُرضي المنصات الدولية أكثر من احتياجات المجتمع المحلي. مما يجعل هذه التجارب تؤكد أن المثقف العابر للحدود يحمل عبء التوفيق بين واقعين: داخلي ممزق، وخارجي يعجّ بالفرص لكن بعيد هنا برز شكل آخر من محاولات المثقفين في طرح خيارات تعيد تعريف أدوارهم داخلياً حيث تحول بعض المنتجين السابقين للمعرفة إلى الميدان الإنساني حيث برز اسم العديد من الكتاب والصحفيين الذين حولوا انشطتهم من الكتابة إلى المشاركة في تنسيق حملات إغاثة والمساهمة في التعليم المجتمعي، أو تقديم الدعم النفسي والمعنوي. في مناطق النزاع هذا التحول من المثقف النظري إلى الفاعل المدني يؤكد نقطة مهمة: في لحظات الانكسار، المعرفة لا تعني فقط إنتاج الأفكار بل تتطلب المشاركة في إعادة بناء النسيج الاجتماعي لكن هذا التحوّل يفتح بدوره سؤالاً: هل نحن أمام تراجع في وظيفة المثقف النقدية لصالح أدوار إنسانية؟ أم أن الجمع بين المعرفة والفعل هو ما يمنح المثقف شرعيته الجديدة؟
المثقف والرقابة الذاتية
في سياق الحرب، الرقابة لم تعد فقط خارجية. كثير من المثقفين صاروا يمارسون رقابة ذاتية خوفاً من التهديد، التخوين، أو حتى فقدان جمهورهم. هذه الرقابة تؤثر في نوعية الخطاب، وتدفع إلى الحذر المفرط، أو التبسيط، أو الهروب إلى العموميات.الرقابة الذاتية أخطر من الرقابة المفروضة، لأنها تُخفي نفسها داخل اللغة، وتجعل من المثقف شريكاً في تقييد نفسه. وهي رقابة تتغذى من بيئة الخوف، ومن هشاشة الحريات، ومن انفجار الخطابات المتطرفة العديد من الكتاب والصحفيين تحدثوا سراً عن خوفهم من التعبير الصريح عن مواقفهم خوفاً من الاستهداف الرقابة الذاتية تؤدي إلى تراجع جودة الخطاب النقدي، وتحول اللغة إلى ما يشبه «لغة التلميحات» أو الرموز المغلقة، مما يفقدها تأثيرها وقدرتها على بناء معنى واضح لدى الجمهور ما يُضعف أثره ويُشتّت رسالته.هذه الحالة تجعل المثقف شريكاً غير معلن في تقزيم سلطته، وأحياناً في تكريس الاستقطاب أو الصمت القسري
في السودان في أزمنة الحرب الرقابة الذاتية ليست فقط رد فعل على القمع الخارجي، بل هي نتاج بيئة سلطوية ثقافية تخيف المثقف من إمكانية فقدان مكانته أو تعرضه للاعتقال أو التشويه الإعلامي. حيث تسود مناخات الخوف والاتهام المتبادل، يمارس المثقف الرقابة الذاتية كآلية بقاء، لكنه بذلك يفرّط في قدرة الخطاب النقدي على التحدي والتغيير.هذه الرقابة تجعل الخطاب مفككاً، ملغزاً، ومتجنّباً للأفكار الجريئة، ما يفضي إلى «ترهل» السلطة المعرفية للمثقف وتراجع دوره في تشكيل الوعي الجماهيري أو مواجهة الخطابات الرسمية.في هذا الواقع، تتحول الرقابة الذاتية إلى آلية للحفاظ على «وجود هش» بدل أن تكون منصة لإعادة بناء السلطة المعرفية.
من الانكسار إلى التجاوز – هل هناك أفق جديد؟
رغم كل العوامل التي تهدد سلطة المثقف، تظهر محاولات جادة لإعادة تشكيل خطاب جديد، يتسم بالتعبير عن الذات والذاكرة والإنسانية، ويخرج عن الإطارات التقليدية الجامدة.هذا التحول يعكس إدراك المثقف لهشاشة سلطته الثقافية، فبدلاً من مواجهة السلطوية المباشرة، يلجأ إلى أشكال تعبير بديلة: الشعر، الفن، السرد الشخصي. هذه اللغات الجديدة تحمل فرصة لخلق «سلطة معرفة» أكثر مرونة وأكثر ارتباطاً بواقع الإنسان المتأزم حيث برز شعراء استخدموا الشعر والفنون البصرية لتقديم سرديات تعبر عن تجربة الحرب من الداخل، بشكل يحمل همّ الذاكرة والهوية والإنسانية.هذه المحاولات تفتح آفاقاً جديدة لسلطة المثقف، حيث تتحول من خطاب معرفي رسمي إلى تجارب فنية تعبيرية قادرة على مخاطبة وجدان الناس بطرق مختلفة يبقى السؤال المحوري: كيف يمكن لهذا الخطاب الجديد أن يلتقط هموم المجتمع ويعيد بناء «سلطة المعرفة» في زمن اللا معنى؟ لكن يبقى السؤال: هل يمكن لهذه التجارب أن تترجم إلى قوة فكرية فاعلة في المجتمع، أم أنها ستظل تجارب هامشية في ظل بقاء البيئة السلطوية الحاكمة على حالها؟
خلاصة:
الواقع الثقافي السوداني في زمن الحرب يعكس هشاشة عميقة في سلطة المثقف المعرفية، التي تواجه تحديات متداخلة منها تفكك الدولة والمؤسسات، ما يضعف الحاضنة التي تستند إليها السلطة المعرفية؛ وانقسام الجمهور والبيئة الاجتماعية، مما يؤدي إلى انفصال المثقف عن معيشة الناس؛ ووجوده في بيئة سلطوية قمعية تعزز الرقابة الذاتية والخارجية؛ ومتطلبات وضرورة تحول المثقف إلى فاعل مدني مع ضغوط سياسية وأمنية كبيرة؛ كذلك محاولات التجديد اللغوي والفني كسبيل للخروج من مأزق السلطة الثقافية التقليدية.هذه الهشاشة لا تعني نهاية دور المثقف، لكنها تحتم عليه إعادة التفكير في أدواته، أدواره، وموقعه في مجتمع يشهد تدميراً بنيوياً عنيفاً.
شارك التحقيق