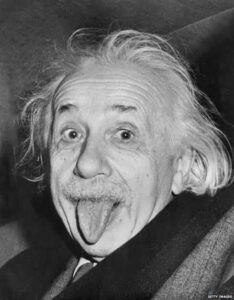د. إشراقة مصطفى حامد
إهداء إلي الصديق Abd Elrhman Sorkati
• حريتي أن أكتب
هو حبيبي القلم
وحده يعرف من أين ألج لجّته
من أين ألتهم عواصفه
ومن أين يطلق عصافير مهجتي حين أبدأ الرقص
أكثر ما يُدهشني حين يتم تجسيد نص من نصوصي، ليس الكيفية التي يتم بها التجسيد، بل ما يثيره العمل الإبداعي ككل من أسئلة وحوارات عميقة، سواء بالصوت أو المسرح أو الموسيقى أو الشعر أو التشكيل المصاحب لكل ذلك. كل مرة أتيقن أن هويتنا الإنسانية يمكن أن تتخلق على يد الفنون هويةً تعترف بالإنسان كإنسان وتتجاوز عقدة اللون والأصل والدين والنوع… إلخ.
شاركت في دورات للكتابة الإبداعية باللغة الألمانية وكان حصادها كتابين يجمعان كل النصوص التي قرأناها وتحاورنا حولها بأفق منفتح. أحرص منذ عام 2010 على المشاركة في هذه الدورات، وفكرتها أشبه بورشات العمل التي تتم فيها قراءة ما كتبنا والتحاور بشأنه. ينصبّ الاهتمام على مناقشة أساس الفكرة لا على مسائل اللغة وضبطها نحوياً. البروفيسورة «إيفا اشيمت» التي تقوم بإدارة هذه الدورات منذ عشر سنوات، من أكثر النمساويات وعياً، وكثيراً ما نتفق في رؤانا الفكرية والسياسية. «إيفا» التي عاشت التهجير طفلةً مع أسرتها اليهودية عرفت كيف تمضي نحو الإنسانية بقلب يسعُ العالم.
عبر هذه الدورات عرفتُ مِن «أنتون ماركو» الكثير عن ألبانيا وعمّا يحدث في تلك المنطقة، عرفتُ رومانيا وحضاراتها، والبرازيل وشجون قهوتها حين تصنعها أسرة «فريناندز»، الدانوب بصيرة الكاتبة العالم «هيلغا نيوماير»، صديقتي الإنسانة التي أكدت لي منذ عرفتُها أن الإنسان صاحب النفس السوية يظل إنساناً.
«آنا» التي عاشت سنوات طويلة في رفقة زوجها الإفريقي، عكستْ كتاباتُها نظرةَ المجتمع النمساوي للأفارقة بكل إيجابياتها وسلبياتها. النصوص التي تقرأها قادتني إلى مسألة الهوية الإبداعية، وهل بالإمكان أن تلعب هويتنا الإبداعية دوراً في بناء الجسور بين شعوب الأرض؟ الحوارات تقرّب وجهات النظر، وكنتُ الوحيدة من المنطقة الإفريقية والعربية في هذه الدورات. فكثيراً ما امتدّ النقاش إلى زمن يتجاوز الزمن المحدد، خاصة أن هذه الدورات تبدأ بعد السادسة مساء.. حوارات أضاءت أغواراً بعيدة في وعينا، حتى إن زميلة من شرق أوروبا تمنّت أن أقرأ مرةً نصاً من غير أن تحس فيه تلك الروح الكفاحية. وطرحَت السؤال حول الأرضية التي ننطلق منها حين نكتب، وهل فكرة الكتابة نفسها تسقط فجأة من السماء؟! الجدير ذكره أن فكرة هذه الورش المتعلقة بالكتابة الإبداعية بدأت في السبعينات من القرن الماضي، وهي ثقافة متعارف عليها في كثير من دول أوروبا. هذه التجارب تثمر كل يوم وتتفتح في الوعي البعيد بسؤال الإنسان.
حريتي في أن أكتب من دون رقيب يقف بيني وبيني، عرفت بوعي كامل أن تناولي للمسكوت عنه في تابوهات الجسد سيجلب لي الكثير من المتاعب، ولا سلاح لي سوى ما كسبته من معارف وقدرة على التحليل العلمي والموضوعي ما استطعت إلى ذلك سبيلاً. هذا الأفق ليس لي وحدي.. إنه لأجل بنات قادمات يجدن في الكتابة متنفساً ومشروع حياة. لأجل كلمة وموقف واضح من التحرش والعنف اللفظي. كل ما عانيته بسبب مواقفي الفكرية أو كتاباتي التي يراها بعضهم فالتة عن السائد والمألوف، يحفزني ألف مرة لأجد منهجاً وإطاراً نظرياً لتحليل هذه العقليات التي تقفز من كتاباتي إلى شخصي.
إيماني بوحدة الإبداع هو مدخلي لأيّ مشاركة، لذا لا أفوّت على نفسي متعة الأسفار في اللوحات، بنقرة على «الكيبورد» تنقلني الشاشة إلى أمكنة تفتح دروبها لي لأمضي لأمكنة داخل النفس البشرية.
الفن التشكيلي يتناغم مع الفنون الأخرى ومن ضمنها الكتابة الإبداعية، لوحة تعلق ألوانها على ذاكرتي وتظل تنتح نتحاً لذيذاً وهي تشدني نحو فضاءاتها، أسبح في أنهارها مالحة أو عذبة، فهي كحالتي تماماً حين أشاهد عرضاً مسرحياً يعود بي إلى فكرة مسرح «مايرْهولد»، أو حين أقرأ رواية لا تختلف أمكنتها وفضاءاتها عن فضاءات اللوحة. مشهد الثور الهائج في سيرة ماركيز «عشت لأروي» يحفز الفنان/ الفنانة لدخول التجربة والوحي يشبك روحه في روح العمل الإبداعي. اللوحة نفسها قد تتلبسني حتى لا أعود أعرف أين أنا مني.
العمل الإبداعي عندي بتسعين روحاً هي أرواحي، أسرار الروح عند الهنود الحمر أو هدايا الحب لمولانا جلال الدين الرومي، منى الخير وأبو عركي ونبتة حبيبتي ومارسيل خليفة وفيروز، أو أن اقرأ للشاعرة العُمانية عائشة السيفي وترافقني قصيدتها «الوحيدون» أينما مضيتُ وحيدة.
الرقص أمام المرآة في كامل زينتي.. رقص حتى يذوّب الدمعُ كحلَ العينين المحلّقتين بأجنحة ملونة.. الإبداع حتى في حركة الأصابع وهي في كامل تركيزها على لعبة الشطرنج. وما زالت لعبات الطفولة وحصّة الطين تستهويني لأقفز بتلك اللعبة (أريكا عمياء).. أريكا ذات البصيرة.
تخصيص صفحة لعمل إبداعي معين لا يعني إقصاء الأشكال الإبداعية الأخرى، فماذا تعني اللوحة إذا لم ترجّ صلصال روح من يقف أمامها غائصاً حتى بحر الإنسانية؟
ثمة تجارب كنت جزءاً منها تصبّ في الفكرة نفسها عبر تجسيدٍ مسرحي لنصّ يخصّني نفّذَته مجموعة نمساوية تنتمي إلى أشكال مختلفة من الإبداع (غناء، رقص، نحت، تلوين، تصوير… إلخ). أذكر أننا كنا نلتقي أسبوعياً لـ»البروفات» ونتناقش حول ما عجّ من رؤى من حواراتنا السابقة.. بعضنا وجد نفسه في بداية مرحلة لعمل إبداعي جديد، وبعضنا كان في حالة سكون ما قبل العاصفة.
ما زلت أحس برعشة في كياني كلما تذكرت صورة الفنان الكردي عبدالرحمن حاوي حين يبدأ في إنجاز منحوتة وهو مستغرق تماماً حتى يعتقد أنه الوحيد في هذا العالم. وتحوَّل الجاليري إلى فضاء، ولم يكن لنا وجود إلا في المنحوتة التي جعلته يستغرق فيها. لذا لم يفُتْني أن أركز على الفنون إبان عملي محاضرةً غير متفرغة بكلية العلوم السياسية بجامعة «فيينّا»، وكانت أكثر الأوراق إمتاعاً لذهني هي التي يكتبها طلبتي عن دور الفنون في عملية السلام (وثقافة السلام هي أحد المواضيع التي كرستُ لها وقتاً من عمري وما زلت)، أو عن إبداع المهاجرين والمهاجرات.
أندهش حين يُقال لي: «أنتِ غير مشغولة بالعمل السياسي وما يحدث في السودان». لم أقف يوماً عن العمل السياسي، ليس بحكم الدراسة فقط، بل بحكم التجربة، فكيف لمبدع أن يكون بلا رؤى وأفق سياسي؟ أستحضر الآن مقولة لبيكاسو قرأتها في مقال عن وحدة الإبداع: «إذا أردت تعلُّمَ التكوين في الرسم، فإن عليك بدراسة مسرح مايرْهولد». وأقول: «عليك أن تفتح كل فضاءات الروح لطاقات الفعل الإبداعي.. فعل الحياة».
بهذه الخلاصة حدث التحول في حياتي. السياسة هي التي تستطيع أن تخاطب كل وجدان بشري وتساهم في سلامه النفسي. هذا الوعي قادني لإطلاق الفكرة وراء الأخرى. أن يكون الأدب طريقنا نحو الآخر. أيّ طريق أنجع منه وسط الخراب التي يحدث الآن في عوالمنا؟ إرهاب وتطرف يميني، والأبرياء يدفعون الثمن، وكل انفجار في دولة أوروبية ينعكس أثره سلبياً على المهاجرين والمهاجرات. كل الأفكار التي تتدافع بشكل إيجابي لغرس وردة مكان رصاصة، ما كان لها أن تشبّ عن الطوق وتتحدّى المستحيل لولا وجود عدد من النمساويين الذين آمنوا بأفكاري ودعموا تنفيذها على أرض الواقع. اختيار «القلم» لي ممثلةً للأدب العربي كان قطرة البداية التي انطلقت منها مشاريع إبداعية تقوم على بناء جسور بين النمسا والبلاد العربية والإفريقية عبر الأدب والفنون.
«سيمفونية الربع الخالي» بادرتُ بفكرتها وكتابتها كمشروع واحتضَنها «القلم» النمساوي إيماناً بحرية الكلمة وفضاءاتها الإنسانية، ولخلق حوار جاد مع الكاتبات والكتّاب في دولة الإمارات وسلطنة عُمان. وقد تزامن تنفيذ البرنامج مع التفجيرات التي حدثت في فرنسا (2015)، وكان حواراً جاداً انطلق من نَصّ الشاعرة العمانية شميسة النعماني: «لا تَمٌتْ مثلهم»، فتبنّى معنا قسمُ حوار الثقافات بوزارة الخارجية النمساوية ورشة عمل ضمن البرنامج الثقافي، وكان المحور بعنوان: «ماذا يعني الموت؟». الموت هو الموت، والسلام مبتغانا. هكذا عبّرت الكاتبات وعبّر الكتّاب عن إنسان المنطقة العربية. مشروع دعمته الشاعرة والناشطة الإماراتية كلثم عبدالله وسانده بإيمانٍ مطلقٍ الكاتب العُماني خميس العدوي وكان حينها رئيساً للجمعية العُمانية للكتّاب والأدباء. سلسلة من المشاريع تستمر في أفق ممتد مسنود بالديمقراطية التي تتمتع بها الدولة النمساوية ودفعت الغالي والنفيس لأجلها.
الإنسانُ شعاري، أن يصل صوتي المشحون بكل أصوات عوالمنا هو ما أريد.. أن أسهم ولو بقطرة في رؤية تقول عنا وعن رؤيتنا. أن تتحدث عن لاجئة على رأس جبل، وعن شباب تركوا بلادهم وكُتبت لهم النجاة.. عن نساء منسيات في خريطة العالم، عن أطفال ورجال ونساء يموتون في الحرب ويتشرد كثير منهم. صوتٌ مشحون بالأمنيات العظيمات، واليقين أن النساء المهاجرات والمهاجرين في كل البلاد الأوروبية مؤهلات ومؤهلون وأن لنا دوراً في إنتاج سياسة هجرة مغايرة. أن أضع بصماتنا، بصمة المحبة والانفتاح على جراحاتنا والمشي على النار حفاة.
أن أقول من نحن وماذا نريد؟ جسور من الفضاءات بين النساء من كل زوايا العالم.. صوت للمبدعات والمبدعين في عوالمنا… من أكون سوى كل ذلك؟
أنا لا أكون من دون الإنسان الذي ينبض في أوردتي.. الإنسان الذي سمعتُ صرخته الأولى في «كوستي» وكبرت شجرته التي تجذّرت هناك ومدّت جذورها إلى كل العالم.. لست سوى تلك العوالم.
سأمضي يوماً إلى قبرٍ نتساوى فيه جميعاً، ولكن يبقى الإرث الذي حملته أيادٍ أكثر إنسانية وأكثر رحمة بعوالمنا وأكثر انتماء للحياة التي يستحقها كل إنسان بجدارة.
مشاركات عديدة ومشاريع مشتركة لعب فيها كثير من النمساويات والنمساويين والمهاجرات والمهاجرين دوراً كبيراً لإيمانهم بالفن والأدب. أن أشارك بنص أدبي عن الرعي والمراعي في إطار الاحتفال بأعياد «الكريسماس» أمام جمهور فاق المائة شخص لا يعني محض حروف تتناثر وتتلاشى، بل هي كلمات تفتح عشرات الأبواب للحوار كما يحدث معي دائماً، أن أرسل فكرة وأكون صوتاً لفتاة مهاجرة وشاب مهاجر، أن أدافع عن حقوقهما يعني أن يتحقق الحلم. أن يساند «د.هيلموت نيدرلا» فكرتي بتكوين كيانٍ داخل «القلم النمساوي» الذى يديره وأن يهتم بأدب المهجر ويفتح أبوابه للكتاب والكاتبات من بلادنا النامية المقيمين بالنمسا لأيّ سبب من الأسباب.. هذا الدعم ما كان سيكون لولا إيمان «د.نيدرلا» بدور الأدب في مسيرتنا الإنسانية وهو الذي ظل يفعل ذلك منذ أن حفزني بعد عامين فقط من قدومي للنمسا لأشارك بنص في الأنطولوجيا التي تهتم بأدب الغربة، كان ذلك في العام 1995، ومن يومها لم يكفّ عن دعمي ودعم كل ما يجعل عوالمنا تنعم في سلامها.
أن أكون ضمن هيئة تحرير لمجلة إلكترونية قامت فكرتها وتنفيذها على أكتاف الشاعرة الهندية «ساريتا جينماني» وزوحها الشاعر الباكستاني «افتاب حسين»، لا يعني سوى أنني صوت قادم من عمق النيل والفرات وكل أنهار الدنيا. كل هذا يفتح آفاقاً نحو رؤى مشتركة حول العديد من قضايانا العالمية.
كيف تتشابك الرؤى لتصب في نهر الإنسانية الأعظم؟ الفنانة التشكيلية «ريناتا مايرانز» التي رسمت لوحات معرضها الأخير من وحي مجموعتي الشعرية «أنثى المزامير» الصادرة عن دار «نينا رويتر» في مقاطعة «لينز». كيف لنصوص معجونة بطمي السودان أن تتشكل في «فيينّا» لترسم من وحيها فنانةٌ تشكيلية في مقاطعة النمسا السفلى، وتكون أنشودة الوصل الشاعرة النمساوية «دوريز كلومشتاين»؟ أيّ عوالم خلقناها وأيّ فضاءات تفتح نحو المهاجرين والمهاجرات، نحو بلادنا الأم؟
إذا تحقق بعض ذلك سيصير جُحر الفأر فضاء. ففي أحلامي البسيطة التي تخصّني: يكفيني جُحر فأر ليتنفس الهواء في رئتي. جئت إلى الدنيا بلا شيء وسأعود إلى الأرض متبوعة بكل هذه المحبة وبمسيرة تواصلها أجيال جديدة. تكفيني ابتسامةٌ عنواناً للمحبة التي أحملها للجميع أينما كانوا وكيفما وُجدوا…. شعاري الانسان
شارك المقال