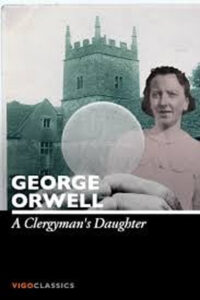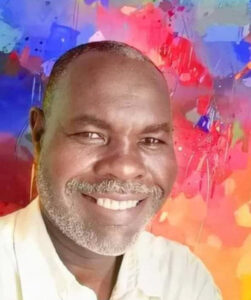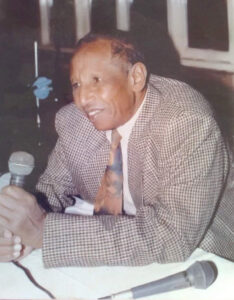سلطة المعرفة في السودان: المثقف بين دور التأثير ومحنة الصمت

تحقيق : نبوية سرالختم
جمهور المثقف – من يصغي إليه؟
• حين تعمّ الفوضى، ويغدو الخراب نظاماً، لا يُستدعى المثقف ليشهد فقط، بل ليُعيد ترتيب الفوضى ذاتها. دوره لا يُقاس بترف اللحظة ولا رفاهية الاستقرار، بل بقدرته على صوغ المعنى من داخل الفقد، وإعادة بناء الوعي حين تتفكك البنى الاجتماعية، السياسية، والمعرفية.
كن هذا الدور لم يكن دوماً على هذا النحو الدفاعي أو الهامشي. فالمثقف السوداني، قبل الحرب، كان يتمتع بموقع خاص داخل الحقل العام: كان منتجاً للسرديات، وصاحب رأي في السياسة والاجتماع، وحارساً معرفياً ضد السلطوية والتزييف.
من قاعات الجامعات، إلى صفحات الصحف، إلى منصات النقاش العام، لعب المثقف دوراً مركزياً في نقد الدولة، وفي إعادة مساءلة الخطابات الرسمية والمعارضة معاً. بل كان – في كثير من الأحيان – هو من يصوغ المصطلحات، ويؤطر النقاش، ويقترح البدائل.
غير أن اندلاع الحرب في أبريل 2023 قلب المعادلة رأساً على عقب. تفككت الدولة، وتلاشت المؤسسات، وسقطت الحريات العامة، ووجد المثقف نفسه فجأة في زمن بلا مركز، بلا منابر، بلا جمهور متماسك، وأحياناً بلا لغة قادرة على وصف ما يحدث.
فهل ما زال له سلطة معرفية في هذا الواقع الجديد؟ أم تحوّلت سلطته إلى مجرد سلطة أخلاقية – يُحترم فيها كرمز، لا كمؤثر؟ هل يستطيع أن يؤدي دور «الضمير» وسط الفوضى؟ أم يُطلب منه الصمت، أو يُضغط عليه ليتحوّل إلى تابع لهذه الجهة أو تلك؟
هذا التحقيق لا يكتفي بطرح الأسئلة، بل يحاول استقصاء تحولات موقع المثقف السوداني، ما بين ما كان عليه قبل الحرب، وما صار إليه في قلب الخراب: من بقي مخلصاً للمسافة النقدية؟ من تحوّل إلى واجهة لخطاب مسيّس؟ من صمت؟ ومن بقي يكتب، رغم أن لا أحد يقرأ؟
المثقف وسؤال الجمهور
لطالما ارتبطت السلطة المعرفية للمثقف بقوة الجمهور الذي يصغي إليه. في السياق السوداني، كان المثقف قبل الحرب يخاطب جمهوراً متنوعاً: طلاب الجامعات، القراء في الصحف الورقية، المشاركين في الندوات، والمتابعين عبر المنصات الرقمية.
لكن الحرب قلبت المعادلة. لم تعد هناك قاعات دراسية منتظمة، ولا صحف تُطبع، ولا فضاءات آمنة للنقاش العام. فهل ما زال للمثقف جمهور يصغي إليه؟ أم أصبح صوتاً بلا صدى، يتحدث في الفراغ أو لجمهور متخيل؟
في هذا السياق، يُطرح سؤال جوهري: من يتابع المثقف اليوم؟ من يقرأ ما يكتبه؟ من يثق في تحليله؟
بعض المؤشرات تشير إلى تحول الجمهور نحو خطاب أكثر عاطفية وسطحية، يُقدمه مؤثرو السوشيال ميديا أو الأصوات الحماسية التي تقدم إجابات جاهزة لا أسئلة صعبة. هذا التحول أضعف علاقة الجمهور بالمثقف التقليدي، خاصة حين يكتب بلغة تحليلية لا تواكب مزاج اللحظة.
الخطاب المعرفي .. العاطفي أم الدعائي؟
في أزمنة الأزمات، تزداد الحاجة إلى تفسير عقلاني لما يجري، لكن يزداد أيضاً الإغراء بخطاب يقدّم العزاء أو التحشيد أو العداء.
الخطاب المعرفي، كما يمثله المثقف، يعتمد على التحليل، السياق، والنقد. أما الخطاب العاطفي، فيستند إلى الاستقطاب، والمظلومية، والرغبة في الانتصار الأخلاقي. أما الخطاب الدعائي، فيعمل كأداة ترويج لأجندات محددة، سواء كانت عسكرية، سياسية، أو أيديولوجية.
في السودان، ومع اتساع دائرة الحرب والانقسام، تراجع الخطاب المعرفي لصالح العاطفي والدعائي. صار كثير من الناس يفضلون التفسيرات البسيطة والمواقف الحادة، ويخشون الخطاب الذي يطلب منهم أن يشككوا، أو يعيدوا التفكير.
هذا التحول مثّل تحدياً كبيراً للمثقف: هل يتمسك بخطابه العقلاني ويفقد جمهوره؟ أم يتبنى لغة جديدة تقرّبه من الناس دون أن يفقد استقلاليته؟
بعض المثقفين حاولوا التوفيق: استخدام لغة مبسطة، الانخراط في النقاشات العامة عبر وسائط شعبية، أو استخدام السرد الشخصي لجذب الجمهور دون التنازل عن التحليل.
وسائل التواصل الاجتماعي – منبر جديد أم فخ تشويهي؟
قدّمت منصات التواصل الاجتماعي فرصة نادرة للمثقف ليخاطب جمهوره مباشرة، دون وساطة الصحف أو دور النشر أو القنوات الرسمية. لكنها أيضاً كانت ساحة للفوضى، والتشويه، والاستقطاب.
في حالات عديدة، صار المثقف هدفاً لحملات التشويه أو الاتهام بالانحياز أو النخبوية أو الانفصال عن واقع الناس. بعضهم انسحب من هذه المنصات بعد أن أصبحت ساحة للتحريض، لا للنقاش.
لكن في المقابل، برزت نماذج إيجابية لمثقفين أعادوا صياغة خطابهم على هذه المنصات، فقدموا محتوى معرفياً بلغة بصرية، أو صوتية، أو سردية جذابة. آخرون استخدموا هذه المنابر لتوثيق ما يجري، أو لتعليم الجمهور، أو لفتح فضاءات نقاش نقدي وسط الضجيج.
غير أن سلطة المثقف على هذه المنصات تبقى مهددة دائماً بخوارزميات تقيس التفاعل، لا القيمة، وبمزاج جمهور يبحث عن الإثارة أكثر من الفهم.
أزمة الثقة بين المثقف والجمهور
من أعمق التحولات التي رصدها هذا التحقيق، هو تراجع الثقة بين جمهور واسع من الناس والمثقف التقليدي. لم يعد يُنظر إليه فقط كمنتِج معرفة، بل كجزء من نخبة فشلت في التغيير، أو تواطأت مع سلطات سابقة، أو لم تعش المعاناة اليومية.
هذا الانفصال كان موجوداً قبل الحرب، لكنه تعمّق بعدها. فبينما نزح الملايين، وسقطت المدن، وانهارت البنى التحتية، بدا أن بعض المثقفين يتحدثون من أماكن آمنة، بلغة لا تعكس عمق المعاناة.
في المقابل، هناك مثقفون خاضوا نفس التجربة: فقدوا منازلهم، نزحوا، عاشوا العنف، وواصلوا الكتابة من داخل الخراب. لكن أصواتهم لم تصل دوماً، وسط ضجيج الحرب، ووسط جمهور لم يعد يثق بسهولة.
هل يمكن استعادة الجمهور؟
ربما تكون هذه اللحظة هي الأصعب في علاقة المثقف بجمهوره. لكنها أيضاً لحظة فرصة. فحين تعم الفوضى، يكون الجمهور في حاجة إلى معنى، إلى تفسير، إلى خيط يُمسك به وسط التيه.
إذا استطاع المثقف أن يعيد صياغة لغته، أن ينخرط بصدق في معاناة الناس، أن يتحدث من داخل التجربة لا من فوقها، فقد يستعيد جمهوره – أو يبني جمهوراً جديداً.
لكن ذلك يتطلب شجاعة معرفية، وجرأة أخلاقية، ومرونة تواصلية. المثقف اليوم لا يكفي أن يكون عارفاً، بل يجب أن يكون حاضراً، متفاعلاً، وقادراً على الإصغاء بقدر ما يتكلم.
في هذه الحلقة حاولنا أن نسلط الضوء على تراجع السلطة المعرفية لصالح السلطة التأثيرية، حيث يقود المشهد من لديه عدد أكبر من المتابعين، لا من لديه معرفة أعمق ومع الإشارة إلى ان هناك جمهور صغير، لكنه نوعي، لا يزال يبحث عن خطاب معرفي نقدي. هذا الجمهور قد لا يكون صاخباً، لكنه يمثل الأمل في إعادة بناء المجال العام، واستعادة المعنى في زمن الفوضى.
شارك المقال