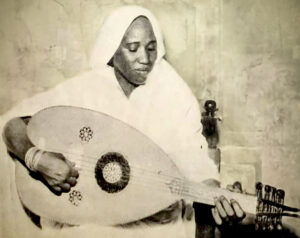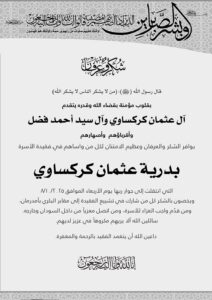غناء البنات في السودان: تعبير جريء عن الحب والواقع الاجتماعي ومواجهة للقيود المجتمعية
Admin 5 مايو، 2025 226

أ. د. فيصل فضل المولى
أكاديمي وباحث مستقل
• منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى اليوم، شكّل “غناء البنات” في السودان ظاهرة ثقافية غنية ومعقدة، لا يمكن اختزالها في مجرد أناشيد تُغنى في المناسبات. هو تراث نسائي شعبي نما في الهامش، لكنه ظل يؤثر في المركز، يُعبّر عن الذات، ويُحرّك الوعي، ويهزّ الثوابت. عبره، وجدت النساء السودانيات وسيلة بديلة — وربما وحيدة لفترات طويلة — ليُبدين آراءهن في الحب، والزواج، والرجال، والسياسة، والعدالة، وحتى المظالم الاجتماعية. لا عجب أن يُوصف هذا الغناء أحيانًا بأنه “برلمان البنات”، أو “ميكرفون الظل”، حيث الصوت الأنثوي يتجاوز الصمت المفروض ويتكلم بجرأة قد تُربك المجتمع أحيانًا، لكنها تكشف الكثير عن ديناميات السلطة والثقافة.
غناء البنات ليس مقصورًا على الأعراس والمناسبات الاجتماعية، كما يُروّج له في السياقات المحافظة، بل هو نتاج تاريخي لتفاعل المرأة مع الواقع، سواء في البيوت أو الأسواق أو الحقول أو الجامعات أو حتى في ميادين الثورة. ومع تطور الوسائط والمنصات، وجدت كثير من الفنانات أنفسهن أمام فرصة لتوسيع الأثر، وتحويل هذا الغناء من شكل محلي بسيط إلى أداة للمساءلة الاجتماعية والتمكين.
وتبرز أغنية “أنت وأنا” للفنانة السودانية إيمان الشريف كمثال يُجسد هذا النهج في غناء البنات، إذ تتناول الأغنية موضوع الحب والعلاقة العاطفية من منظور نسائي مباشر، حيث تُعبر الفنانة عن مشاعرها تجاه الحبيب بعفوية وصدق، دون خجل أو مواربة. الأغنية تؤكد مجددًا على أن للنساء الحق في التعبير عن رغباتهن، وتُعيد تشكيل صورة المرأة السودانية كذات فاعلة ومبادرة، لها صوتها الخاص الذي لا ينبغي تجاهله أو تحجيمه.
كما تُعَدُّ أغنية “أسياد اللواري” للفنانة رؤى محمد نعيم نموذجًا قويًا آخر لهذا الشكل من التعبير الشعبي. ففي كلماتها التي تحمل مزيجًا من العاطفة والقوة، تُعلن الفنانة حبها للرجل الذي تحبه وتقول: “حبيبي البريدو والليلة اتجنصص عشاني”. هذه العبارة البسيطة لكنها محمّلة بالمعنى، تُظهر كيف أن الحب لا يُختبأ، بل يُقال علنًا، حتى وإن كان ذلك في مجتمع يُقيّد مشاعر النساء ويُطالبهن بالكتمان. الأغنية لا تُظهر فقط مشاعر الحب، بل تؤكد قدرة المرأة على اختيار من تحب، وعلى إعلان هذا الحب بكل ما فيه من تضحية وصدق.
أما في أغنية “سايق الركشة” للفنانة عشة الجبل، التي انتشرت على نطاق واسع، فنجد مثالًا حيًّا على هذا النوع من التعبير الفني الجريء. ففي كلماتها، تخرج الفتاة عن المألوف لتُعلن إعجابها العاطفي تجاه شخصية من بيئتها اليومية، متجاوزة بذلك الخطوط الحمراء التي يرسمها المجتمع للفتيات في ما يتعلق بالبوح العاطفي والمبادرة بالمشاعر. هذا الشكل من الغناء لا يسعى فقط للتسلية، بل يطرح سؤالًا عميقًا حول من يملك الحق في التعبير، ومن يحدد ما هو “لائق” أو “غير لائق”.
وفي سياقٍ مختلف لكن متصل بالحراك السياسي والاجتماعي، تأتي أغنية “الميرم والكنداكة” للفنانة الراحلة شادن محمد حسين، التي استلهمت فيها رمزية المرأة السودانية القوية من التراث والتاريخ، لتُعبّر عن حضور النساء في ساحات النضال والوعي والثقافة. وقد ارتبط صوت شادن بالثورة السودانية، إذ كانت من الأصوات الحيّة في المشهد العام، تنقل التراث بأسلوب حديث وتحمل رسائل عميقة عن الكرامة والحرية. والجدير بالذكر أن شادن محمد حسين استشهدت في مايو 2023 إثر سقوط قذيفة على منزلها بأم درمان أثناء الحرب الدائرة في السودان، لتغيب عنا جسدًا، لكنها تبقى حاضرًة بصوتها ومواقفها، شاهدة على ثمن الكلمة في زمن القمع، وعلى هشاشة الحياة وسط العنف، حتى لمن يغنون للسلام.
هذا الغناء، بكل تنويعاته، هو بمثابة “أرشيف شفهي” لما لا يُقال في الصحف أو المنصات الرسمية. كلمات بسيطة، وإيقاعات مألوفة، لكنها محمّلة بالرسائل العميقة التي تُقاوم التهميش والنسيان. في كثير من الأحيان، تمثل هذه الأغاني ما يمكن تسميته بـ”النسوية الشعبية” التي لا تعتمد على النظريات الأكاديمية، بل على الملاحظة اليومية، والتجربة الحية، والشجاعة في التعبير.
وبالرغم من أن هذه الأغاني تواجه أحيانًا انتقادات بسبب جرأتها، إلا أنها تشكل حالة من المقاومة الناعمة، تكشف عن رغبة متزايدة لدى النساء في كسر القيود المفروضة عليهن، وفرض وجودهن كأصوات فاعلة في المجال العام. إنها محاولة لاستعادة الصوت، وإعادة تشكيل سردية المجتمع من منظور أنثوي شعبي، نابض بالحياة، ومرتبط بالشارع اليومي أكثر من أي منصة رسمية.
وفي سياق الحراك الاجتماعي والسياسي الأوسع في السودان، خصوصًا بعد ثورة ديسمبر 2018، يصبح غناء البنات امتدادًا ثقافيًا لهذا التغيير. فكما خرجت النساء إلى الشوارع يطالبن بالحرية والسلام والعدالة، خرجت أصواتهن أيضًا عبر الأغاني تُعيد تعريف دور المرأة في المجتمع وتُعزز من حضورها الرمزي في الثقافة السودانية.
ومع الاعتراف بكل ما يقدمه غناء البنات من مساحة للتعبير النسوي الشعبي، يبقى من المهم الإقرار بأن الغناء السائد لا يُمثّل بالضرورة كل مكونات المجتمع السوداني. فقد أشار بعض الباحثين والمثقفين إلى أن كثيرًا من مناطق السودان التاريخية، كأقاليم الشرق والغرب والشمال البعيد، لم تُتح لها فرص حقيقية لإدماج ثقافاتها ضمن النسيج الثقافي الوطني، نتيجة لعقود من التهميش البنيوي وضعف التمثيل الرسمي في أدوات الدولة الثقافية.
لذلك، فإن غناء البنات كما نعرفه اليوم قد يعكس تجربة شريحة اجتماعية محددة، لا كل السودان. ولعل اللحظة الحقيقية التي يُصبح فيها هذا الغناء تعبيرًا شاملًا عن المجتمع، ستكون حين تتبنى الدولة مشروعًا ثقافيًا يعكس التنوع الحقيقي للمجتمع السوداني، ويحترم كل روافده، لا يُقصي أحدًا منها، ولا يختزل “السودانية” في صوت واحد أو منطقة واحدة.
وفي هذا السياق أيضًا، يُبرز ما طرحه الباحث عادل إبراهيم في مقاله “أغاني البنات في السودان: التعدد السوداني في مواجهة أحادية السلطة”، حيث يرصد تطور الغناء النسوي من شكله المرتبط بالتقاليد الاجتماعية إلى شكله المعاصر كأداة مقاومة ثقافية. ويُظهر أن غناء البنات، وخاصة ما يُعرف اليوم بـ”أغاني القونات”، تحوّل إلى صوت التعدد ضد المركزية الثقافية القسرية، متحديًا القيود المفروضة من الدولة والمجتمع، ومُعبّرًا عن الهويات المهمشة بلغة شعبية جريئة، ومواقف حاسمة في الدفاع عن الوجود والتنوع.