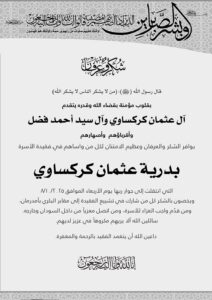نفس الملامح والشبه: السودان بين تكرار الأزمات وفرص كسر الحلقة
Admin 30 أغسطس، 2025 78
أ. د. فيصل محمد فضل المولى
أكاديمي وباحث مستقل
مقدمة: مرآة تتكرر صورها
• منذ فجر الاستقلال عام 1956، ظل السودان يعيش حالة مأساوية من التكرار المميت. انقلابات عسكرية، حروب أهلية، انتفاضات شعبية، اتفاقيات سلام، ثم انهيار جديد يعيد الدورة من بدايتها. وكأن البلاد محكومة بمرآة قاسية لا تعكس سوى صورة واحدة مهما تغيرت الأسماء والوجوه. هذه الصورة يمكن اختصارها في عبارة يرددها السودانيون بحسرتهم اليومية: «نفس الملامح والشبه».
هذه العبارة ليست مجرد وصف للتشابه بين أفراد أو أحداث، بل هي مفتاح لفهم مأزق السودان السياسي والاجتماعي. فهي تكشف أن حاضرنا ليس سوى نسخة باهتة من ماضينا، وأن جيل اليوم يعيد تجربة آبائه وأجداده دون نجاح في كسر الحلقة.
إن قراءة هذه العبارة في سياق ستة عقود من الاستقلال، تكشف أن المأساة ليست في اختلاف الحكام، بل في تشابه النهج، واستنساخ السياسات، وتكرار النتائج نفسها مهما اختلفت الظروف.
ولعل أكثر ما يثير الأسى أن السودان، بثرائه الطبيعي والبشري وموقعه الجغرافي الاستراتيجي، كان مؤهلاً لأن يكون نموذجًا في التنمية والاستقرار. لكن بدلاً من أن تتحول موارده الزراعية والمائية والمعدنية إلى قاعدة للتقدم، تحولت إلى لعنة تغذي الصراعات.
كما أن تنوعه الثقافي والإثني، الذي كان يمكن أن يكون مصدر قوة، صار ذريعة للحروب والانقسامات. بهذا المعنى، فإن عبارة «نفس الملامح والشبه» ليست فقط توصيفًا سياسيًا، بل هي تعبير عن مفارقة كبرى: بلد يملك كل مقومات النهوض، لكنه يكرر سقوطه في الحفرة نفسها مرة بعد أخرى.
الأخطر أن هذا التكرار لم يعد مجرد أحداث متشابهة، بل صار جزءًا من الوعي الجمعي. كل سوداني تقريبًا يمكنه أن يروي قصة نزوح، أو فقد عزيز، أو قمع سياسي، ثم يكتشف أن أبناءه يواجهون المصير ذاته. إننا أمام مأساة مستمرة يتوارثها الجيل تلو الجيل، حتى صار الماضي والحاضر والمستقبل حلقات متداخلة في مرآة واحدة لا تعرف سوى «نفس الملامح والشبه».
الاستقلال: بداية لم تكتمل
حين رُفع علم السودان في الأول من يناير 1956، بدت لحظة تاريخية عظيمة، لكنها سرعان ما كشفت عن هشاشة الدولة الوليدة. ورث السودان مؤسسات ضعيفة من الاستعمار، ونخبًا حزبية منقسمة على نفسها أكثر من انشغالها بمشروع وطني جامع.
النزاع بين الشمال والجنوب برز منذ البداية، وتحوّل سريعًا إلى حرب مسلحة. الانقسام بين الأحزاب الطائفية والحركات الحديثة، جعل الحكومات المدنية قصيرة العمر، وعاجزة عن إنجاز أي إصلاح حقيقي. بدلاً من أن يكون الاستقلال نقطة انطلاق، صار مرآة أولى لتكرار المأساة: انقسامات داخلية، صراعات نخبوية، وفشل في إدارة التنوع.
الانقلابات العسكرية: دورة القمع المتشابهة
في نوفمبر 1958، أطاح الفريق إبراهيم عبود بالحكومة المدنية الأولى، لتبدأ دورة الانقلابات التي ستصبح السمة الأبرز في التاريخ السوداني. تلاه جعفر نميري عام 1969، ثم عمر البشير عام 1989.
رغم اختلاف الخطابات، فإن الملامح متطابقة: عسكرة الدولة، تقييد الحريات، تركيز السلطة في يد فرد واحد، وتغذية النزاعات الداخلية. نميري رفع شعار الاشتراكية، والبشير جاء بمشروع «الإنقاذ»، لكن كليهما انتهى إلى استبداد مطلق وانهيار اقتصادي واجتماعي.
حتى طريقة السقوط حملت نفس الشبه: انتفاضات شعبية تجبر الطغاة على الرحيل، لتبدأ مرحلة انتقالية قصيرة، ثم تعود الدائرة من جديد. وكأن السودانيين يشاهدون الفيلم ذاته بأبطال مختلفين.
الحروب الأهلية: النار التي لا تنطفئ
منذ 1955، لم يعرف السودان عقدًا واحدًا بلا حرب. الحرب الأهلية الأولى في الجنوب (1955–1972)، ثم الثانية (1983–2005)، مرورًا بحرب دارفور (2003)، وصراعات جبال النوبة والنيل الأزرق، وصولاً إلى الحرب الراهنة في الخرطوم منذ 2023.
المكان يتغير، لكن الملامح واحدة:
• قرى محروقة، ومزارع مهجورة.
• ملايين النازحين واللاجئين.
• مجاعات وأوبئة تضرب الأطفال والنساء.
• خطاب رسمي يبرر القتل باسم «حماية الوطن».
التكرار هنا ليس صدفة، بل نتيجة بنية سياسية عاجزة عن إدارة التنوع وعدالة السلطة. وكأن الحروب قدر محتوم يعيد إنتاج نفسه جيلاً بعد جيل.
الانتفاضات الشعبية: وعود قصيرة العمر
ثلاث ثورات شعبية كبرى هزت السودان: أكتوبر 1964، أبريل 1985، وديسمبر 2018. جميعها بدأت بمشهد بطولي: جماهير تملأ الشوارع، شباب يهتفون بالحرية، نساء في الصفوف الأمامية، دماء شهداء تُلهب الشوارع.
لكن، بعد لحظات
الانتصار، يتكرر المشهد ذاته: فترة انتقالية قصيرة، صراعات بين القوى المدنية، تدخل الجيش مرة أخرى، ثم عودة الاستبداد. حتى ثورة ديسمبر التي بشّرت بعهد جديد، انتهت بانقلاب جديد، ثم حرب مدمرة في قلب العاصمة.
وهكذا، يتضح أن حتى الثورات، رغم اختلاف الزمان والأجيال، تحمل نفس الملامح والشبه في مآلاتها.
اتفاقيات السلام: نصوص مكررة بلا روح
وقّع السودان عشرات الاتفاقيات لإنهاء النزاعات: أديس أبابا 1972، نيفاشا 2005، الدوحة 2011، وجوبا 2020. لكن النتيجة واحدة: حبر على ورق، ثم انهيار الاتفاقيات بسبب غياب الإرادة السياسية.
نيفاشا أنهت الحرب الأهلية الثانية، لكنها قادت إلى انفصال الجنوب.
اتفاقيات دارفور كررت الوعود بالتنمية والمشاركة، لكنها انهارت سريعًا. كل اتفاق جديد بدا نسخة عن سابقه، بنفس الملامح: احتفال رسمي وضجيج إعلامي، ثم فشل في التطبيق.
الاقتصاد: أزمات مستنسخة
الحروب والانقلابات انعكست مباشرة على الاقتصاد. منذ السبعينات وحتى اليوم، ظل السودان يعاني الأزمات نفسها:
• تضخم خانق يفقد العملة قيمتها.
• اعتماد على صادرات محدودة مثل القطن والنفط.
• عجز مزمن في الميزان التجاري.
• أزمات غذاء متكررة ومجاعات.
رغم الموارد الضخمة، ظل الشعب يعيش في فقر مدقع. كل حقبة وعدت بالإصلاح الاقتصادي، لكن النتيجة دائمًا انهيار جديد. هنا أيضًا يظهر «نفس الملامح والشبه»: أزمات متكررة بلا حلول جذرية.
الثقافة والذاكرة: الشبه في الوجدان الشعبي
الأغنية والشعر السوداني وثّقا هذا التكرار. في أغاني مصطفى سيد أحمد، ومحجوب شريف، تتكرر صور الشهداء والأحلام المؤجلة. الأمثال الشعبية تردد أن «الحال ما بتتبدل»، والقصص الشفاهية عن النزوح والفقد تعيد إنتاج نفس الحكايات في كل جيل.
حتى في الذاكرة الفردية، صار كل سوداني يحمل قصة نزوح أو فقد أو قمع، ليجد أبناءه يعيشون القصة نفسها بعد عقود. هكذا، تحولت الثقافة نفسها إلى مرآة تعكس أن الملامح لا تتغير مهما طال الزمن.
الأجيال الجديدة: بذور مختلفة وسط التشابه
رغم كل هذا التكرار، هناك ملامح جديدة بدأت تتشكل. الشباب الذين قادوا ثورة ديسمبر ابتكروا أشكال مقاومة جديدة: لجان المقاومة، التنظيم الأفقي، استخدام الإعلام الرقمي لتوثيق الجرائم. النساء أصبحن في الصفوف الأمامية، يطالبن بالمشاركة الكاملة. هذه الملامح قد تكون مختلفة حقًا، إذا وجدت من يحميها ويحوّلها إلى مؤسسات دائمة.
التدخلات الإقليمية والدولية: تشابه السيناريو
في كل مرحلة، يظهر الدور الخارجي بنفس الملامح: دعم عسكري لأحد الأطراف، رعاية اتفاقيات هشة، واستغلال للأزمات لصالح أجندات إقليمية ودولية. السودان كان دائمًا ساحة صراع الآخرين، والنتيجة أن التدخلات لم تحل الأزمات بل أعادت إنتاجها.
كيف نكسر المرآة؟
عبارة «نفس الملامح والشبه» ليست مجرد توصيف شعبي، بل هي تشخيص سياسي لتاريخ كامل. السودان لم يفشل بسبب قلة الموارد أو نقص الإمكانات، بل لأنه ظل يعيد إنتاج الأزمات نفسها في دورات متكررة. هذا التكرار لا يعكس ضعفًا في الحاضر وحده، بل امتدادًا لفشل النخب في صياغة مشروع وطني يعلو فوق المصالح الضيقة.
لكن هذا لا يعني أن التشابه قدر محتوم. كسر الحلقة ممكن إذا:
• بُنيت مؤسسات قوية تحمي الديمقراطية.
• وُضعت سياسات تنمية عادلة توزع الثروة على الأقاليم.
• تحققت عدالة انتقالية توقف الإفلات من العقاب.
• أُعطي الشباب والنساء الفرصة لصياغة مستقبل مختلف.
ما يحتاجه السودان ليس مجرد تغيير في الوجوه، بل قطيعة مع أنماط الحكم والإدارة التي ظلت تعيد إنتاج الفشل. المطلوب هو مشروع وطني جامع، يقوم على رؤية استراتيجية طويلة الأمد، لا على حلول مؤقتة أو اتفاقيات جزئية. فالتاريخ أثبت أن الاتفاقيات التي لا تُبنى على عدالة ومؤسسات راسخة مصيرها الانهيار، وأن الثورات التي لا تملك حماية دستورية تتحول إلى جسر لعودة الاستبداد.
لقد آن الأوان للسودانيين أن يرفضوا أن يكون حاضرهم مجرد نسخة من ماضيهم. عليهم أن يصروا على صياغة ملامح جديدة لا تشبه إلا إرادتهم في الحرية والكرامة. المجتمع الدولي بدوره مطالب بدعم هذا التحول، لا بتغذية الصراعات أو الاكتفاء بالبيانات. السودان يحتاج إلى شراكات تنموية حقيقية، لا إلى وساطات شكلية تكرر الفشل.
وعندها فقط، يمكن أن تنكسر المرآة التي أسرت السودان ستة عقود. عندها لن يقال بعد الآن «نفس الملامح والشبه»، بل سيقال: «ملامح جديدة… تصنع تاريخًا مختلفًا وتفتح أفقًا جديدًا».
شارك المقال