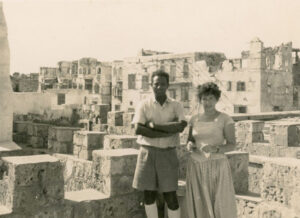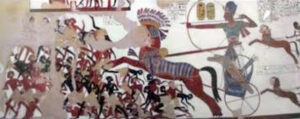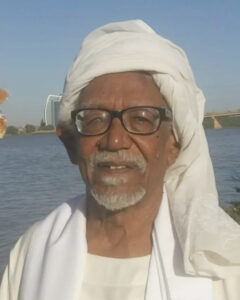
د. أحمد الياس حسين
أكاديمي متقاعد وباحث مستقل
• تناول الموضوع السابق «نصوص قبطية رقم 1) رسالة ملك المقرة إلى بطرك الإسكندرية، وذكرنا أن رد البطرك على هذه الرسالة وصل إلينا عن طريق روايتين: إحداهما رواية أبا منا وقد تناولناها مع رسلة ملك مقرة في الموضوع الأول. ويتناول هذا الموضوع الرواية الثانية لرد البطرك على رسالة ملك مقرة، وهي رواية ابن المقفع.
رواية ابن المقفع على رسالة البطرك إسحاق وتعليقه عليها
تناول ساورس بن المقفع- الذي كان عائشاً في القرن الرابع الهجري (10 م)- في كتابه تاريخ بطاركة الكنيسة المصرية، الأحداث التي وقعت في عصر البطرك إسحاق (67-70هـ/686-689 م) في تعليقه على الرسالة التي كتبها البطرك إسحاق إلى ملك الحبشة والنوبة. قال ابن المقفع:
«في تلك الأيام كتب البطرك [إسحاق] إلى ملك الحبشة وملك النوبة أن يصطلحا، ولا يكون بينهما سجس، وذلك لخلاف كان بينهما. فسعى به بعض أهل المكر إلى عبد العزيز بن مروان [والي مصر 65 – 85 هـ / 684 – 704م] وأرسل [الوالي] من يحضره [يحضر البطرك] ليقتله. ولما علم بذلك رجال البطرك في بلاط الوالي كتبوا كتباً بغير ذلك المعنى وأسرعوا في إرسالها إلى الرسل الذين أرسلهم البطرك. وقبل أن يصل البطرك إلى الوالي أحضر رجال الوالي رسل البطرك، فأمر بهم واطلع على الرسائل التي معهم فلم يجد فيها ما قيل له، فسكن غضبه على البطرك».
فابن المقفع يرجع هنا إلى رسالة ملك المقرة إلى البطرك إسحاق يشتكي فيها ملك نوباديا كما ورد في الموضوع السابق رقم 2. وذكر ابن المقفع أن عيون البطرك في بلاط الخليفة لما علموا بالأمر بإحضار البطرك، كتبوا رسالة مختلفة عن التي كتبها البطرك، وسارعوا بإرسالها إلى رسل البطرك، ولذلك لم يجد رسل الخليفة الرسالة الحقيقية، بل وجدوا رسالة جواسيس البطرك في بلاط الخليفة. ويخاطب البطرك في هذه الرواية ملكي الحبشة والنوبة. فمن هما هذان الملكان؟

فما المقصود بالحبشة في الرسالة؟
لم يكن مفهوم الحبشة في المصادر العربية المبكرة منحصراً فقط على منطقتي إثيوبيا وإرتريا الحاليتين، بل كان المفهوم واسعاً يتعدى حدودهما. فالمسعودي في كتابه مروج الذهب (ج 1 ص 37)، يقول عند حديثه عن مناطق جنوب أسوان:
«وعلى أميال من أسوان جبال وأحجار يجري النيل في وسطها، ولا سبيل إلى جريان السفن فيه هناك، وهذه الجبال والمواضع فارقة بين مواضع سفن الحبشة في النيل وبين سفن المسلمين. وفي مكان آخر (ج 1 ص 161) يقول: «وقد ذكرنا النتاج الذي كان بصعيد مصر مما يلي الحبشة».
وذكر القلقشندي (صبح الأعشى، ج 1 ص 444) عن حدود مصر الغربية: «وحدها الغربي يبتدئ من ساحل البحر الرومي حيث العقبة، ويمتد جنوباً، وأرض إفريقية غربيه، على ظاهر الفيوم والواحات حتى يقع على صحراء الحبشة على ثمان مراحل من أسوان».
فالمسعودي في النص الأول يتحدث عن الشلال الذي يفصل أسوان عن سفن الحبشة على النيل. فالحديث هنا عن الشلال الأول الذي ينتهي عنده إبحار سفن النوبة شمالاً. فالسفن هي سفن النوبة التي جاء ذكرها تحت اسم سفن الحبشة. وفي النص الثاني يذكر المسعودي أن صعيد مصر ينتهي أو يأتي بعد الحبشة. فالحبشة في نصّي المسعودي مرادٌ بها النوبة.
ويوضح القلقشندي في النص أعلاه أن صحراء الحبشة تقع جنوب الفيوم والواحات وعلى مسافة ثماني مراحل من أسوان. ومن المعروف أن الواحات المصرية تقع غرب النيل بينه وبين الحدود الليبية. فالصحراء الواقعة جنوب الواحات وبالقرب من أسوان، هي صحراء النوبة التي ذكرها القلقشندي تحت اسم صحراء الحبشة. فالحبشة عند كل من المسعودي والقلقشندي هنا مقصود بها النوبة، فملك الحبشة في رواية ابن المقفع مقصود به ملك النوبة.
وابن المقفع ذكر أن البطرك أرسل «إلى ملك الحبش وملك النوبة» فمن هو ملك النوبة؟
كما اتضح أعلاه فإنه في بعض الأحيان تطلق المصادر العربية لفظ الحبشة على النوبة، كما تطلق أيضا عبارة «ملك الحبشة» على ملك المقرة. فابن المقفع نفسه (ص 83)، يقول في مكان آخر عن ملك المقرة: «وكان ملك المقرة الحبشي ارتدكس وهو الملك العظيم».
فإذا كان ملك الحبشة في رسالة البطرك مقصوداً بها ملك مقرة، فمن المقصود بملك النوبة؟
أطلقت المصادر العربية اسم النوبة بصورة عامة على سكان مملكتي مقرة وعلوة، لكنها أطلقته بصورة خاصة على النوبة المجاورين لحدود مصر الجنوبية، وهم سكان المملكة التي عرفت في المصادر اليونانية بمملكة نوباديا، وعرفت في المصادر العربية بمملكة مريس.
ذكر ابن سليم في كتابه أخبار النوبة (ص 98): «اعلم أنّ النوبة والمقرة جنسان بلسانين، كلاهما على النيل، فالنوبة هم: المريس المجاورون لأرض الإسلام». فابن سليم يفصل بين النوبة والمقرة، ويوضح أن النوبة هم المجاورون لمصر، وهم النوباديون المعروفون في المصادر العربية باسم المريس. فما ورد في رواية ابن المقفع من أن البطرك أرسل «إلى ملك الحبشة وملك النوبة أن يصطلحا»، المراد به أن البطرك أرسل إلى ملك المقرة وملك نوباديا.
ورغم أهمية ما ذكره أبا مينا، وما يوضحه وجود مملكتي نوباديا والمقرة بعد حروب عبد الله بن سعد التي كانت عام 31 هـ / 652 م، إلا أن أغلب المؤرخين لم يتعرضوا لما ذكره، والقلة من المؤرخين الذين تناولوه لم يوفوه حقه من البحث والتقييم والنقد المنهجي.

آراء بعض المؤرخين
تناول فانتيني في كتابه تاريخ المسيحية (ص 74)، رسالة ملك مقرة إلى البطرك (الموضوع السابق رقم 1)، وأوضح أن ملك نوباديا كان يمنع مبعوثي البطرك المتوجهين إلى ملك المقرة ومبعوثي ملك المقرة إلى البطرك من المرور عبر أراضيه»، وعلق على ذلك قائلاً:» «ونستنتج من هذا أن مملكة نوباديا ما زالت مستقلة من ملك دنقلة في زمن البطرك المذكور»؛ ففانتيني يقرر أن مملكة نوباديا كانت لا تزال موجودة حتى عصر البطرك إسحاق الذي تولى منصبه عام 67هـ، أي بعد مضي 36 سنة من حرب عبد الله بن سعد للنوبة عام 31هـ.
فإذا كانت مملكة نوباديا موجودة على حدود مصر الجنوبية حتى عام 67 هـ/ 686 م، فيكون عبد الله بن سعد قد حارب مملكة نوباديا (مريس) عام 31 هـ/ 51-652 م. وقد نص على ذلك المسعودي كما ذكرنا في الموضوع رقم 12 من هذا الكتاب. ورغم ذلك يقول فانتيني (ص 88) «سار عبد الله بن سعد إلى النوبة عام 652 م إلى دنقلا رغم المقاومة الشديدة من النوبة، ودار القتال العنيف على ضواحي مدينة دنقلا». ومدينة دنقلة هي عاصمة مملكة المقرة.
أما مصطفى محمد مسعد في كتابه الإسلام والنوبة في العصور الوسطى (ص 74)، فلم يقبل ما كتبه أبا مينا، لأنه قال إن الاعتماد «على المصادر القبطية وحدها لا يعد دليلاً كافياً على صحته»؛ وهذا هو ما قصدته من القول بأن المؤرخين لم يهتموا بهذا النص ويوفوه حقه من البحث والتقييم والنقد المنهجي.

وأضاف مسعد أن ما ذكره أبا مينا «لا يتفق وما جاء في عقد الصلح سنة 652»، أي أنه بنى رأيه على ما ورد في نص المقريزي. وكذلك فعل كراوفورد (Crawwford, 23) وكيروان (Kirwank p 61) وآركل (Arkell, p186) ووليام آدمز (آدمز ص 404)، وكذلك فعلت الغالبية العظمى من المؤرخين، فأصبح اتحاد المملكتين قبل حرب عبد الله بن سعد من المسلَّمات التي لا تتطلب النقاش أو البحث.
وقد أبدى بعض المؤرخين شكهم في مصداقية بنود هذا الصلح الذي ذكره المقريزي كما فعل فانتيني نفسه (69 و71 و74-75) وتناول بعض المؤرخين هذا الرأي بحذر، مثل آركل Arkell, p 186)) الذي يقول على سبيل المثال: «من الممكن أن تكون مملكتا نوباديا ومقرة اتحدتا أمام خطر الغزو العربي عام 21 هـ/ 642م». ويقول أيضاً: «ويبدو أن عبد الله بن سعد غزاهم عام 31 هـ/ 652 م وجد أن كل البلاد من أسوان إلى حد مملكة علوة تحت حكم ملك واحد». ويلاحظ تعبير آركل جاء في النص الأول «من الممكن»، وجاء في النص الثاني «ويبدو أن عبد الله» أي أن وحدة المملكتين من الممكن أو ربما تمت قبل حرب عبد الله، وهذا حكم ظني غير قاطع.
ويرى مُنرو-ماي (Munro-Hay, p 97) أن بعض الباحثين يشك في أن المملكتين كانتا متحدتين عند غزوة عبد الله بن سعد عام 31ه/، ويشتبه في أن رواية المقريزي عن اتحاد المملكتين – مثل روايته عن المسجد – لا تعبّر عن عصر عبد الله بن سعد.
وهنالك قلة من المؤرخين مثل مونري دي فلارد (Monneret de Villard) وعلي عثمان محمد صالح (Ali Osman Mohamed Salih, p 59) عارضوا ما ورد في نص المقريزي من أن عبد الله بن سعد حارب مملكة مقُرة، وقرروا أن الحرب كانت مع مملكة نوباديا، أي أن مملكة نوباديا كانت لا تزال موجودة ومستقلة عن مملكة مقُرة.
ويوجد نصان عربيان تمت مناقشتهما في الموضوع السابق (رقم 12) من هذا الكتاب، يؤكدان ما ورد في النصوص القبطية. أحدهما للمسعودي في كتابه مروج الذهب (ج 2 ص 21)، يوضح أن عبد الله بن سعد حارب عام 31ه/ 51-652 م ملك مملكة مريس وعقد معه الصلح. قال المسعودي:
«وقد كان عمر بن الخطاب رضي اللّه عنه لما افتتح عمرو بن العاص مصر كتب إليه بمحاربة النوبة، فغزاهم المسلمون، فوجدوهم يرمون الحدق، وأبى عمرو بن العاص أن يصالحهم، حتى صرف عن مصر، ووليها عبد اللّه بن سعد، فصالحهم على رؤوس من السبي معلومة، مما يسبي هذا الملك المجاور للمسلمين المدعو بملك مريس من أرض النوبة ومن غيرهم من ممالك النوبة».

والنص الثاني في كتابه صورة الأرض لابن حوقل (ص 55)، جاء فيه:
«أسوان افتتحها عبد الله ابن أبي سرح سنة إحدى وثلاثين، وافتتح هيف؛ وهي المدينة التي تجاه أسوان من غربي النيل، وقد تدعى قرية الشقاق، وافتتح ابلاق؛ وهي مدينة في وسط النيل على حجر ثابتة وسط الماء منيعة الجزيرة وبينها وبين أسوان ستة أميال، وبحذائها على النيل من جهة الشرق مسجد الرّوينيّ وقصر آليه، وتحت المسجد بيعة النوبة، وهو آخر حد الإسلام وأول حد النوبة».
فهذان النصان يوضحان بصورة قاطعة أن عبد الله بن سعد حارب عام 31هـ/51-652 م ملك مريس (نوباديا) في منطقة أسوان. وبالتالي فإن عبد الله بن سعد لم يصل دنقلة، ومعاهدة البقط لم توقع مع ملك مقرة بل وقعت مع ملك مريس (ملك نوباديا).
هذا الموضوع جزء من موضوعات الطبعة الثانية من كتاب «مراجعات في تاريخ السودان» معد للطباعة.
شارك المقال