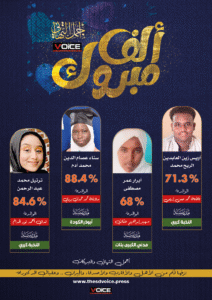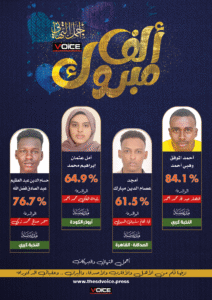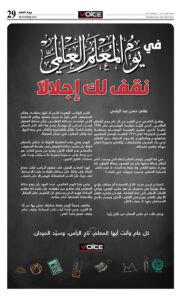الهوية الأكاديمية تحت التهديد: كيف تفقد الأستاذية معناها حين تصبح لاجئاً؟

د. إيهاب عبد الرحيم الضوي أحمد
اختصاصي تحليل بيانات وخبير إحصاء – عضو هيئة تدريس بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت
• في أحد مراكز الإيواء المؤقتة على حدود السودان الشرقية، وقف أستاذ جامعي خمسيني، بملامح يعلوها الشحوب والتعب، ينتظر دوره في طابور طويل للحصول على وجبة طعام ومستلزمات أساسية. يحمل في يده حقيبة مهترئة تحتوي على شهاداته الجامعية، رسائل توصية، وأوراقاً لم يقرأها أحد منذ شهور. كان حتى وقت قريب يدرس لطلبة الدراسات العليا في جامعة عريقة، يناقش أطروحات علمية معقدة، ويشارك في مؤتمرات إقليمية. الآن، يجلس تحت سقف بلاستيكي داخل خيمة مزدحمة، دون حاسوب، دون مكتبة، دون قاعة محاضرات. قال بصوت يغلب عليه الحزن «كنت أشرح مفاهيم التنمية المستدامة، واليوم لا أملك ثمن المواصلات إلى أقرب مدينة».
هذه القصة ليست استثناء، بل نموذج متكرر لمأساة طالت المئات من النخب الأكاديمية السودانية التي اضطرت لمغادرة منازلها ومكاتبها الجامعية، ولم تجد أمامها سوى مخيمات النزوح أو العيش على الهامش في دول الجوار. لم تكن الهجرة فقط فقداناً للسكن أو الراتب، بل كانت ضياعاً لجزء من الذات، للهوية العلمية، لمكانة اجتماعية تشكلت على مدى عقود من الاجتهاد والمثابرة.
منذ اندلاع الحرب في السودان في 15 أبريل 2023، لم تكن آثار الصراع محصورة في البنية التحتية أو الأرواح التي أزهقت فقط، بل امتدت بشكل بالغ القسوة إلى واحدة من أكثر الطبقات الاجتماعية حساسية وندرة: النخبة الأكاديمية والعلمية.
تقدر التقارير غير الرسمية أن المئات من أساتذة الجامعات السودانية والباحثين والخبراء الأكاديميين قد اضطروا إلى مغادرة أماكن عملهم، بل ومغادرة البلاد في كثير من الأحيان، دون أي حماية مهنية أو آلية دولية تضمن لهم الحد الأدنى من الاستقرار أو الاستيعاب في بيئات جديدة. الجامعات الكبرى في الخرطوم ومدن أخرى توقفت عن العمل، بعضها تعرض للنهب، وبعضها الآخر أصبح مسرحاً للعمليات العسكرية.
ورغم أن اللجوء الأكاديمي ليس ظاهرة جديدة عالمياً، إلا أن الحالة السودانية تكشف عن غياب شبه تام لسياسات وطنية أو إقليمية أو دولية تهدف إلى إنقاذ هؤلاء الأكاديميين من مصير التهميش والنسيان. فالجامعات في دول الجوار، وإن أبدى بعضها تعاطفاً مبدئياً، لم تقدم حلولاً ممنهجة أو فرص توظيف مؤقتة. أما المنظمات الدولية المعنية كـ اليونسكو أو مبادرات مثل Scholars at Risk، فإما غابت تماماً أو تعاملت مع الأزمة على استحياء، دون خطط طارئة تتناسب مع حجم الكارثة الأكاديمية.
إن هذا المقال يأتي في ظل هذا الفراغ المؤسسي، ليضع على الطاولة مأساة غير مرئية: مأساة تفكك النخبة العلمية في بلد كان يعول عليها في التنمية والإصلاح ما بعد الحرب. فحين تقطع الصلة بين الأستاذ ومؤسسته، وبين الباحث ومشروعه العلمي، لا نخسر أفراداً فقط، بل نخسر ذاكرة وطنية وقاعدة مستقبلية للتنمية. إنه نداء عاجل بأن الحرب لا تقتل بالرصاص وحده، بل بتفريغ المجتمعات من رموزها الفكرية، وتحويل حاملي الشهادات العليا إلى لاجئين بلا صفة.

ما هي الهوية الأكاديمية؟ ولماذا هي مهمة؟
الهوية الأكاديمية ليست مجرد وظيفة أو مهنة يؤديها الأستاذ الجامعي، بل هي حالة وجودية ومعرفية متكاملة، تتشكل بمرور الزمن من التفاعل اليومي مع مؤسسات التعليم، والطلاب، والبحث العلمي، ومجتمع المعرفة الأوسع. إنها تشبه «البصمة الفكرية» التي يحملها الأكاديمي، والتي تمنحه معنى لدوره، واعترافاً اجتماعياً بوجوده.
تقوم هذه الهوية على ثلاثة أركان أساسية:
1. الانتماء إلى مجتمع علمي: حيث لا يعمل الأستاذ في عزلة، بل كجزء من شبكة واسعة من الزملاء والباحثين والمؤسسات، يتبادلون المعرفة، وينتجونها، ويناقشونها ضمن أطر علمية واضحة.
2. نقل المعرفة والتأثير التربوي: الوظيفة التعليمية لا تقتصر على التلقين، بل هي عملية بناء للعقول وصياغة للأفكار. الأستاذ الجامعي لا يدرّس فقط، بل يُلهِم، ويوجه، ويرعى الأجيال الجديدة فكرياً.
3. البناء الذاتي حول المهنة الأكاديمية: كثير من الأكاديميين يرون في عملهم هويتهم الجوهرية، فهم ليسوا (موظفي تعليم)، بل :مفكرين ومربين، وباحثين، و مواطنين في مجتمع المعرفة العالمي.
ولكن، حين تفقد هذه الأركان الثلاثة دفعة واحدة -كما حدث مع مئات الأساتذة السودانيين بسبب الحرب- فإن النتيجة لا تكون فقط فقدان عمل أو راتب، بل انهيار داخلي مؤلم في التصور الذاتي. يتساءل البعض في لحظات الانكسار: من أكون الآن إذا لم أعد أدرّس، ولا أبحث، ولا يعترف بي أحد كأستاذ؟
هذا التهديد للهوية لا يُرى في العناوين الإخبارية، ولا يقاس بأرقام النزوح أو الخسائر المادية، لكنه يمثل أخطر أنواع الأذى: الأذى الصامت الذي يفتك بالكرامة والروح والعقل في آنٍ معاً.
تحليل نفسي اجتماعي: مظاهر التهديد للهوية
حينما يتحول الأستاذ الجامعي من شخصية فاعلة ومحورية في بيئته الأكاديمية إلى لاجئ على هامش المجتمع، تبدأ سلسلة من التحولات النفسية والاجتماعية العميقة، لا تقل قسوة عن فقدان المأوى أو الراتب. فالمعاناة هنا ليست فقط فيزيائية، بل وجودية.
• الشعور بفقدان القيمة الشخصية والكرامة المهنية
الكرامة بالنسبة للأستاذ الجامعي لا تستمد من المال، بل من القدرة على التأثير، والتدريس، والمشاركة في تطوير المجتمع. حين ينتزع هذا الدور فجأة، يشعر الكثير منهم وكأنهم (أجساد حية بأدوار منتهية). قال أحد الأساتذة الذين نزحوا إلى ساحرة البحر الأحمر: (كنت مرجعاً في تخصصي، الآن لا أحد يسألني حتى عن رأيي في خبر صحفي)!!
• العزلة الاجتماعية والابتعاد عن المجتمع العلمي
الانفصال عن الحلقات العلمية، والمؤتمرات، واللقاءات الفكرية يخلق فراغاً عاطفياً وفكرياً. يجد الأستاذ نفسه وحيداً، بلا طلاب، بلا زملاء، بلا نقاشات. قالت أستاذة جامعية نزحت من الخرطوم إلى شمال السودان: أفتقد حتى أبسط الأشياء، السبورة، الحديث العفوي في الممر مع طالب، وحتى رائحة الورق في المكتبة افتقدتها.
• الاكتئاب والضغط النفسي جراء البطالة والاغتراب
الضغوط النفسية الناتجة عن البطالة القسرية، والغربة، وعدم اليقين، تؤدي إلى حالات اكتئاب حاد لدى البعض. أشارت استبيانات غير رسمية إلى أن أكثر من 70% من الأكاديميين اللاجئين يعانون من أعراض القلق والتوتر المزمن، وأقل من 10% فقط تلقوا أي دعم نفسي فعلي.
• الشعور بعدم الجدوى أو (الفراغ العلمي)
إنها الحالة الأصعب. حين يشعر الأكاديمي أن ما يعرفه وما بناه من معرفة ومهارة بات بلا فائدة في واقعه الجديد، تبدأ دوامة الشك في الذات. يقول أحد الأكاديميين الضالعين في البحث العلمي: عندي أفكار بحثية كثيرة، لكنها الآن لا تساوي شيئاً، لا جامعة، لا منصة، لا تمويل، لا مستفيدين.
هذه المظاهر لا تقاس فقط من منظور إنساني، بل تؤثر على المجتمعات المضيفة أيضاً، لأنها تُهدر طاقات نادرة، وتمنع الانتفاع من كفاءات كان يمكن أن تسهم في التعليم والتنمية، حتى في ظروف اللجوء المؤقت.

البيئة المضيفة: إقصاء ناعم أم احتواء هش؟
حين غادر الأساتذة السودانيون بلادهم تحت ضغط القصف أو الانهيار الكامل للمؤسسات، لم تكن وجهتهم حلماً أكاديمياً بديلاً، بل كانت هروباً نحو النجاة. كثيرون ظنوا أن الجامعات في دول الجوار أو المؤسسات التعليمية الإقليمية قد تشكل ملاذاً مرحلياً، منصة احتواء مؤقتة تسمح لهم بمواصلة رسالتهم. لكن الواقع كان أكثر تعقيداً.
• جامعات مغلقة أمام الطوارئ
في معظم الدول التي لجأ إليها الأساتذة السودانيون، لم تكن هناك سياسات أو بروتوكولات واضحة لاستيعاب الأكاديميين اللاجئين. لا توجد قواعد طوارئ تسمح بالتوظيف المؤقت، ولا برامج مخصصة لإدماجهم في البحث أو التدريس، ولو بنظام الزائرين.
• العراقيل البيروقراطية
حتى حين تبدي بعض الجامعات مرونة شكلية، تصطدم النوايا الحسنة بسلسلة من المعوقات: توثيق الشهادات (وهو مستحيل في ظروف الحرب)، شروط الجنسية أو الإقامة، المعادلات الأكاديمية الطويلة والمعقدة، وضعف تمويل البرامج الأكاديمية المحلية أصلاً.
• احتواء هش بلا دعم
في حالات نادرة، تم قبول أساتذة سودانيين في بعض المراكز أو المبادرات، لكن غالباً دون أجور مناسبة، أو عقود رسمية، أو إشراك فعلي في اتخاذ القرار الأكاديمي. يشعر الكثير منهم بأنهم «حضور رمزي دون دور فعلي».
• الإقصاء الناعم
ما لم يُقال صراحة، يُمارس بصمت. كثير من الجامعات – ربما تحت ضغط الأولويات المحلية أو الحساسيات السياسية -اختارت سياسة «السكوت والتجاهل». لا تُغلق الأبواب بشكل مباشر، لكنها لا تفتحها حقاً. هكذا يتحول الأكاديمي اللاجئ إلى شاهد صامت، يحمل تاريخه دون حاضر. قال أحد الأساتذة: «حين طلبت فرصة لإلقاء محاضرة مجانية في تخصصي، قيل لي إن القاعات محجوزة لعام كامل. بعد أسبوع، عُقدت فيها دورة خارجية لشركة خاصة.»
في النهاية، غير مطلوب من الدول المضيفة أن تتحمّل كامل عبء الكارثة، لكن ما يطلب هو الحد الأدنى من إرادة الاحتواء، ومن فهم أن الأكاديمي لاجئ مختلف، يحمل في عقله ما يمكن أن ينقذ التعليم، لا يثقل كاهله.
دور المؤسسات الدولية: غياب مبادرات بحجم الأزمة
في خضم المآسي الكبرى، تتوجه الأنظار عادة نحو المؤسسات الدولية ذات الصلة، أملاً في تدخلات عاجلة، وبرامج دعم تنقذ ما يمكن إنقاذه. لكن في حالة الأكاديميين السودانيين اللاجئين، بدا المشهد مختلفاً؛ إذ بدت الجهات الدولية والإقليمية المعنية وكأنها لم تسمع بعد أصداء الانهيار الأكاديمي في السودان.
• اليونسكو والإيسيسكو: صمت مثير للقلق
بوصفها المنظمة الأممية المعنية بالتعليم والثقافة والعلوم، كان من المتوقع أن تطلق اليونسكو مبادرات استجابة سريعة لاحتواء انهيار قطاع التعليم العالي في السودان، خاصة في جانبه البشري والمعرفي. لكن ما صدر حتى الآن لا يتجاوز بيانات تضامن عامة، أو ورش عمل محدودة الأثر. أما الإيسيسكو – وهي منظمة إسلامية إقليمية معنية بالتعليم والبحث العلمي في الدول الأعضاء – فقد بدت غائبة عن المشهد تماماً، وكأن معاناة الآلاف من الأكاديميين السودانيين لا تدخل ضمن أولوياتها، رغم أن السودان عضو فاعل فيها منذ عقود.
• أين هي الشبكات الأكاديمية الإقليمية؟
المجالس التعليمية الخليجية، اتحادات الجامعات العربية، أو منظمات التعاون البحثي الإقليمي، لم تطلق أي برامج مخصصة أو منابر لاستيعاب الأساتذة المتضررين. لا قواعد بيانات، ولا دعوات للمؤتمرات، ولا فرص بحث بديلة.
هذا التجاهل لا يُفسَّر فقط بضيق الموارد أو تعقيد الوضع، بل ينذر بخطر أعمق: أن تتحول المأساة الأكاديمية إلى قضية منسية على هامش الأجندات السياسية والتنموية.
• مقارنة بنماذج عالمية: يمكن ما لا يُفعل
على الجانب الآخر، تقدم بعض النماذج الدولية إشارات إلى ما يمكن فعله لو وجدت الإرادة. من أبرز هذه المبادرات:
• Scholars at Risk: برنامج دولي نشط يقدم دعماً قانونياً وأكاديمياً للأساتذة المهددين، وينسق مع جامعات عالمية لاستضافتهم مؤقتاً.
• Council for At-Risk Academics (CARA) في بريطانيا: يوفر منحاً وتسهيلات لإعادة إدماج الأكاديميين اللاجئين في مؤسسات التعليم العالي.
• PAUSE في فرنسا: يقدم دعماً مالياً وتأهيلياً للباحثين المتضررين من النزاعات.
هذه المبادرات، وإن كانت محدودة النطاق، إلا أنها تؤكد أن الاستجابة ممكنة، لو وجد التخطيط والاعتراف بأهمية العقل الأكاديمي كأولوية إنسانية وتنموية. إن غياب هذه المبادرات في السياق السوداني يشكل فجوة أخلاقية، وفراغاً مؤسسياً لا يليق بتاريخ السودان الأكاديمي، ولا يليق بمن يفترض أن يكونوا شركاء في نهضة ما بعد النزاعات.
دعوة للإنقاذ: ماذا يمكن فعله الآن؟
إن إنقاذ النخبة الأكاديمية السودانية من التلاشي ليس رفاهية، بل ضرورة أخلاقية وتنموية ملحة. أمامنا فرصة – وربما واجب – لتصحيح مسار الإقصاء الصامت الذي يعيشه هؤلاء الأساتذة، عبر سلسلة من الخطوات الواقعية التي لا تحتاج إلى معجزات، بل إلى إرادة سياسية، ووعي مؤسسي، وشراكات جادة.
(1) إنشاء قاعدة بيانات للأساتذة السودانيين المهجّرين
الخطوة الأولى تبدأ بالتوثيق. لا يمكن دعم من لا نعرف مكانه أو وضعه. المطلوب هو تأسيس قاعدة بيانات مركزية – تدار بالشراكة بين منظمات أكاديمية دولية وجهات سودانية في الشتات – تضم أسماء الأساتذة، تخصصاتهم، أماكن وجودهم، ومستوى جاهزيتهم للاندماج في برامج أكاديمية. هذه القاعدة ستكون أساساً لأي تدخلات لاحقة، سواء من الجامعات أو منظمات التمويل أو مؤسسات التدريب.
(2) توفير منح مؤقتة واستيعاب أكاديمي مرن
يجب أن تتحرر الجامعات الإقليمية والدولية من البيروقراطية التقليدية، وتتبنى آليات مرنة للتوظيف المؤقت للأساتذة السودانيين. يمكن تصميم برامج زمالة قصيرة الأجل، أو مساقات محدودة الزمن، أو فرص إشراف مشترك مع جامعات أخرى، تمنح للأكاديميين حتى ولو بشكل تطوعي مبدئي. كذلك يمكن تفعيل التعاون مع المبادرات الدولية الناجحة مثل Scholars at Risk وCARA من خلال تخصيص مقاعد مضمونة للسودانيين.
(3) إطلاق مبادرات تعليم عن بعد يقودها الأساتذة النازحون/ اللاجئون
في ظل تعذر العودة إلى الجامعات السودانية المحاصرة، يمكن تأسيس منصات تعليمية إلكترونية تدار من الخارج، وتوظف فيها الكفاءات الأكاديمية اللاجئة لتقديم دورات ومحاضرات عبر الإنترنت، موجهة للطلاب السودانيين داخل البلاد وخارجها. هذه الخطوة ليست فقط إنقاذاً لمهنة الأكاديمي، بل أيضاً شريان حياة للطلاب الذين انقطعوا عن تعليمهم بسبب الحرب.
(4) ضمان دعم نفسي وتطوير مهني للمتضررين
لا يمكن إغفال البعد النفسي في هذه الأزمة. الأساتذة بحاجة إلى دعم نفسي احترافي يساعدهم على تجاوز صدمة النزوح وفقدان الدور. بالموازاة، يجب إطلاق برامج تطوير مهني تعيد تنشيط المهارات الأكاديمية، وتساعدهم على مواكبة المستجدات في تخصصاتهم، خاصة لأولئك الذين انقطعوا عن الممارسة لعدة أشهر أو سنوات.
وإجمالاً لما كتبته هنا، فهذه ليست مجرد مقترحات، بل دعوة مفتوحة لإنقاذ ذاكرة معرفية وطنية مهددة بالضياع. إن الأستاذ الجامعي ليس مجرد موظف حكومي، بل هو حارس لروح الأمة، وصانع لمستقبلها. فحين ننقذ أستاذاً من العزلة، ننقذ معه آلاف العقول التي كان سيلهمها.
خاتمة: الأستاذ الجامعي ليس رقماً في خيمة
في مشهد الحرب، كثيراً ما يتم النظر إلى الأكاديمي كرقم في إحصائيات اللاجئين، أو كصوت عابر في تقارير إغاثية لا تميز بين من كان يحمل كتاباً ومن كان يحمل بندقية. لكن الحقيقة أبعد وأعمق من ذلك بكثير. إن الأستاذ الجامعي هو حارس الذاكرة، ومهندس الوعي، وباني الإنسان. حين نفقده، لا نخسر فرداً فقط، بل نخسر مكتبة تمشي على قدميها، وخبرة كانت ستنتج قادة، وأفكاراً كانت ستصلح ما أفسدته الحروب. إن الهوية الأكاديمية ليست وثيقة نعلقها على الجدار، بل هي انتماء إلى عقلٍ جمعي، إلى مشروع وطني مستقبلي. لذلك فإن إنقاذ الأساتذة من النسيان، ومن التهميش، ومن التآكل النفسي، هو إنقاذ للبلد كله من مستقبل أكثر ظلاماً. وآخر ما أسطره هنا: حين نفقد أساتذتنا، لا نخسر أفراداً فقط، بل نخسر ذاكرة وطن، وركيزة المستقبل.
شارك المقال