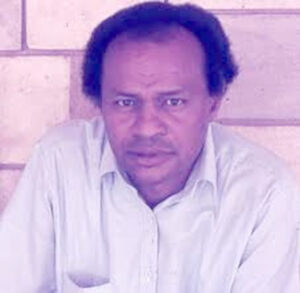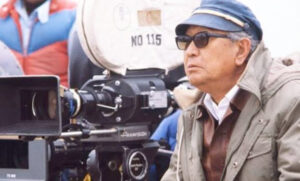د. أسامة خليل
• يقول الدكتور إبراهيم بسيوني-عميد كلية التربية بجامعة أسيوط- في كتابه «المنهج وعناصره» في معرض حديثه عن المناهج الدراسية بأن هذه المواد «تكتسب أهمية التخزين للاستخدام المستقبلي، وقد لايدرك الدارسون وقت دراستها أن لها أهمية أو قيمة في حياتهم، ولكنهم سيدركون أهميتها عندما يكبرون وينغمسون في الحياة، ويتعاملون معها، ويجابهون المشكلات، فعندئذٍ يسترجعون ما سبق أن درسوه، فيكون لهم عوناً ومعيناً في البحث عن حلولٍ للمشكلات والتعامل مع الحياة بكفاءة وفعالية أفضل». ومن هنا نرى الدور المتعاظم للمناهج الدراسية في بلورة وترسيخ الموروث الثقافي والاجتماعي والعقدي وسد حاجة المجتمع في حقول المعرفة المختلفة لأي أمة من الأمم في مجالات الحياة المهنية والنظرية.

وبأي حال من الأحوال ونحن نتحدث عن المناهج الدراسية والسياسات التربوية، لا يمكن أن نتجاوز التأثير الراكز للمؤسسات التعليمية الأهلية التي أنشأها رواد الطرق الصوفية ودورها في رفد المجتمع السوداني بقيمه الأخلاقية، ومفاهيمه الثقافية والعقدية الذين قامت على عاتقهم نشر الدعوة الإسلامية وتعاليمه السمحة، لما تميزوا به من فهمٍ عميقٍ للدين تفقهاً في علومه وبالمجتمع إدراكاً لحاجياته؛ فكانت الأهداف التربوية تلبي احتياجات المتعلم الدينية من خلال مؤسسة المسيد ودُور العبادة والمعاهد الدينية التي وجهت اهتمامها إلى معالجة القضايا المعرفية التي يحتاجها المسلم من حفظٍ للقرآن الكريم وتفسيره، ومعرفة أحكامه في العقيدة والعبادات والمعاملات، وتناول سيرته المباركة عليه أفضل الصلوات واتمَّ التسليم؛ وقوفاً على أخباره وآثاره.
ومع توسع التعليم المدني أنشأت وزارة المعارف معهد بخت الرضا كمؤسسة تربوية تضع المناهج وتشرف عليها، وهي من المؤسسات الرائدة في مجالها على النطاقين العربي والأفريقي، وعهد لهذا الدور رجال يشهد لهم التاريخ بالكفاءة والتجرد من أجل خدمة الأهداف العليا للعملية التربوية، وعلى تلك الأرضية الصلبة خرجت أجيال كانوا محل إعتزاز وتقدير تعدَّت مساهماتهم حدود الوطن ويكفي دورهم الفاعل في تأسيس البنية التحتية لدول الخليج العربي فردد الدهر حسن سيرتهم فهل ترى يعود ذاك الزمن؟!.
ليت إدارة تطوير المناهج تنظر إلى تجربة معهد بخت الرضا في وضع المناهج بحيث لايتم تغيير المنهج إلا بعد توفر الامكانيات المادية والبشرية وتوفير الكادر المؤهل من المعلمين الذين يتم اخضاعهم لفترة تجريب حقيقي للمنهج الجديد، ولكن كيف يتحقق ذلك والمدارس تفتقر إلى المعينات التعليمية من كتب وأثاث وتقنيات حديثة فضلاً عن غياب المعلم المؤهل بعد تسرُّب الخبرات إلى المدارس الخاصة والمهن الأخرى لمقابلة متطلبات الحياة المتزايدة يوماً بعد آخر.

ولا مندوحة أن تجتهد الإدارة التعليمية في تحديث المناهج بما يواكب هذا التطور والتحديث الذي ينتظم الحياة في مجالات المعرفة المختلفة، وفي الوقت نفسه لابد للحصيلة المعرفية أن تلعب دوراً مهماً في حياة الفرد بما يتسق مع ثقافته وعقيدته.
وهنا حقيقة لابد من ذكرها بالرغم من الاعتماد على التعليم المدني في إدارة شئون الحياة المختلفة إلا أن الحاجة لازالت ماسة إلى إلمام الطالب بقسط من التعليم الديني في مرحلة مبكرة قبل توجهه إلى العلوم العصرية بالقدر الذي يساعده على تذليل الكثير من مشاق البحث المضني في بعض فروع التخصصات العليا، لذلك نجد أن مسائل الزواج والطلاق والمواريث والعقود وأصول الفقه وغيرها من الفروع الملزمة لطالب القانون في تخصصه حتى لا يجد عسراً في هضم مسائلها والاجتهاد في القضايا المتعلقة بها بالإضافة إلى ذلك يحتاج ممتهنوا القضاء الجالس والواقف إلى الالمام بالموروث الشعبي وعادات القبائل وتقاليدها.
ومع تقدم الأبحاث في مجال الطب البديل ظهرت الحاجة إلى النظر في الطب النبوي درءاً لمخاطر العقاقير الطبية، وقد اطلعت في الأيام السابقة على حوار صحفي مع طبيب سوداني تخصص في الحجامة لمعالجة الكثير من الحالات المستعصية، والأمر برمته ينسحب إلى التخصصات الاقتصادية التي لاغنى لطالبها من أساس في فقه المعاملات وما يتصل بذلك من فهمٍ عميق للمعاملات المالية في المصارف لمعرفة الطرق الشرعية من التشريعات والقوانين السارية ومدى تطبيقها داخل المصارف، وطريقة التعامل مع النواحي الفقهية، ومدى التزام العملاء والمتعاملين مع المصارف بالتطبيقات الشرعية، وحتى لانخرج عن سياق ما نحن بصدده نذكر القاريء ببعض الدراسات القيمة في هذا المجال للبروفسور محمد صفي الدين العوض أستاذ الاقتصاد بجامعة الخرطوم، وشوقي دنيا، وسيد هواري، وأحمد النجار.

وفي علم النفس لا يمكن أن نتجاوز الجهود الكبيرة التي قدمها البرفسور فاخر عاقل أستاذ علم النفس بجامعة دمشق والكاتب بمجلة العربي في علم النفس الإسلامي من خلال نقده العلمي لمدارس علم النفس المعروفة مثل مدرسة علم النفس المادي لبافلوف الروسي وعلم النفس الجنسي لفرويد في نظريته التي ربط فيها علم النفس بالجنس وأدلر الذي ارتبط عنده بمركب النقص فأخذ الجوانب الإيجابية من تلك النظريات وطرح فاسدها وله مؤلفات كثيرة في هذا المجال.
أما في الفلسفة فللإمام أبو حامد الغزالي آراء جديرة بالاهتمام وخاصة في كتابه «تهافت الفلاسفة» الذي يقف شاهداً على تمكنه من هذا العلم بعد دحضه لكثير من آراء الفلاسفة من خلال مناظرته لهم. وقد أردنا من هذا الاستطراد ربط العملية التعليمية بقيم المسلم الروحية والأخلاقية من خلال التأسيس الراشد لمبادئ العلوم الدينية والذي يفتقر بعض اختصاصيي العلوم الإسلامية للأسف إلى أساس متين في مبادئه. وفي هذا السياق أشار الدكتور عبدالله الطيب في كتابه «نظرات في المجتمع الإسلامي» إلى غياب التمهيد الممنهج في علوم الدين لاستيعاب المواد الرئيسية في أقسامها العليا حين قال:»أن الطالب الجامعي الذي يتخرج بشهادة بكالوريوس مكونة في جوهرها من برنامج مرتجل، لا يجوز بحالٍ من الأحوال أن يسمى خريجاً يعتمد عليه في علوم الدين».
شارك المقال