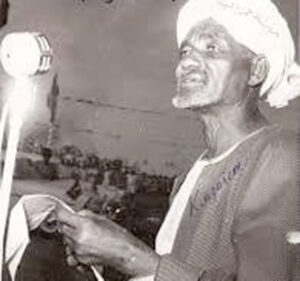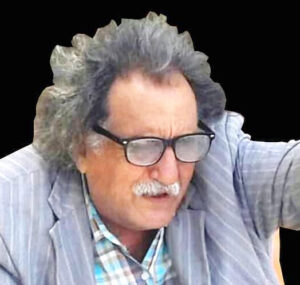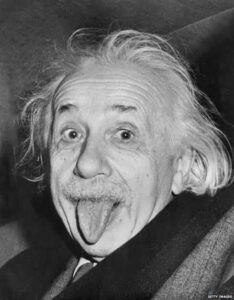قراءة نقدية في قصيدة الشاعرة ساجدة الموسوي: وَهَلْ يَسْكُتُ الحرُّ عمّا جَرَى ؟!
Admin 30 أغسطس، 2025 280

د. غانم السامرائي - العراق
أستاذ الأدب المقارن
تمهيد
• تضع الشاعرة العراقية الكبيرة ساجدة الموسوي قصيدتها ’وهل يسكتُ الحرُّ عمّا جرى؟!’ في تخوم نوعين شعريَّين متعالقَين: شعر الشهادة (التوثيق الأخلاقي للحدث/الجرح) وشعر الاحتجاج (الخطاب التحريضيّ المناهِض للصمت والتواطؤ). فهي حينما تتوجّه ’إلى الأستراليين الذين تظاهروا من أجل غزّة’ فإنما تجعل من التضامن العابر للجغرافيا نقطةَ بدءٍ جماليّة وأخلاقيّة، ومن غزة نقطةَ اختبارٍ لمعيار إنسانيّ كونيّ. هذا الإطار يُملي على النص بنيةً تتدرّج من المشهديّ البهيّ (المظلّات/الورد/المطر) إلى الكارثيّ الفاجع (الجوع/العطش/الفناء)، وتتوسّل في انتقالها آليّاتٍ إيقاعيّة وتصويريّة وخطابيّة ترسّخ أطروحتها.
أولًا: البناء الإيقاعي – من إيقاع التفعيلة إلى إيقاع الموقف
تتحرّك القصيدة في أفق قصيدة التفعيلة (الحرّة)، حيث يتراجع الإيقاع الوزنيّ الصارم لصالح إيقاع الموقف والموسيقى الداخلية التي تتولّد من:
اللازمة الاستفهاميّة الإنكاريّة: ’وهل يسكتُ الحرُّ عمّا جرى؟!’ هي جملةٌ تؤدّي وظيفةَ المحور الإيقاعيّ الذي تعود إليه النبرة لتثبيت الأطروحة. إن صيغةُ السؤال هذه ليست طلبًا للجواب بل تصعيد إيقاعيّ للحكم الأخلاقي.
التوازي والترصيع الصوتي: ’ولا مَن يُدين / ولا مَن يذود’، ’عصرُ الجنون / عصرُ الظلام / عصرُ المجون’ عبارات تتجاورُ التركيباتُ المتوازية لتولّد جرسًا يرسّخ الدلالة (التنديد/الافتضاح)، ويُحكِم إيقاعَ التوالي النبريّ .
إيقاع الأفعال الإنشائيّة (الأوامر والنداءات): في هذه العبارات، ’صوّري… وثّقي…’، ’فيا أرضُ…’، يتحوّل الفعل الإنشائي إلى انضباط إيقاعي يسرّع النسق، ويحوّل القارئ من التلقّي السلبيّ إلى موقعِ المشاركة.
التدوير وتقطيعُ الأسطر: تتعمّد الشاعرةُ القطع لتأجيل اكتمال المعنى – مثل ’وكانوا جموعًا تحدّوا مواعيدهم / وصباحاتِ قهوتهم / ولم يأبهوا للمطر…’ – بما يخلق توقّعًا إيقاعيًّا وتوتّرًا دلاليًّا في كلّ كسرة سطر.
الإيقاع الصوتيّ الحرفيّ: الحضورُ الكثيف للحروف المُفخَّمة (ص/ض/ط/ظ) في مقاطع الألم (’تصرخ’ ، ’الظلم’، ’الظمأ’) يقابله ليونةُ ميمات ونوناتٍ في مقاطع العطف والتوادّ، بما يعكس تبادلاً لحنيًّا بين حدّة الفاجعة ورقّة التعاطف.
بهذه التقنيات لا تُعيد القصيدة إنتاج وزنٍ تقليديّ، بل تبتكرُ طاقةً إيقاعيّة تُحاذي انفعالاتها وتخدمُ منطقهَا الاحتجاجيّ.
ثانيًا: التقنيات الشعريّة – دراماتورجيا الخطاب وتحوّلات المنظور
تشتغل القصيدة على حزمةٍ من الوسائل البلاغيّة والسرديّة تُكسب خطابها حركيّةً دراميّة:
الاستفهام الإنكاري بوصفه تقريرًا أخلاقيًّا: سؤال العنوان/اللازمة يؤسّس لبرهنةٍ عاطفيّة: كلُّ جوابٍ محتمل يقود إلى نفي إمكان السكوت.
الالتفات وتعدّد المخاطَبين: تنتقل من المشهد الغائب (’سماءُ المظلّات’) إلى مخاطبة الأرض (’فيا أرضُ’) والكاميرات (’صوّري’) والجماعة (’آن لمن يستطيع… أن يقول رؤاه’).
الإنشاء الطلبيّ (الأمر/النداء/التمنّي): ’ألا ليتني معهم’، ’صوّري’، ’وثّقي’ هي أدواتٌ تُفعّل الأدائيّة فالكلامُ نفسه فعلٌ احتجاجيّ.
المفارقة البصريّة: من ’حقلِ وردٍ على طولِ جسر الحياة’ إلى ’عظامٌ كستها الجلودُ… سقطت في العراء ظماءً’. يصوغ هذاالانتقال الحادّ مُفاصلةً أخلاقيّة بين عالمين.
المعجم المائيّ بوصفه بُنيةً ضدّيّة: (مطر/ماء/شربة) (ظمأ/جوع/فناء). تتوزّع هذه المفردات ذات الحقل الواحد بين قطبين لتُنتج طباقًا دلاليًّا يعرّي بشاعةَ حصار الماء.
الانزياح والتركيب: قولها ’عظامٌ كستها الجلود’ يعدل عن المألوف (جلودٌ تكسي عظامًا) ليُقدّم البنيةَ العميقة للخراب: ما يتبقّى هو العظمُ/الموت، والجلدُ مجرّد غشاءٍ باهت؛ إنّه انزياحٌ مُبرمج يفضح ترتيب الأولويّات في الكارثة.
السخرية المُرّة بالتجريد الزمنيّ: ’عصر الجنون/عصر الظلام/عصر المجون’ هي ثلاثيّةٌ تُنتج توقيعًا خطابيًّا وتوظّف جناسًا ناقصًا (الجنون/المجون) يُضاعف أثر الإدانة.
ثالثًا: الصورة الشعريّة والأسلوب التصويري:
مشهد الافتتاح (الكانفاس البصري): ’سماءُ المظلّات… السحبُ الماطرات… حقلُ وردٍ… جسرُ الحياة’. هنا يتعانق الاصطناعيّ (المظلّات) والطبيعيّ (السحب) في تماهٍ استعاريّ يُحوّل حشود المتظاهرين إلى بستانٍ إنسانيّ. و ’الجسر’ هنا ليس مكانًا فحسب بل عتبة عبور من الخاصّ إلى الكونيّ.
مشهد الحصار: ’لقد أغلقوا حولها كلّ باب ولم يبقَ إلا الفناء’. هنا يصير الفضاءُ قفصًا دلاليًّا: أبوابٌ تُغلق أفقٌ يُمحى فناء. إنّه تصويرٌ مكانيّ للحكم بالإعدام.
مشهد الجوع والعطش: كادراتٌ قريبة على الجسد: ’عظامٌ كستها الجلود’، ’سقطت في العراء ظماء’. إن توظيف الواقعيّة الفجّة هنا لا يبتذل الألم بل يجرّده من التزيين.
مشهد التوثيق/الفضح: ’صوّري أيّتها الكاميرات… وثّقي عار عصر الجنون’. هنا تتحوّل الكاميرا إلى شخصيّةٍ شعريّة (تَشخيص)، تتلقّى أمرًا ملزِمًا: ليس الجمالَ بل العار هو موضوع التصوير. هنا تتأسّس جماليّة القبح بوصفها احتجاجًا.
اقتصاد اللون والملمس: من ألوان الورد والمطر إلى بهتان الجلد والعظم؛ انتقالٌ لونيٌّ وملمسيّ يُعيد تشكيل الحسّ كي يرى القارئ ما يُراد له أن يراه.
رابعًا: الرمزيّة – حقولٌ إيحائيّة ومراياُ تناصّ
تستند رمزيّة القصيدة إلى علاماتٍ واضحة تُغني القراءة:
المظلّات/الورد: رمزا حمايةٍ وتفتّحٍ في قلب العاصفة؛ الجمال ليس ترفًا بل استراتيجيةُ مقاومة. المظلّةُ سقفُ كرامةٍ، والوردُ بيانُ سلمية.
جسر الحياة: عتبة عبور اجتماعيّ وأخلاقيّ.
إغلاق الأبواب/الفناء: حقلٌ رمزيّ للحصار، يَسْتَحضر دلالة قطع الأكسجين الأخلاقيّ عن غزة.
الأرض التي تنطوي كالسِّجلّ: إحالةٌ تناصيّة لصورٍ قرآنيّة تتوسّلها الشاعرةُ لا للتنبوء الأُخروي، بل لتقول: إذا تعطّلت القيم طُويت صفحةُ المعنى.
الكاميرات: رمزُ الشاهد/الحَكَم في زمن الصورة؛ لكنّها أيضًا مرآةُ عجزٍ إن لم تُترجم المشاهدةُ إلى فعلٍ. لذا تُؤمَر: ’صوّري… وثّقي’، في مفارقةٍ تُدين حيادَ العين.
خامسًا: المفاهيم والرؤية الفكريّة
تتجاوز القصيدة التمثيل إلى التقعيد الأخلاقي:
مبدأ عدم البراءة بالصمت: ’وإن صمتوا شعروا أنّهم شركاء’. تُعلن القصيدة مفهوم المشاركة السلبيّة: الصمتُ ليس حيادًا بل اشتراكٌ في الجُرم.
كونيّة الضمير: إهداءُ النص للأستراليين لا يُجمّل الغربَ ولا يُشيطن الشرق؛ إنّه يؤكّد إمكانَ الضمير العابر للحدود.
العدالة بوصفها فعلَ قول: ’آنَ لمن يستطيع البراءة… أن يقول رؤاه’. هنا يُعاد تعريف الفعل السياسيّ على أنّه قولٌ مُؤثّر.
تفكيك خطاب الحضارة الراهنة: ’عصر الجنون/الظلام/المجون’ ثلاثيّةٌ تُسائل شرعيّة الحداثة الأداتيّة حين تُدار الرفاهيةُ على حساب الإبادة/التجويع. ههنا ينتقل النصّ من الرثاء إلى النقد الحضاريّ.
أخلاقيّة الماء/التجويع بوصفها اختبارًا إنسانيًّا: توسيع حقل الماء (مطر/شربة/ظمأ) يُحيل إلى حقٍّ بيولوجيّ/أخلاقيّ أصيل.
تحويل المشاهَدة إلى توثيق: إن الأوامر الصادرة للكاميرا تُؤسّس لأخلاقيات التصوير زمن الحروب: إن رأيتَ فعليك أن تُوثّق، وإن وثّقتَ فعليك أن تدين. هكذا تُقفل القصيدة على سؤالٍ متوالد ’لماذا… لماذا… لماذا…’ ليصبح منطقُ الاستفهام منطقَ محاكمة.
سادسًا: البنية العامّة
تُحسن الشاعرة تدبيرَ الانتقال من الافتتان الجماليّ بالمشهد المتضامن إلى تفجير الفاجعة: بنيةٌ حلزونيّة تتقدّم عبر دواماتٍ ثلاث: (مَنظرٌ إنسانيّ باذخ) (تشخيص الخطر/السكوت) (توثيق العار/استدعاء الفعل).
خاتمة
لا تُراهن القصيدة على زخرفةٍ بل على اقتصادٍ تعبيريٍّ موقظ: الصور مكثّفة، المعجم مُنتقى، الإيقاع مُسخَّرٌ لإلزام القارئ أخلاقيًّا. بهذا المعنى، تندرج قصيدة ساجدة الموسوي في تقليدٍ حديث لـشعر الشهادة والاحتجاج، حيث تتكامل البُنى الإيقاعيّة والتقنيّات الأسلوبيّة والرموز الموجِّهة لتشييد حُجّةٍ شعريّة
* سبق ان نشرنا القصيدة بفويس فى عدد سابق وتمت ترجمتها للغة الانجليزية من قبل الدكتور غانم السامرائي.
شارك القراءة