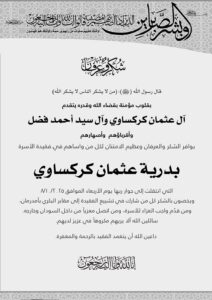بقلم: هنيدة التني
• تشكل الحروب والكوارث نماذج صارخة للظروف الاستثنائية التي تهز أركان العقود، وتطرح تساؤلات مصيرية حول مصير الالتزامات التعاقدية أثناءها وبعد زوالها. تتحول قصة مستأجرين عاديين مثل «عمر» الذي غادر بيته هرباً من ويلات الحرب، و«سليم» الذي بقي محاصراً فيه دون أن يتمكن من الانتفاع به، إلى حالة دراسية معبرة عن إشكالية قانونية عميقة.
فمع انتهاء النزاع وبدء مرحلة التعافي، يبرز السؤال الجوهري: هل تعود الالتزامات التعاقدية، وعلى رأسها عقد الإيجار، إلى سابق عهدها تلقائياً بمجرد زوال الظرف الطارئ؟ يسعى هذا المقال إلى تفكيك هذه الإشكالية من خلال تحليل المستويين الواقعي والقانوني. على المستوى الواقعي، نجد أن تجربة المستأجر خلال الحرب (مغادرة أم بقاء تحت التهديد) تختلف جذرياً، مما يثير تساؤلات حول عدالة مطالبة كلا الطرفين بنفس الالتزامات. أما على المستوى القانوني، فيتطلب الأمر الغوص في نظريتي «القوة القاهرة» و«الظروف الطارئة» والتمييز بينهما، وكذلك فهم الآثار المترتبة على كل منهما، بين تعليق مؤقت للالتزامات أو انقضائها كلياً.
سيعتمد هذا التحليل على أحكام القانون المدني، ولا سيما قانون المعاملات المدنية السوداني (المادة 318)، كمثال تطبيقي، مع الاستناد إلى آراء أعلام الفقه القانوني مثل الدكتور عبد الرزاق السنهوري، وإلى المبادئ المستمدة من الفقه الإسلامي التي تقرر قاعدة «لا ضرر ولا ضرار». الهدف هو تقديم إطار واضح يُجيب عن سؤال استئناف الالتزامات تلقائياً من عدمه، وما إذا كان زوال الحرب يعني بالضرورة عودة كل شيء إلى ما كان عليه، أم أن الأمر يتطلب إعادة نظر في بنود العقد أو حتى فسخه وإبرام عقد جديد يحقق التوازن والعدالة بين أطراف العلاقة التعاقدية في مرحلة ما بعد الأزمة.
هل تعود الالتزامات تلقائيًا؟
حين بدأت الحرب، كان «عمر» يعرف أن البقاء في المدينة خطر، فغادر بيته المستأجر، حمل أسرته وخرج تحت صوت القصف، وأغلق الباب خلفه دون أن يعلم متى سيعود. لم يكن معه سوى بعض المال وبعض الأوراق الثبوتية، وأمل خافت في أن تعود الحياة كما كانت.
في الجهة الأخرى من المدينة، قرّر «سليم» أن يبقى. لم يكن يملك خيار الرحيل، أو ربما لم يرغب في ترك منزله المستأجر. بقي فيه طوال الحرب، لكن ليس كما يبقى الإنسان في منزله، بل كما يبقى في قوقعة: لا كهرباء، لا ماء، لا حركة، لا أمان. لم يكن يخرج من البيت إلا نادرًا، وبخوف شديد، وكل أعماله توقفت، بقي في المكان، لكنه لم يكن يعيش كما يعيش الناس، بل كما يُحاصر الإنسان في بيته: بلا عمل، بلا راحة، بلا أمان.
مرت الشهور، ثم خفت أصوات المدافع. الحرب انتهت. عاد «عمر» إلى بيته ليجده كما تركه، مغبرًّا، صامتًا.
أما «سليم»، فقد فتح الباب في أول يوم هدوء، ووقف أمام البناية محاولًا تذكّر كيف كان شكل الحياة قبل الحرب.
في الأسبوع ذاته، طرق المؤجر بابيهما، ليسأل السؤال نفسه:
«هل ستدفع الأجرة عن الشهور الماضية؟»
لكن هل الإجابة واحدة؟
هل يُلزم عمر بالأجرة رغم أنه لم يكن موجودًا؟
هل يُلزم سليم رغم أنه كان مقيمًا دون انتفاع حقيقي؟
وهل انتهاء الحرب يعني عودة الالتزامات كما كانت؟
هل يُستأنف العقد تلقائيًا؟
هذه الأسئلة تفتح لنا بابًا مهمًا للنقاش حول التزامات الإيجار بعد زوال الظروف الاستثنائية مثل الحرب، وما إذا كانت الالتزامات التعاقدية تعود تلقائيًا أم لا.
في القانون المدني، وخاصة في العقود الزمنية كعقد الإيجار، يُعتبر الظرف الطارئ سببًا مشروعًا لتعليق تنفيذ الالتزامات مؤقتًا، دون إنهاء العقد تلقائيًا. ويُعد هذا التعليق حالة استثنائية، حيث يُجمّد أثر العقد إلى حين زوال الظرف الذي حال دون تنفيذه.
ومن الناحية النظرية، فإن زوال العذر زوالًا حقيقيًا – كعودة الحياة إلى طبيعتها، وزوال آثار الحرب، واستعادة إمكانية الانتفاع بالعين المؤجرة – يعيد العقد إلى حالته الأولى، ويستأنف تنفيذ الالتزامات كما كانت عليه، ما لم يكن قد تم تعديل العقد أو فسخه خلال فترة الظرف.
لكن من المهم الإشارة إلى أن العقد قد يُفسخ أثناء استمرار الظرف الطارئ، وليس بالضرورة أن ينتظر الطرفان زواله. وقد نصّ قانون المعاملات المدنية السوداني على ذلك في المادة 318 من القانون تُجيز للمستأجر فسخ عقد الإيجار إذا ترتّب على تنفيذه ضررٌ بالغ في النفس أو المال له أو لمن يتبعه في الانتفاع بالمأجور، وإذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد.
وهنا يُفهم من عبارة «من يتبعه في الانتفاع بالمأجور» أنها تشمل من انتقل إليه الحق في الانتفاع، سواء بعقد إيجار من الباطن، أو في حال كان المستأجر الأصلي قد منح الإيجار إلى طرف ثالث، أي كان مانحًا للإيجار. وفي هذه الحالة، يتسع نطاق الحماية ليشمل من يُعتبر متضررًا من استمرار العقد، حتى لو لم يكن طرفًا مباشرًا فيه.
كما تجدر الإشارة إلى أن قانون المعاملات المدنية السوداني، في المادة 318، يمنح للمستأجر حق فسخ عقد الإيجار إذا حدث ما يمنع تنفيذ العقد، ويقصد بعبارة «ما يمنع تنفيذ العقد» – بحسب الفهم المستقر – أن يطرأ مانع فعلي يحول بين المستأجر وبين الانتفاع بالعين المؤجرة، أي أن تنفيذ العقد يصبح غير ممكن من ناحية واقعية. فالمستأجر، بطبيعته، لا ينتفع بالعقد إلا إذا تمكن من استخدام العين المؤجرة. فإذا حالت الحرب – أو غيرها من الظروف القاهرة – دون ذلك، كأن تُقفل الطرق، أو تُمنع الحركة، أو يُهدَّد الأمن، فإن أساس العقد ينهار مؤقتًا، ويحق له المطالبة بفسخه، دون أن يُعد ذلك إخلالًا من جانبه.

الفرق بين وجود ظرف طارئ وتعذر التنفيذ وبين زوال الظرف ووجوب استئناف العقد
*الظرف الطارئ وتعذر التنفيذ (مرحلة الأزمة):
يُعد الظرف الطارئ حدثًا استثنائيًا عامًا، غير متوقع الحدوث، يقع بعد إبرام العقد، ويجعل تنفيذ الالتزام ممكنًا من الناحية المادية، ولكنه مرهق جدًا للمدين ومختل التوازن الاقتصادي للعقد على نحوٍ يجعله غير عادل. وفي هذه الحالة لا تنقضي الالتزامات، وإنما يجوز للقاضي أن يتدخل لتعديل شروط التنفيذ تحقيقًا للعدالة بين الطرفين.
أما تعذر التنفيذ فيقع عند حدوث قوة قاهرة أو ظرف خارجي استثنائي يجعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً استحالة كلية، سواء كانت الاستحالة مادية أو قانونية، كما في حالة دمار العين المؤجرة بسبب الحرب. وهنا ينقضي الالتزام لزوال محله أو لاستحالة الوفاء به.
في تمييزه بين الظرف الطارئ والقوة القاهرة، أشار الدكتور عبد الرزاق السنهوري في كتابة الوسيط في شرح القانون المدني إلى أن لو أن الحادث الطارئ قد جعل تنفيذ الالتزام مستحيلاً لكان يعد قوة قاهرة يُنقضي بها الالتزام، أما إذا كان الحادث لا يتجاوز كونه مجرد ظرف طارئ يجعل تنفيذ الالتزام مرهقًا على التاجر أو المدين دون أن يصل إلى حد الاستحالة، فإن هذا لا يغير من وجوب تنفيذ الالتزام كاملاً.
فالتاجر، بحسب السنهوري، يواجه في تجارته كسبًا وخسارة، وهما من الأمور المتوقعة في حدود المألوف، والالتزام يظل قائمًا ويلزم المدين بتنفيذه.
ولكن، إذا كان تنفيذ الالتزام قد أصبح مرهقًا جدًا للمدين إلى درجة تتجاوز حدود المألوف في التجارة، ولكن التنفيذ لم يصل إلى حد الاستحالة، وكانت هذه الحالة تمثل عبئًا شديدًا يتعارض مع مبادئ العدالة والإنصاف، فإن النظرية الخاصة بالظروف الطارئة تقر بأنه لا ينقضي الالتزام، لكنه يجوز تعديله أو تخفيفه بحيث يُمكن المدين من تنفيذه مع وجود مشقة معقولة، وليس إرهاقًا بالغًا.
*زوال الظرف واستئناف العقد (مرحلة ما بعد الأزمة):
ما الذي يقصد ب (زوال الظرف)؟
يقصد بزوال الظرف عودة الحالة إلى وضع طبيعي، أو على الأقل إلى حالة مشابهة للوضع الطبيعي، وذلك بانتهاء الحدث الاستثنائي الذي عرقل التنفيذ، مثل انتهاء الحرب أو رفع القيود التي كانت تحول دون تمكين المستأجرين من الانتفاع بالعين المؤجرة لهم.
وفي هذه المرحلة، يمكن للمستأجرين العودة إلى الانتفاع بالعين المؤجرة في وضع مماثل لما كانوا عليه قبل وقوع الأزمة، ويستأنف العقد عمله في صورته الأصلية، مع استكمال تنفيذ الالتزامات المترتبة عليه بما يحقق استقرار الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة.
يُعدّ السؤال حول كيفية عودة الالتزامات تلقائيًا بعد زوال الظرف الطارئ سؤالًا في غاية الأهمية، لما له من أثر مباشر في حل الكثير من المشكلات القانونية المستقبلية المتعلقة بتنفيذ العقود.
كيف نصل إلى هذا السؤال؟ أو كيف نعرف ما إذا كانت الالتزامات تستأنف تلقائيًا؟
الإجابة تكمن في تحديد حالة العقد:
فإذا كان العقد ما يزال قائمًا ولم يتم فسخه أو إنهاؤه، فإن الالتزامات تستأنف تلقائيًا بعد زوال الظرف الطارئ، ويعود كل طرف لتنفيذ ما عليه من التزام وفقًا للشروط الأصلية.
أما إذا أدى الظرف الطارئ إلى فسخ العقد أو إنهائه — سواء بمقتضى نص صريح أو بمقتضى الواقع القانوني للحالة — فلا تعود الالتزامات تلقائيًا، وإنما يتطلب الأمر إبرام عقد جديد أو اتفاق جديد لاستئناف التنفيذ.
يبقى هنا سؤال مهم هو: كيف يمكن للظرف الطارئ أن يؤدي إلى فسخ العقد؟
وهذا السؤال يفتح المجال للنقاش حول حدود الظرف الطارئ وتأثيره في بقاء العقد أو فسخه، لا سيما في الحالات التي يتحول فيها الظرف من مجرد تعسر مؤقت إلى استحالة مستمرة أو تغيير جذري في الظروف يجعل استمرار العقد غير معقول أو غير ممكن قانونًا أو واقعيًا.

الظروف الطارئة وفسخ العقد: رؤية عبد الرزاق السنهوري والفقه الإسلامي
لقد طرحت سؤالاً مهماً حول كيفية تأثير الظروف الطارئة في فسخ العقد، وهو سؤال بحثت فيه كثيراً في المراجع القانونية والفقهية، فلم أجد له تعبيرًا واضحًا سوى في كتابات الدكتور عبد الرزاق السنهوري، الذي تناول معظم موضوعات القانون المدني، وخصّ بالبحث الظروف الطارئة وتأثيرها على العقود.
في كتابه الوسيط في شرح القانون المدني، يذكر السنهوري أن عقد الإيجار قد ينفسخ بالعذر في مذهب الحنفية، وهو رأي يفسر كيفية فسخ العقد بسبب الظروف الطارئة.
ففقهاء الحنفية يقرون أن العقد قد يُنفسخ بالعذر إذا استحال تنفيذ الالتزام دون ضرر على صاحب العذر، أو إذا كان تنفيذ العقد يوقع ضررًا لا يمكن احتماله، وهو ما يستند إلى القاعدة الفقهية الشهيرة «لا ضرر ولا ضرار».
ويشرح السنهوري أن مفهوم العذر عند الفقهاء قد يكون مرتبطًا بالعين المؤجرة أو بالمؤجر أو بالمستأجر، وقد وضع الفقه الإسلامي معيارًا مرنًا لتقييم العذر. فقد ذكر ابن عابدين وغيره من الفقهاء أن أي عذر يمنع استيفاء العقد بسبب ضرر يلحق بالنفس أو المال، يمنح لصاحبه حق فسخ العقد.
هذه النظرية تتقاطع مع ما يعتبره القانون المدني الحديث من مفهوم القوة القاهرة والظروف الطارئة، لكنها تتسم بمرونة تمكن من التمييز بين الحالات التي تستدعي الاستمرار في التنفيذ رغم المشقة، وتلك التي تستوجب إنهاء العقد بسبب الضرر الذي لا يُطاق.
ويجدر التذكير بأن المادة 318 من قانون المعاملات المدنية قد أشارت إلى حق المستأجر في فسخ العقد. فالنص القانوني يمكن فهمه بأكثر من وجه، ومن الممكن تفسيره بما يتوافق مع مبدأ القاعدة الفقهية الشهيرة «لا ضرر ولا ضرار»، التي تبيح للمستأجر فسخ العقد إذا استلزم تنفيذ الالتزام إلحاق ضرر بالنفس أو المال له أو لمن يتبعونه في الانتفاع بالعين المؤجرة.
كما أن المادة تلمح إلى إمكانية فسخ العقد في حال وقوع ظروف تحول دون تنفيذ العقد، مما ينسجم مع النظرية التي تعترف بأن الظروف الطارئة قد تستدعي فسخ العلاقة التعاقدية، حفاظًا على حقوق الأطراف وتحقيقًا لمبدأ العدالة.
إذا أدى الظرف الطارئ إلى فسخ العقد أو إنهائه، فلا تعود الالتزامات إلا بعقد جديد أو اتفاق جديد.
شارك المقال