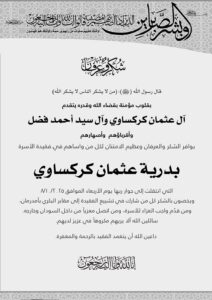محمد عبدالقادر محمد أحمد
كاتب صحفي
• كقانوني اعتاد أن يقرأ النصوص لا بعين القارئ العابر، بل بعين الباحث عن المعنى والدلالة، وجدت نفسي مدفوعًا بدافع الفضول لأن أفتح كتابًا قد كَثُر الحديث عنه، كتاب ظننت أني سأجد فيه مادة فكرية أو سردًا تاريخيًا لا أكثر. لكن ما إن بدأت أتصفح صفحاته، حتى بدا لى كأني أمام نصوص صيغت لتكون ديباجة لدستور يليق بدولة تسعى إلى النهضة. لم أقرأه كقارئ عادي يبحث عن المتعة الأدبية، بل كدارس للقانون يرى في كل جملة مادة من مواد القوانين العليا.
من بين ما شدّ انتباهي عبارات محكمة الصياغة، تنضح بروح الدستور والمواثيق الدولية. يقرر المؤلف: «سيادة القانون هي ضمير الدولة الناجحة، وأصغر الدول يمكن أن تكون أقواها بسيادة القانون». ويؤكد أن «الحرية هي الرئة النقية التي يتنفس بها المجتمع»، وأنه «كلما تضامن الناس لبناء الدولة كلما أسرعت خطى نهضتها». ثم يضيف: «المشروع الوطني الناجح هو جسر كبير، مداخله التي تحتاج إلى تعبيد فوري هي الثروة والسلطة والهوية والاختلال التنموي». وفي موضع آخر، يضع إصبعه على جرحنا التاريخي حين يكتب: «من أهم أمراض الدولة الفاشلة: الإرث السلطوي… وتسلط الأجهزة الأمنية والفساد البائن… وانكسار القضاء».
بل إنه يذهب أبعد من ذلك، فيخصص درسًا بعنوان «الدين والسياسة»، مؤكدًا أن الخلط بين المجالين جريمة في حق الوطن. ثم يقرر، وهو يستعرض جذور مشكلة الجنوب، أن إدخال الدين في معادلة الحرب الأهلية، جعلها «حربًا دينية مقدسة»، وعمّق الانقسام، وقطع الطريق أمام أي تسوية عادلة. كيف لا يُدهشك نص بهذا الوضوح؟ كيف لا يخطفك وأنت ترى كاتبًا يرفض استغلال العقيدة في السياسة، ويُحذّر من عسكرتها، ويضع الإنسان السوداني-كما يقول – في صدارة المشروع الوطني باعتباره الاستثمار الحقيقي لا العبء؟
لقد وجدت في هذا الكتاب رؤية متكاملة: دولة مدنية تقوم على حكم القانون، دستور يُعبّر عن التنوع، عدالة اجتماعية كمعيار للحكم الرشيد، ومجتمع مدني قوي هو «الحصن الأخير الذي لا يمكن اختراقه».
في تقديري إن مثل هذه النصوص لو قُرئت في قاعات المحاكم الدستورية، أو في محافل الأمم المتحدة، لما بدت غريبة، فهي تستلهم نصوص العهود الدولية، وتعيد صياغتها في قالب سوداني أصيل. ومن يقرأها يظن أنّ الكاتب يُعدّ مشروعًا تاريخيًا لانتقال السودان من خانة الدول الأقل نموًا إلى مصاف الدول المتقدمة.
لهذا السبب، دعوت نفسي أولًا، ثم أدعو القارئ الآن: اقرأوا هذا الكتاب، لا على سبيل التسلية الفكرية، بل بوصفه مرآةً لرؤية تُعرض علينا كطريق إلى المستقبل. ستجدون فيه خطابًا يفيض بالحكمة، لغةً تحاكي النصوص الدستورية، وحلمًا صادقًا – في ظاهره – بدولة قانون وحرية ومساواة.
غير أنّ ما يثير الحيرة والذهول هو اكتشاف اسم المؤلف. هذه ليست كتابات مجهول، بل هي كلمات الدكتور كامل إدريس نفسه، وقدّمها في أول مؤتمر صحفي باعتبارها «رؤيته» لبناء السودان. وهنا تقف المفارقة، فالرجل الذي أنشد في كتابه أن الدين لا ينبغي أن يُستعمل سلاحًا في الصراع السياسي، كان أول من انحاز لتحالفات مع العسكر، وظل يبارك عسكرة الدولة. الكاتب الذي أعلن أن العدالة الاجتماعية هي معيار الحكم الراشد، رأيناه لاحقًا يهادن أنظمة لم تُبقِ للعدالة الاجتماعية من أثر. من رفع لواء «الرئة النقية» للحرية، جلس في صفوف من يضيّقون على الحريات ويؤججون الحرب. ومن حذّر من «الحرب المقدسة»، عاد فوقف في معسكر يؤججها، ويبرر نزيف الدم الذي حذّر هو نفسه من عواقبه.
ألم تقل بنفسك إن سيادة القانون هي ضمير الدولة؟ فكيف رضيت أن تكون شاهدًا على خنق ذلك الضمير؟ ألم تؤكد أن العدالة الاجتماعية هي معيار الحكم الراشد؟ فلماذا باركت نظمًا لم تجلب سوى الظلم والتفاوت؟ ألم تُفرد درسًا كاملًا بعنوان «الدين والسياسة»، محذرًا من خطورة خلط الدين بالسلطة، فكيف قبلت أن تضع يدك مع من رفعوا راية الدين لإشعال الحرب؟ ألم تكتب أن الهوية الوطنية الجامعة هي صمام الأمان، ثم شاركت في مسارات سياسية كرّست الانقسام، وألقت بالوطن في أتون حرب طاحنة؟
هذه أسئلة لا تُوجّه لكاتب عادي، بل لرجل حمل لقب «الأستاذ الدكتور»، ورفع صوته يومًا ببيان دستوري أراد به الخير لوطنه. لكن المؤلم أنّه اختار أن ينزل بنفسه إلى «زقاق ضيق»، وأن يصطف مع العسكر، وأن يضع على لافتة الحرب توقيعه، بينما كتابه يفيض بالسلام والتنمية. وهنا يأتي الاستنكار قبل كل شيء، فكيف يتحوّل مشروع «المستقبل»، الذي بشّرت به إلى حاضرٍ يبارك خرابًا ويُطيل عمر المعاناة؟
وأنا أقرأ نصوص د. كامل إدريس، وأقارنها بمواقفه، لا أملك إلا أن أُبجّله لعلمه، وأتأسف بصدق على الوضع الحرج الذي قبل أن يقحم نفسه فيه. أستغرب، وأستنكر، كيف تحوّل الكاتب إلى نقيض نصه، وكيف ارتضى المفكر أن يكون شاهدًا على حربٍ كان يجب أن يكون أول من يقاومها؟
والسلام،،
شارك المقال