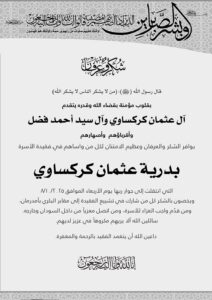محمد عبدالقادر محمد أحمد
كاتب صحفي
• منذ أن تحوّلت مواقع التواصل الاجتماعي إلى ما يشبه «الحياة البديلة للسودانيين»، لم يعد مستغرباً أن يتحوّل الفيسبوك أو غيره من المواقع إلى ساحة محاكم جماهيرية، يعتلي فيها كل شخص مقعد القاضي والنيابة والدفاع في ذات اللحظة، وبعضهم لا يبخل حتى بأن يلعب دور الشرطي وجامع المعلومات والخبير القانوني. وفي الحادثة الأخيرة التي أطاحت بثقة الجمهور في إحدى وكالات السفر (دون حاجة لذكر الاسم) يُقال إنها احتالت على العشرات إن لم يكن المئات من المواطنين، في مبالغ مالية ليست بالهينة، لم تلفت انتباهي لأنها «جديدة» في باب النصب والاحتيال، فهذا الباب مفتوح على مصراعيه منذ أن استسهل الناس الحيلة وتركوا الحذر، ولكن لأنها كشفت أبشع ظاهرة مستترة كانت تتسلل طوال السنوات الخمس الأخيرة تحت مسمى «المسوق» و»صانع المحتوى» و»المؤثر».
الثابت أن اليوم، لم تعد الشركات تعتمد على قدرات المنتج أو جودة الخدمة وحدها، بل على «قوة التأثير النفسي» للإعلان، فأصبح الإعلان ليس مجرد لافتة بل «شهادة» يقدمها شخص يتبعه جمهور من المتابعين، فيصدقونه كما يصدقون إمام الجامع أو الطبيب أو المحامي. هنا، يدخل «المسوق» ليقول للناس إن هذه الوكالة موثوقة وإنه «شخصياً جربها» أو «ظل يسافر معها طوال حياته»، ويُظهر لهم تذاكر وصورًا ويقدم حديثًا مصقولًا بالانبهار، وهو يعلم في قرارة نفسه أنه لم يثق في هذه الوكالة إلى الدرجة التي تجعله يحجز عبرها لنفسه أو لأحد من أسرته، لكنه يثق فقط في الثمن الذي سيُدفع له مقابل الإعلان، فيكذب في الرواية»، ويُجمل في التزكية، ويغري الضعفاء ليدفعوا تحويشة العمر بناء على إعلانه أو شهادته، ثم إذا ما ظهرت الكارثة، صاح بأعلى صوته: ما ذنبي.. أنا كنت بس مسوّق!
في تقديري ومن ناحية قانونية، التسويق ليس عملاً بريئاً والمسوق لا يفترض أن يعامل على أنه مجرد رسول يحمل معلومة، بل شريك أصيل في خلق الرغبة التي تدفع الناس لإبرام العقد، لأنه يحدث أثراً مباشراً على إرادة المتلقي، بحيث يدفعه لإبرام عقد ينتج عنه التزام مالي.. ومن حيث المبدأ، يجب أن يقع على المسوّق التزام قانوني يسمى (واجب التحقق) أو Duty of Due Diligence، وهو واجب الحذر الملقى على عاتق من يستخدم تأثيره على الجمهور لأغراض مالية أو دعائية، إذ لا يجوز له أن يعرض على الجمهور معلومة مضللة أو غير موثقة، أو أن يصف خدمة بأنها آمنة وهو لم يتحقق من ذلك عبر تجربة حقيقية، أو أن يخفي عن الناس أنه يتقاضى مقابلًا ماليًا نظير هذا الترويج.
بموجب قواعد المسؤولية التقصيرية في القانون المدني، يعتبر من ارتكب فعلاً أو امتناعاً غير مشروع، ألحق ضرراً بالغير، مسؤولاً عن تعويض ما سببه من ضرر، ولو لم يقصد الإضرار. وفي هذا السياق يكون المسوّق الذي جعل الناس «يثقون» ويسلّمون أموالهم بناء على إعلانه أو شهادته، مسؤولاً معهم مسؤولية مشتركة، لأنه ساهم في إحداث الضرر. والقانون لا يقبل مقولته الشهيرة: «ما كنت بعرف»، إذ إن الجهل لا ينفي المسؤولية، ويساوي في الخطورة بين من يعرف الحقيقة ويخفيها، ومن لا يعرف ويتعمد ألا يسأل.
أما من الوجهة الأخلاقية، فإن «التسويق» بدون ضوابط يُعتبر أخطر من الغش التجاري نفسه، لأن الوكالة المحتالة قد تُنهي القصة وتختفي، لكن المسوق يبقى موجوداً، ينتقل من شركة إلى أخرى، يلمّع هذه، ثم يشيد بتلك، ويكرر العبارة ذاتها (المنتج الخرافي.. أحسن خدمة في السودان.. أنا شخصياً ما بختار غيرهم)، مقابل أن تدفع له الجهة المعلَن لها مبلغاً يصمت معه ضميره، ويفتح فمه ليلقي على الناس شهادة، لا تقل عن شهادة الزور!
إن الساحة اليوم باتت في أمسّ الحاجة إلى تقنين واضح لمهنة التسويق المؤثر، بإلزام صريح للمسوِّقين بالآتي:
إعلان صريح وشفاف بأن المحتوى الذي يقدمونه هو إعلان مدفوع.
الإفصاح عن تجربته الحقيقية أو مصدر المعلومة التي يستند إليها، وإلا وجب أن يقول بوضوح «لم أجربه»، ولا يعطي أي انطباع مضلل عن تجربته الشخصية.
تحمل المسؤولية القانونية عن أي ضرر مادي يقع على المتلقين بسبب إعلانه، إذا لم يثبت أنه بذل العناية اللازمة للتحقق.
فليس من المقبول أن يقف مسوّق ليقول إن المنتج «خرافي» وهو لم يره إلا في الاستديو، أو أن يشيد بوكالة سفر وهو لم يجربها قط، ثم يدفع الناس أموالهم فيُؤذون، فيما يظل هو يرقص على «الستوري» التالي ليعرض معلناً جديداً. إن كان القانون يتبع الضرر لحماية المستهلك، فلا بد أن يلحق بالمسوّق أيضاً، لأنه الحلقة التي أثرت في إرادة الجمهور، وجعلتهم يضعون ثقتهم حيث وضع هو جيبه.
إن هذه القضية ليست قضية وكالة سفر، ولا قضية مجموعة من الضحايا فقط، إنها قضية نزاهة المجال العام، وحق الناس في ألا يُنتهك وعيهم عبر كلمات مدفوعة الثمن. فالتسويق إن لم يسنده الضمير، تحول من مهنة إلى وسيلة غش، ومن حق مشروع إلى مشاركة في الجريمة.
وعندئذٍ لا يكفي أن نقول للمسوّق (أنت ضحية)، لأن أي مسوّق يقبض ثمن الإعلان وهو يعلم (أو يتعمّد ألا يعلم) يصبح جزءاً من منظومة الإضرار، شاء أم أبى.
شارك المقال