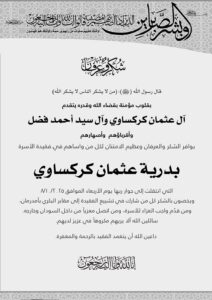حسن عبدالرضي الشيخ
كاتب صحفي
• حين نتأمل العامية السودانية، نجد أنفسنا أمام كنزٍ لغويّ حيّ، ليس مجرد لهجة عابرة أو خليط من مفردات متناثرة، بل جسرٌ متين يصل حاضرنا بماضينا، ويقرّبنا من لغة القرآن أكثر مما يظنّ الكثيرون. هذه العامية، التي تدور على ألسنة الناس في الأسواق والبيوت، ويحملها الفلاحون والرعاة والحرفيون في حياتهم اليومية، ليست بعيدة عن الفصحى، بل هي امتداد طبيعي لها، أزالت بعض الزوائد واحتفظت بجوهرها وروحها العميقة.
لقد أسهمت الإذاعة السودانية في انتشار العامية السودانية، وكان لها الباع الكبير في مزج قدر وافر من اللغات المحلية وصهرها في بوتقة سمّيناها «الدارجة السودانية». وكثير من الأدباء والشعراء والفنانين استخدموا هذه العامية وأبدعوا بها إبداعًا مذهلًا. والمفكرون السودانيون ليسوا ببعيدين عن هذا الاستخدام المبدع، فكانت الندوات والمحاضرات التي تشرح أي فكرة للناس بهذه العامية؛ لأنها الأقرب إلى قلوبهم وعقولهم. فالفكرة، إذا أرادت أن تبلغ الناس، لا تكفيها الفصاحة وحدها، بل تحتاج إلى لغة حيّة يتنفسها السامعون، وهذا ما جعل خطاب المفكرين يصل إلى الرجل البسيط في القرية وإلى المثقف في المدينة بلا حواجز لغوية ولا تعالٍ لفظي.
والشاهد على أصالة العامية السودانية، أنها كانت أداة لكبار المبدعين والمفكرين. فالطيب صالح، الروائي السوداني العظيم، صاغ بها حوارات شخصيات روايته الخالدة (موسم الهجرة إلى الشمال)، التي صُنّفت ضمن أفضل مئة رواية في تاريخ الأدب الإنساني. لقد كان يدرك أن العامية السودانية تحمل موسيقى داخلية وإيقاعًا عربيًا صافيًا، قادرًا على مضاهاة لغة الشعر في نقل العاطفة ورسم المشهد وتجسيد الحس الإنساني.
وكذلك فعل البروفيسور عبد الله الطيب، أحد أعمدة اللغة العربية في القرن العشرين، وأحد أعظم من خدموها وشرحوها. هذا الرجل، الذي درّس الفصحى في أرقى الجامعات، لم يجد غضاضة في تفسير القرآن الكريم للشعب السوداني عبر الإذاعة بالعامية السودانية الدارجة؛ لأنه كان يعلم أن جمال القرآن لا يُحتجز خلف أسوار النحو والصرف، بل يُفتح بابه للناس بلغتهم التي يألفونها ويحبونها.
والعامية السودانية كانت ولا تزال وعاءً للشعر والغناء والمسرح. فقد عبّر بها شعراء المديح عن محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، ووصفوا خير البرية بألفاظ فائقة الجزالة. فحاج الماحي وود سعد – على سبيل المثال – حلّقا بالعامية السودانية بعيدًا في سموات الوصف الرصين والإبداع النادر. كما كتب الحاردلو، شاعر البطانة الكبير، مستخدمًا مفردات الدارجة السودانية، أروع أبيات الدوبيت والمسادير. وأبدع ود الرضي وسيد عبد العزيز أجمل القصائد بها، وتغنّى محمد وردي ومحمد الأمين بروائع هاشم صديق وأبو آمنة حامد. وعلى خشبات المسرح، أبدع الشاعر الكبير إبراهيم العبادي في مسرحيته الشعرية ريا ودكين بالعامية، فصارت مثالًا على قدرتها التعبيرية العالية.
وبخلاف كثير من اللهجات العربية، احتفظت العامية السودانية بمفردات فصيحة هجرتها ألسنة العرب في أماكن أخرى، فهي تقول «الزول» بمعنى الرجل، و»العتب» بمعنى اللوم، و»القُرْبة» للماء، و»الحشيش» للنبات، و»الضراع» لليد، وكلها ألفاظ أصيلة مذكورة في المعاجم القديمة. وحتى تراكيبها النحوية ما زالت أقرب إلى الفصحى، مما يجعل الانتقال من العامية إلى الفصحى ميسورًا على لسان السوداني أكثر من غيره.
إن الدفاع عن العامية السودانية ليس دعوة لترك الفصحى، بل هو تأكيد على أن الفصحى تسري في عروقنا من خلال لهجتنا، وأننا لا نحتاج إلى قطع الصلة بين الماضي والحاضر حتى نحافظ عليها. فالعامية السودانية ليست خصمًا للفصحى، بل هي ابنتها البارّة التي ورثت منها الصوت والنغمة والروح.
فلنعتز بهذه العامية، فهي وعاء فكرنا الشعبي، وأداة إبداعنا الفني، وجسرنا الأقرب إلى لغة القرآن، وجزء أصيل من هويتنا السودانية التي تميّزنا عن غيرنا، وتربطنا بأمتنا العربية في آنٍ واحد.
شارك المقال