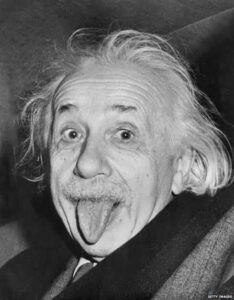الشاعر السوداني مصطفى محمد سند.. ودَّع (الغابة والصحراء) ولاذ بـ (البحر القديم)!!
Admin 2 أغسطس، 2025 773

أ. د. عبدالمطلب محمود
عميد أكاديمية الدراسات العلمية والإنسانية العليا في بغداد
• هو واحد من خمسة شعراء عرفهم ميدان الشعر في السودان في ستينيات القرن الفائت، وعرفهم باسم (مدرسة الغابة والصحراء)، ضمَّت فضلاً عنه أسماء شعراء مجدّدين مهمّين، هم كل من : النور عثمان أبكر، ومحمد عبد الحي [أستاذ الأدب لاحقاً]، ومحمد المكّي إبراهيم، ويوسف عيدابي، وعبد الله شابو، وعلي المك، وصلاح أحمد إبراهيم، وإسحق إبراهيم إسحق، سعت عبر التسمية إلى وصْل غابات أفريقيا بجغرافيا الصحارى العربية، توسيعاً لفضاء الشعر السوداني الذي ظلّ حبيس فضائه الضيِّق لعقود زمانية طوال.
يوم شارك الشاعر مصطفى سند [مصطفى محمد سند] في مهرجان المربد الشعري التاسع، الذي انعقد في العام 1988 في بغداد والبصرة، ضمن وفد شعراء السودان وأُدبائه، عرفته إنساناً بسيطاً متواضعاً هادئ الملامح دافئ الصوت، حتى إذ قرأ قصيدته (غنائية السائر على شفق الأسمار)، أدركتُ شخصيّاً ما كان يعتمل في أعماقه من تمرّد وجرأة حتى على الشعر نفسه، وقد افتتح قصيدته يومها بـ :
«عينُ اللهِ على البابِ الشرقيِّ ومَن صلَّوا خلفَهْ/ عينُ اللهِ على أُفقِ (العَيناتِ) النائمِ في خاصرةِ الريحِ العاشقةِ المعشوقة/ يا بصَرَ الرائينَ بكوراً هيّئ للجُثثِ الباردةِ المشنوقة/ ثلّاجةَ عينيكَ/ وهيّئ لقصائدِ مَن يبكي الشِّعرَ/ مقابرَ من حبرٍ وزُجاجْ/ مَن قال بأنّ حدائقَ أحرُفِنا غرقت في اليمِّ وذابت في حضُنِ الأمواجْ/ …/ إنْ كان حصادُكَ أبعدَ ما يرجونَ فها أنتَ الساعة/ تُخزي كلَّ رهينِ الظنِّ الآثمِ/ تطلع شِعراً.. قمحاً.. ناراً.. وخيولا/ ومعارجَ من رغوِ التشكيلِ البِكرِ.. ضباباً وهيولى…».
ثم شارك في مربدٍ تالٍ بقصيدة عمديّة مستحدثة، لم يتخلَّ فيها عن ذكر البحر الذي عشقه، الذي ارتبط معه بأوثق الوشائج وقد عُرف به عبر ديوانه البِكر (البحر القديم)، الذي ظل لصيقاً باسمه منذ صدر له في العام 1971، حتى رحيله إلى ملكوت الخالق في العام 2008، وفي قصيدته (المربديّة) تلك، غنّى بغداد عاشقاً:
«بغدادُ تفتحُ باباَ دونه سفرٌ/ في العَودِ منه إلى بغدادَ بالسفرِ/ بحرٌ.. ولكنه تحلو سباحتُهُ/ في زورقٍ من رؤى التاريخِ مُنحدِرِ/ …/ إنْ مسَّ شَعرةَ رملٍ فيه ملتبسٌ/ أو شاغلته طيوفُ الليلِ في السَّحَرِ/ أو راوَغتْ سعَفاً ألقى ضفائرَهُ/ على الفراتِ، عيون العاشقِ الحَذِرِ…».
وعلى الرغم من علمي بعد ذلك من أن للشاعر مصطفى أربعة دواوين أخرى تلت ديوانه البِكر (البحر القديم)، هي على التوالي : ملامح من الوجه القديم/ 1978، وهو القسم الثاني من ديوانه الأول، وعودة البطريق البحري/ 1988، ونقوش على ذاكرة الخوف/ 1990، وبيتنا في البحر/ 1993، ظلت تراودني رغبة دائمة للحصول على ديوانه البِكر، حتى عثرت قبل أسابيع مضت على نسخة منه عند بائع كتب على عربة في شارع المتنبي، ورحت أقرأها للتعرّف أكثر على «سـرّ» هذا (البحر القديم)، الذي رافق الشاعر طوال مسيرته الحياتية والشعرية، وقد قدّم له زميله في (مدرسة الغابة والصحراء) الشاعر صلاح أحمد إبراهيم، وصدر من قسم التأليف والنشر بجامعة الخرطوم، وحرّضتني المقدمة مزيداً من التحريض على سبر غور نصوص الديوان، إذ رأى الشاعر صلاح إبراهيم : «أن اللغة الشعرية لدى مصطفى قد بلغت شأواً عظيماً، كما أن موسيقى شعره عارمة جارفة […]، وخير قراءة للشعر ما كانت عن دراية واستبصار، وإعمال الفكر والذوق والخيال، وخير الشعر ما أثرى العقل والوجدان، وجعلنا بفراءته أكثر إنسانية وحكمة ورهافة شعور وإحساساً بالجمال»(ص3).
وبالوقوف على القصيدة الأولى في الديوان (مقاطع استوائية)، ستظهر محنة لم يعهدها شعرنا العربي حتى ذلك الحين، يمكن أن تتمظهر على أنها محنة الشاعر مع الآخر/ الآخرين، في مواجهة الزيف والكذب وما يُشاع عنه عبرهما :
«في البدء قال الواهمون/ يا لَلسعادة بيتُ صاحبِنا القرَنفُلُ،/ قاعُ منزلِه البهارُ وسقفُه الغيمُ الحنونْ/ يا حظَّه التهمَ الصدور،/ مركضَ الزلَقِ المُريحِ وعبَّ أنهارَ العيونْ/ نصبتْه حاناتُ النبيذِ وأعينُ السُّمارِ/ بهجةَ يومها الباكي على وتَر الشجون/ وأعُدُّ.. كم أكذوبةٍ عنّي يقولُ الواهمونْ»(ص5). ففضلاً عن جدَّة مفتتح هذا النصّ الشعري ـ زمنيّاً ـ الذي بدا تعبيراً عن حالة خاصة، سنكون أمام حالة استهجان لأحوال اجتماعية عامة، واقعة وحقيقية ومستمرة الحدوث في كل زمان، وسائدة في أيٍّ من مجتمعاتنا العربية، كأنها قدَر مفروض لا نملك منه فكاكا، بل هي بمثابة الطبول ضاجّة الضربات الصاخبة في الرؤوس والنفوس، وهذا ما سيبين عنه الشاعر في مقطع آخر من قصيدته هذه :
«الطبلُ.. حُمّى الطبلِ في رأسي/ شراييني تفُحُّ بلا انقطاعِ/ جسمي عليه عقاربُ العرَقِ السخينِ/ كأنّ آلافَ الأفاعي/ في الصدرِ تنهشُني.. دواركِ يا سهولُ/ ويا جروفُ ويا مراعي/ أنا من وثاقِ العُرفِ محلول الشراعِ/ أبكي وأضحكُ لا يَبينُ تبذُّلي العاري ولا يبدو ضَياعي/ …/ غنّيتُ للسودِ الغِلاظِ وللعبيدِ وللرُّعاعِ/ …/ للشمسِ تغسلُ بيتنا العالي علوَّ الشمسِ/ من مطر البنادق…»(ص7)، حتى لكأن الشاعر يقرأ ما يجري في بلده في أُخريات الربع الأول من القرن الحالي، ويفضح الزيف والكذب نفسه اللذين حال السودان كلِّه ـ لا حاله الشخصيّ وحده ـ في عواصف الحروب وفجائعها، وهي بحق رؤية «نبوئية» تُسجّل له الآن، ولا أظنها سُجِّلت له قبل الآن.
وبالوقوف على قصيدة (البحر القديم)، سيأخذنا الشاعر مصطفى سند إلى حالة وجع لا تخلو من مرارة ألم مشفوعة بتهكُّم جريء، وقد فضح في قصيدته هذه أكاذيب لم يكن مقصوداً أو مستهدَفاً بها وحده، بل بلده الجريح :
«بيني وبينك سكّة السفر الطويل إلى الربيع/ إلى الخريف/ تعلو قصور الوهم أنتِ ومرقدي في الليل أتربة الرصيف/ هم ألبسوكِ دثارَ خـزٍّ ناعمَ الأسلاكِ/ منغومَ الحفيفْ/ ودعَوكِ تاجُ العِزِّ.. فخرُ العِزِّ.. مجدُ العِزِّ.. شمسُ العِزّ.. عِزّ العِزِّ/ صبّوا في دماكِ عُصارة الكذِبِ المُخيفْ/ وأنا الذي حرق الحشاشة في هواكِ/ ممزَّق الأضلاعِ، مطلولَ النزيفْ/ …/ هذا أنا../ بحرٌ بغير سواحلٍ.. بحرٌ هلاميٌّ عنيف…»(صص11 و12)، ففي الأكاذيب نفسها سوف تظل بلاده تعيش وهم العز بما اقترن به من صفات، وسوف يظل الشاعر الصادق الوحيد، لأنه الرائي لما في الأفق والبحر المديد «بغير سواحل»، أو البحر العنيف الذي لا تُمسك موجه العاتي أكفّ الكذّابين، لأنه «هلاميّ» مجازاً وحقيقة، مثلما أراد له أن يكون.
وفي قصيدة (أحزان قديمة) يحاول الشاعر فضح زيف خلفيات الصراع القديم بين السودان الشمالي والجنوبي، عبر نقله صور المتاعب والمذابح التي عاشتها مدينة (توريت) الجنوبية، على الرغم من تعايش المسيحيين والمسلمين الطبيعي، ليُبدي في ختامها تفاؤله المنطلق من روحه الإنسانية الصادقة المحبّة للحياة الآمنة المدعوّة للسلام، والساعية إليه بقوة :
«(توريتُ) تدفن في المساء ضغائن الأحقادِ/ تولَد من جديد/ تقف المساجدُ والكنائسُ في برودِ التبرِ/ تضحك للصباح البِكر والفجر الوليد»
(ص19)، وإن ارتد تفاؤله بعد سنين من الوئام والاستقرار بالفعل، لتأتي رياح الأكاذيب والتدخلات الخارجية بالتقسيم الجغرافي القسري للجزء الجنوبي من السودان، الذي أدى إلى فصله عن الجزء الشمالي إلى رحيل الشاعر إلى المملكة العربية السعودية، حيث توفّاه الله في مدينة (أبها) في 23 أيار/ مايو من عام 2008.
أما في القصيدة الثامنة من ديوان (البحر القديم)، التي حملت عنوان (جراح سوقيّة)، وكذلك في القصيدة التاسعة (الكمنجات الضائعة)، فبدا الشاعر نادما وحزيناً على عمره الذي أضاعه بلا جدوى، إذ قال في الأولى :
«نادماً غنّيتُ يا بحر الهجير/ ما سَقت ريحُ الصحارى/ صيحة الدرويش في الليل الكسير…»(ص29)، وقال في الثانية :
«أنا المحرومُ من دنياك لمّا غامت الرؤيا/ ولفّتني المتاهاتُ/ سقيتُ الناسَ من قلبي.. حصادَ العمر/ ذَوبَ عروقيَ الولهى.. بأكوابٍ من النورِ/ أُقبِّلُ كل مَن ألقى على الطرقاتِ،/ من فرَحي وألثمُ أعيُنَ الدورِ…»(ص32)، ليرتفع أساه وحزنه في ثلاثية (عودة إيتاكا)، حتى لبدا في جزئها الثالث صارخاً من عصف آلامه :
«يا وجه الشمسِ الفاضحَ كلَّ حقيرٍ كلَّ جبانْ/ أمي تعجن خمرَ [أظن : خبز] الصندلِ ثم تهزُّ المهدَ بغيرِ حنانْ/ ـ نَم يا شاهدَ موتَ أبيكَ لتحيا فيه/ لترفد نهر الخيبة والخُسرانْ./ أُمي شقٌّ أسودُ مثل الليلِ بقاعٍ أخضرَ كالياقوتْ/ يحتل جبيني منذ صبايَ الباكرِ يحفر بئر الخوفِ/ ويبحث للتابوتْ/ قبراً يبقى تحت اللحمِ ويُنشر حين أموتْ…»(ص38).
أما في القصيدة الأخيرة من الديوان، الثامنة عشرة (خزين الصيف)، فيعود الشاعر مصطفى محمد سند إلى أصوله وجذوره العربية، التي يستعيدها هادئاً ساكناً متخففاً من عنفه، وقد جعل من صوتٍ يأتيه من خارجه ـ وربما من داخله ـ يدعوه إلى هذا، إذ يبدأها بـ :
«يقول لي إن مات في عينيكَ ظِلُّهم/ وسافر النهارْ/ لا تلعنِ الزمانَ والسنينَ والأقدارْ…»، ثم يروح يُخاطب الشمس بسلاسة :
«يا شمس،/ للإيجارِ بيتُ شاعر ٍ تقوَّضت جدرانُه العتاقِ/ خلف شارعٍ قديم/ مهيّأ للناس.. للجياعِ.. للذين مثلكم بلا بيوت/ إن عَزَّ في الزمان حاتِمُ الندى،/ حلفتُ للغريبِ لا يفوتْ/ ببابِه الحزين دون هجعةٍ ودون شربةٍ ودون قوتْ…»(صص60 و61)، فكأنه تصالح مع نفسه فحاول أن يُظهرها على حقيقتها؛ طافحة بالقيم الإنساني وبحب الناس وطلب الخير لهم، ومقت الزيف ودعاته والكذب وحامليه ومحمولاته.
ولابد قبل أن أختم هذه القراءة برأي ظريف التقطته للشاعر من موقعه على (الفيسبوك)، قال فيه : «كنت مُصرّاً على الشعر الفصيح لصعوبة اللغة المحكيّة (العاميّة) لكنني وجدت نفسي مخطئاً».. فكتب بالعاميّة السودانيّة واحدة من أجمل القصائد المغنّاة :
«عشان خاطرنا خلّي عيونِك الحلوات تخاصمنا/ ولما تمرّي ابقى اقيفي واسألي عن مشاعرنا/ زمان غنينا لعنيكي أغاني تحنن القاسين/ هديناك معزّتنا.. مشينا وراكي سنين وسنين/ بنينالك قصور بالشوق فرشنا دروبا بالياسمين/ …/ حلاتك إنتي ماشيه براكي.. شايله الدنيا بازهارا وبالفيها/ زمان بارينا ضحكاتِك لقينا صداها جايي معاكي جايينا/ وحاتك تاني لما تفوتي ابقي اقيفي سالمي الناس وحيينا/ وتماسينا/ عشان نتملّى من عينيك/ عشان نلقى الصباح مسحور/ يِعاين لِصباح خدّيك/ جهرتي الدنيا يا غربتنا يا روعتنا/ ما همّاك.. جهرتينا»(!!)
لقد ودَّع الشاعر السوداني الكبير مصطفى محمد سند مدرسة (الغابة والصحراء) ولاذ بـ (البحر القديم)، ثم ودَّع هذا أيضاً ليترك للحياة دواوين أشعار ملأها مما فاض به قلبه، وما فاض إلا بالحُب والمشاعر الإنسانية والعشق الصوفي للجمال، نأياً بنفسه عن الزيف والكذب والقبح بمعانيها وأشكالها جميعا.
شارك المقال