

حمدي عباس إبراهيم
مستشار اقتصاد زراعي
• السودان قطر يتميز بالغنى وبالتنوع الإيجابي في كثير من مميزاته الجغرافية والموردية والبيئية والإثنية والتاريخية وغيرها. تنوع قوة وتكامل وإضافة وتعاضد. فمن حيث المساحة الكلية يعد الثالث في إفريقيا بعد أن تم انفصال دولة جنوب السودان منه فى عام 2011. مساحته تقدر ب 728 ألف ميل مربع. رقعته الجغرافية تمتد من الشمال، حيث الصحراء الكبرى في شمال إفريقيا، مروراً بأراضي سافنا في وسطه حتى المناطق الاستوائية في جنوبه. لكل من الصحراء والسافنا والاستوائية خصائصها البيئية والمناخية والطبيعية. نهر النيل، أطول أنهار العالم، وعدد من الأنهار الأخرى الدائمة والموسمية والأمطار مصادر مياه مهمة. كذلك نجد في أطرافه الغربية والشرقية سلاسل من الجبال الغنية وذات مناخات وموارد طبيعية خاصة.
الكثير من مساحات السودان الشاسعة غنية بموارد متنوعة فوق الأرض وتحتها، بعضها نادر والعالم في حاجة ماسة له.
لكل هذا فقد تم في منظمة الفاو العالمية للزراعة والأغذية، تصنيف السودان مع كندا وأستراليا كدول تمثل سلة غذاء العالم، لما لها من غنى وتنوع في الموارد الطبيعية.
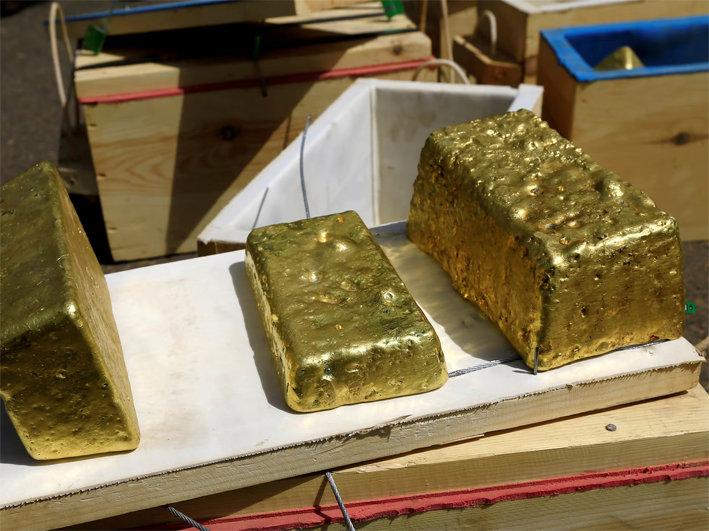
أما من ناحية الموقع الجغرافي في شمال شرق إفريقيا، ومجاورته لما يسمى الدول العربية في شمال إفريقيا، وكذلك دول وسط إفريقيا وجنوب خط الاستواء، فيعد تميزاً جغرافياً وإثنياً وعقائدياً واقتصادياً له أهميته. كما أن إطلالة السودان على البحر الأحمر في مسار طويل، يضيف لأهمية السودان السياسية والمادية والمعنوية بين دول الجوار التي ليست لها منافذ بحرية مع العالم.
من الناحية الإثنية، فالتمازج الإفريقي العربي، الذي حدث منذ قرون على أرض السودان، وكذلك التعدد القبلي والإثني والعقائدي، فتعتبر ميزات لها أكثر من بعد في تاريخ السودان ومستقبله.
من ناحية تاريخية أخرى، فإن تعرض السودان لأنواع مختلفة من الاستعمار، بداية من العهد العثماني التركي، ثم إمبراطورية بريطانيا العظمى إبان استعمارها لمصر، يعتبر من العوامل المهمة في تاريخ السودان، خاصة في بعض الجوانب الاقتصادية والثقافية والخدمية.
الاستعمار البريطاني كما هو معلوم كان يهتم أكثر بالبنيات الأساسية الاقتصادية واحتياجاتها لحدود معينة من التعليم والتدريب والإدارة. وأكيد كل ذلك الهدف الحقيقي منه مصالح الغازي المستعمر لا البلد. ولكن فى نهاية الأمر تظل بنيات أساسية باقية في البلد المستعمر بعد استقلاله.
أمثلة لذلك في السودان، السكة الحديد والمدارس والجامعات ووسائل الاتصال والخدمة المدنية والمشاريع الزراعية والأبحاث وما شابه ذلك.

كل ما ورد من خصائص ومواصفات عامة ولكن أساسية للسودان، ليعتبر ركائز جوهرية ومقومات تطور ونهضة لأي دولة تسعى بوعي وجدية لذلك، وتهيئ كل المتطلبات لتحقيقه.
فما هو حال السودان اليوم، بعد 72 سنة (1954 – 1925)، منذ أن نال استقلاله من بريطانيا العظمى، وأعلن استقلاله رسمياً في مطلع يناير 1956 من داخل برلمانه المنتخب ديمقراطياً؟
من أهم متطلبات النهضة المتوقعة في بلد بكل تلك الركائز والمقومات الإيجابية: الاستقرار السياسي والأمني المستدام، والإرادة الوطنية والرؤى والخطط الواقعية الشفافة والمستدامة. حصل السودان على استقلاله بعد نضال عسكري، تمثل في ثورة علي عبداللطيف في 1924 وثورات عسكرية أخرى، ونضال سياسي سلمي بقيادة مؤتمر الخريجين (أول تنظيم سياسي قومي).
نال حق الحكم الذاتي في 1954 بعد تنظيم أول انتخابات ديمقراطية حرة في البلاد. أعلنت تلك الحكومة استقلال البلاد من داخل البرلمان المنتخب في مطلع 1956 وذلك بإجماع وتوافق سياسي لكل أطياف الكتل السياسية ونواب الشعب أجمعين.
لكن، بكل أسف كان ذلك أول وآخر إجماع حقيقي بين الكيانات السياسية السودانية، لم يتكرر بين النخب السياسية بصورة حقيقية صادقة مرة أخرى حتى تاريخه. تلت ذلك الإجماع بفترة وجيزة بداية التشتت والتشاكس السياسي في عهد أول حكومة مدنية منتخبة (54 – 58)، وكذلك غياب وعدم بلورة الرؤى والخطط طويلة المدى لمرحلة ما بعد الاستقلال.

ولعل في قصر الفترة بين إعلان الاستقلال وحدوث أول انقلاب عسكري – وهو انقلاب عبود في نوفمبر 1958 – والذي وأد تلك الديمقراطية الوليدة في مهدها، ما قد يبرر جزئياً غياب متطلبات النهضة. بل كان هذا الانقلاب العسكري هو الإسفين الأول في أهم متطلبات النهضة والتقدم، ألا وهو الاستقرار السياسي. انقلاب عبود هذا على الشرعية الدستورية البرلمانية، فتح شهية العسكريين للاستيلاء على السلطة مرات عديدة في تاريخ البلاد، مما أطال حالة عدم الاستقرار السياسي حتى تاريخه. وحسب الكثير من المصادر المؤكدة، حدث فى السودان عدد 19 محاولة انقلابية، نجحت منها 7، مع اختلاف فترات حكم من نجح. وبذا يعتبر السودان الأول عربياً والثاني عالمياً من حيث عدد الانقلابات.
ويجدر بنا في تحليل ركيزة الاستقرار السياسي هذه، أن نشير إلى أن هذه ال 72 عاماً منذ استقلال السودان، شهدت وصول أربعة انقلابات عسكرية للحكم: في سنة 58 و69 و89 و2021. حكمت السودان لفترات 6 و16 و30 و4 سنوات على ترتيب تواريخها. وأيضاً كانت هنالك العديد من المحاولات الفاشلة كلياً أو جزئياً خلال فترات الحكم العسكري المشار إليها. وخلال ذات فترة ال 72 عاماً منذ الاستقلال تم حكم السودان برلمانياً وديمقراطياً ثلاث فترات فقط، لم يتجاوز مجموع عمرها 12 عاماً.
وما بين هذا التداول غير السلمي للحكم في السودان، حدثت ثلاث ثورات وانتفاضات شعبية عارمة ضد حكم العسكر، وأعادت الحكم المدني الديمقراطي، وفي كل مرة لم تتجاوز تلك العودة دورة برلمانية ديمقراطية واحدة، ليعود مقامر عسكري جديد بذات المبررات المزعومة.

ولا بدّ أن نشير أنه حتى خلال الحكم البرلماني المدني سادت حالة من التشاكس بين الأحزاب الحاكمة، إذ كانت معظم الحكومات إما قومية أو ائتلافية مبنية على الحد الأدنى من التفاهمات في معظم المواضيع الأساسية، خاصة الاقتصادية والتنموية.
كل ذلك التفصيل يؤكد حالة عدم الاستقرار السياسي في السودان خلال ال 72 عاماً الماضية وحتى تاريخه.
ركيزة أخرى لا بدّ من التعرض لها لأهميتها في التنمية والاستغلال الأمثل للميزات الإيجابية من موارد طبيعية وغير ذلك، ألا وهي الاستقرار الأمني. ففي بداية الحكم الوطني عام 1954 حدث تمرد حامية توريت في جنوب السودان، فكان الطلقة الأولى في عدم الاستقرار الأمني في الجنوب والسودان. وكان ذلك شرارة حرب الجنوب، التي أدت لانفصاله كلياً عن السودان عام 2011. وفي عام 2003 تكرر ذات مشهد عدم الاستقرار الأمني في دارفور وجزء من جنوب كردفان. وهنالك تحول الأمر من صراعات قبلية أو بين المزارعين والرعاة، إلى صراع سياسي وإثني وما زال مستمراً. ولم تبذل أي من الحكومات العسكرية أي مجهود سياسي سلمي صادق لحل مشكلات الجنوب ولا دارفور. بل في الأغلب أصبحت تلك الأنظمة جزءاً أساسياً من تأجيج الصراع لأسباب مهنية أو عقائدية أو لتكريس السلطة. وهنا أيضاً نشير لظاهرة سريان حالات استخدام العنف من الأنظمة العسكرية التي حكمت السودان، وذلك بتكميم الأفواه المعارضة، وكبت الحريات، والحرمان من الحقوق الأساسية، وفرض البرامج دون أي اعتبارات لرأي الشارع المدني، وهو صاحب الحق الأصيل في كل شيء يتعلق بالحكم.
وفي التعامل الحربي فقط مع مشكلة الجنوب من كل الحكومات العسكرية، ما يؤكد ذلك، كمثال لذاك العنف الممنهج وليس حصراً.
مظاهر عدم الاستقرار السياسي والأمني هذه هي من المؤكد الأسباب الرئيسية في عدم استغلال السودان موارده الطبيعية وغيرها من موارد، وأن يظل هكذا في ذيل قائمة الدول المتخلفة. علماً بأن المهنيين والعلماء من السودانيين الذين وجدوا فرصة للهجرة أو الاغتراب في دول مستقرة، تتوفر فيها كل متطلبات الإنتاج والعطاء، قد أثبتوا وجودهم وكفاءتهم. هذا ينفي تماماً محاولات الكثير من العسكريين والقادة المدنيين وتوابعهم إلقاء أسباب فشل تطور السودان على المهنيين وعلى الشعب عامة.

إيماءً لكل ما ورد عن ركائز التنمية والتقدم المطلوبة، وبناء على هذا التحليل، لن يتمكن السودان من تحقيق شعار السودان سلة غذاء العالم، وسيظل بكل أسف مكباً لنفايات العالم، ومتسولاً للإعانات والإغاثة، رغم كل الغنى الموردي والتنوع الإيجابي الموصوف عاليه. سيظل السودان في قائمة الدول المتخلفة غير القادرة على استغلال مواردها الطبيعية، ويستمر صناع وتجار الحروب والأزمات المفتعلة في نهب موارده مرة تلو الأخرى.
لن ينصلح الحال، كما تنبأت الكثير من المنظمات العالمية والإقليمية والخبرات المحلية، إلا بمجهودات خارقة متواصلة لفترة 7 إلى 10 سنوات من تاريخ إنهاء الحرب الحالية. وإن نجح هذا الإصلاح في هذه الفترة، فلن يحدث النهضة، ولكن ربما يعيد البلاد اقتصادياً فقط لنقطة ما قبل الحرب. علماً أن تلك النقطة ليس فيها ما يبشر أبداً لأن تكون الهدف أو المنصة لإطلاق النهضة. لكل هذا لا بدّ من تدابير عاجلة صارمة صادقة أمينة، تشمل:
1- السعي الدؤوب الصادق لترسيخ الديمقراطية الصحيحة في كل مناحي ومكونات الحياة السودانية، من كيانات سياسية أو فئوية أو قبلية أو طائفية أو اجتماعية أو غير ذلك.
وهذا لن يتأتى إلا بأن تكون جموع عامة الشعب في القرى والبادية والمدن الريفية والحضرية هي الحاكم الفعلي صاحب القرار النهائي. لهذه القواعد الجماهيرية الحق الأوحد الدائم في اختيار ومراقبة ومحاسبة القيادات التي يختارها طوعاً من القاعدة لأعلى القمة. لذا لا بدّ من أن تكون البداية محاسبة كافة القيادات الحالية، واختيار البديل حسب معايير جديدة.
2- الضرورة القصوى أن يكون منهج القواعد الشعبية الجماهيرية هو التصدي وهدم كل أنواع العنصريات القبلية والطائفية والدينية والمهنية. وتكون المعايير الأساسية للاختيار هي: الكفاءة والخبرة والأمانة والتجرد، بجانب السمات الشخصية القيادية بإيجابية.
3- استناداً إلى تلك المعايير، تتم إعادة اختيار القيادات السياسية في كل الكيانات والأحزاب السياسية من أقصى اليمين لأقصى اليسار. وذلك من القاعدة حتى أعلى قمة. تتزامن مع ذلك وبذات المعايير العامة، إعادة اختيار وتصعيد القيادات في الكيانات المهنية والدينية والشعبية كافة. وألا يكون هنالك معيار للوراثة أو القداسة في الاختيار. وتتم كذلك مناقشة وإجازة الرؤى الاقتصادية والاجتماعية والمهنية والقانونية والعلاقات الخارحية وغير ذلك، حسب توجه كل كيان سياسي، من جموع القاعدة الشعبية.
4- آليات التنفيذ والإشراف القانوني والإداري الميداني لهذا الأمر كله، يوكل لأجهزة قانونية مستقلة جداً وذات كفاءة عالية.
بالطبع هذا يستوجب إعادة نظر وهيكلة دقيقة ومهنية وأمينة جداً لكافة الأجهزة العدلية الحالية في البلاد، شاملة القضاء والنيابة العامة والشرطة.
كما يستوجب بالضرورة توافقاً كلياً بين الجميع على من ينفذ هذه الهيكلة في الأجهزة العدلية. ولعل في العدد الهائل جداً من القانونيين خارج أجهزة الدولة الرسمية والكيانات السياسية الحالية وكذلك الأساتذة، ما يفي بهذا الغرض الأساسي جداً لعملية الإصلاح الشامل.
5- كل هذا العمل الإصلاحي القاعدي وغيره، يحتاج بالضرورة لمناخ حرية مسؤولة كاملة في أجهزة الدولة الرسمية وكذلك الشعبية والخاصة.
6- مطلوب حرية كاملة منضبطة تخدم قضية البناء الديمقراطي الجديد، وأهم ما في البناء من طرح وتداول وإجازة وتقييم وتقويم للبرامج والرؤى بصورة مستمرة.
كل هذا وغيره من رؤى إيجابية لن يتأتى ويؤتي أكله لشعب السودان، بعد كل أنواع المعاناة المستمرة هذه، إلا بأعلى درجات التوافق الوطني الصادق الأمين المتجرد. ولن يتحقق ذلك إلا في دولة القانون والشفافية، حيث سيادة القوانين العادلة على الكل، دون حصانة أو استثناء لفئة أو كيان أو أحد.
مهام ليست سهلة، لكن أكيد غير مستحيلة. إذا فشلنا في تحقيق هذه الرؤى والأماني، فما هو إلا تصديق للمتنبي حين أنشد:
ولم أرَ فى عيوب الناس عيباً
كعجز القادرين على التمام.
شارك المقال












