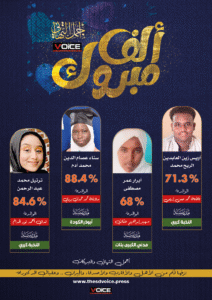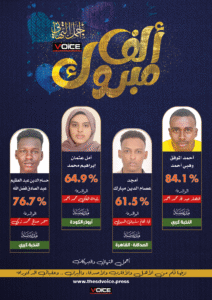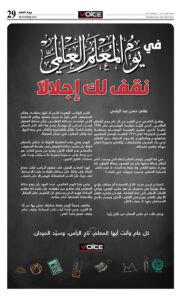التعليم العالي في السودان في مفترق طرق.. أرقام صادمة ومصير وطني يحتاج لرؤية إنقاذ
Admin 19 يوليو، 2025 1220

د. إيهاب عبد الرحيم الضوي أحمد
اختصاصي تحليل بيانات وخبير إحصاء – عضو هيئة تدريس بالجامعة العربية المفتوحة بدولة الكويت
• «شي في غاية الجدية» هكذا عنوَن المهندس وليد محمد المبارك- مدير ادارة البحث والتطوير وضمان الجودة بمركز معلومات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بالسودان- مقاله الجريء، الذي هزّ أركان المنظومة التعليمية بأرقامه الصادمة، وتوصياته التي تضع صناع القرار أمام لحظة مفصلية لا تقبل التردد.
في واقعٍ اجتاحته الحرب، وأثقلته موجات النزوح القسري، وغيّب عنه الاستقرار المؤسسي، لم تعد الأزمات التعليمية تُقاس بتراجع الترتيب العالمي أو تدني الميزانيات فحسب، بل باتت تقاس بغياب الأمل، وانحسار الحلم في عيون الشباب، وتحوّل القاعات إلى أطلال، والكراسات إلى أحزان مؤجلة.
جاءت نتائج التقديم للجامعات السودانية لعام 2025 كمرآةٍ صادقة لوجه الأزمة دون رتوش، كاشفة عن جرح نازف لا يمكن إخفاؤه تحت شعارات موسمية أو خطط نظرية على الورق. لم تعد المشكلة في توفر المقاعد، بل في من تبقى ليجلس عليها، ولم تعد المشكلة في عدد الجامعات، بل في قدرتها على الصمود وسط الانهيار العام.
إنها أزمة بنيوية تجاوزت الأرقام، لتكشف عن هشاشة في منظومة لم تراجع نفسها بما يكفي، ولم تُؤهَّل لمواجهة الطوارئ، ولم تُحصّن بأدوات الاستدامة في زمن الحرب والسلام معاً. الأزمة هنا لا تتعلق فقط بانخفاض نسب القبول أو بهجرة المتفوقين، بل تتعلق بفقدان الثقة في التعليم كوسيلة للترقي الاجتماعي والوطني، وبتآكل الإيمان بدور الجامعة في صناعة المستقبل.
في ظل هذه المعطيات، يغدو السؤال الأكبر: هل يمكن لنظام التعليم العالي في السودان أن ينهض مجدداً من هذا الركام؟ وهل نملك الجرأة لا فقط للاعتراف بالأزمة، بل لصياغة مشروع وطني حقيقي لإعادة بناء التعليم كأولوية استراتيجية؟
هذا ما سعى المقال الأصلي لإثارته، دون مواربة أو تزيين للواقع. ومن هنا تبدأ مسؤولية الجميع: دولةً، مجتمعاً، أكاديميين، ومنظمات دولية، لوضع التعليم في مركز أجندة التعافي، لا في هامش الخطابات.
الأرقام لا تكذب… لكنها تئن تحت ثقل الواقع
بحسب الإحصائيات الواردة في المقال الصادر عن المهندس المبارك، فإن أزمة التعليم العالي في السودان قد تجاوزت مرحلة القلق، وانتقلت إلى مرحلة الخطر الهيكلي العميق. فعلى الرغم من تسجيل 337,484 طالباً لأداء امتحانات الشهادة الثانوية، لم يتمكن من الجلوس للامتحان فعلياً سوى 226, 730 طالباً وطالبة فقط، أي ما نسبته (67.2%) وهي نسبة تترجم ميدانياً إلى عشرات الآلاف من القصص التي لم تكتمل: نزوح، انقطاع دراسي، فقر، أو حتى غياب الأمان الجغرافي لأداء الامتحان.
ومن بين من جلسوا، نجح 149,142 طالباً وطالبة فقط، بنسبة نجاح عامة بلغت (66%) وهنا تبدأ المفارقة؛ فحين نغربل الأرقام أكثر، نجد أن (52%) فقط من الناجحين، أي نحو 77,549 طالباً، هم المستهدفين بالتقديم لمؤسسات التعليم العالي. لكن المفاجأة – بل الصدمة الإيجابية – أن عدد الطلاب الذين تقدموا فعلياً بلغ 88,942 طالباً وطالبة؛ أي بنسبة (114.7%) من العدد المستهدف. هذه النسبة المرتفعة رغم الظروف المزرية تعبّر بوضوح عن تعطشٍ عميق للتعليم، وعن رغبة شعبية جارفة لدى آلاف الأسر في أن يبقى التعليم هو الأمل الأخير للخروج من نفق الحرب، والفقر، والتيه.

عندما يتحوّل فائض المقاعد إلى مؤشر أزمة
في أي سياق طبيعي، قد ينظر لهذا الإقبال بأنه نجاح للنظام التعليمي. لكن المعضلة الكبرى تظهر حين يُقارن هذا الرقم بإجمالي السعة المخططة لمؤسسات التعليم العالي في السودان، والبالغة 340,000 مقعد. فما حدث فعلياً هو أن نسبة الإشغال لم تتجاوز (26%) فقط، ما يعني أن أكثر من 250,000 مقعد ستظل شاغرة بعد التقديم للدور الأول. هذا الرقم لا يعبر عن وفرة ولا عن مرونة في النظام، بل يكشف عن خللٍ جوهري في منظومة التخطيط التربوي. نحن أمام مفارقة صادمة: الفرص موجودة، ولكن الوصول إليها مفقود. فالجامعات حاضرة بالبوابات والقاعات الدراسية التي حطمتها الحرب، ولكن من ينبغي أن يدخلها إما عالق في مخيم نزوح، أو يحاول عبور الحدود نحو مستقبلٍ أكثر أماناً في الخارج، أو ببساطة فقد إيمانه بقدرة تلك الجامعات والقاعات على صناعة حلمه.
بين العرض والطلب… تتوارى العدالة التعليمية
وهنا نلامس لب الأزمة: ليست المشكلة في عدد المقاعد، بل في قدرة الدولة على تأمين بيئة تعليمية طويلة الأمد. فالتعليم لا يقاس بعدد الكراسي ولا بحجم القاعات، بل بتوافر المعلم المؤهل، والمحتوى الحديث، والخدمات الأساسية، والأمان النفسي والمعيشي للطالب. وما نشهده اليوم هو اتساع في الفجوة بين ما هو مخطط على الورق، وما هو ممكن التحقيق في الواقع. إن بقاء ربع مليون مقعد شاغر لا ينبغي أن يُقرأ كفرصة مهدورة فحسب، بل كإنذار وطني يستدعي التوقف والتأمل والتدخل العاجل. لأن اتساع الفجوة بين العرض والطلب في هذا السياق لا يعني فقط فشلاً في الاستيعاب، بل نزيفاً مستمراً في الكفاءات، وهجرة صامتة للأحلام، وغياباً مدوياً للعدالة التعليمية التي طالما تغنى بها السودانيون.
هجرة العقول قبل أن تولد
في الوقت الذي يعاني فيه السودان من نزيف العقول المتواصل منذ عقود، يبدو أن الحرب الأخيرة قد دفعت بهذه الظاهرة إلى مستوى جديد وخطير: هجرة العقول قبل أن تُولد. فالمقال يشير إلى أن نسبة لا يستهان بها من الطلاب المتفوقين لم يتقدموا للجامعات المحلية، ليس لأنهم غير راغبين في التعليم، بل لأنهم – وأسرهم – لم يعودوا يرون في المؤسسات المحلية فضاءً آمنًا أو مُجدِيًا للاستثمار في المستقبل.
إن الحديث هنا لا يدور حول خريجين غادروا البلاد بعد التخرج، بل عن نخبة من الشباب الذين لم يلتحقوا أصلًا بالجامعات السودانية، واختاروا طرقًا بديلة للتعليم في الخارج، أو حتى توقفوا عن المحاولة تماماً، وفضلوا اللجوء إلى أسواق العمل أو الهجرة غير النظامية. وهنا تكمن الخطورة: إذا كانت العقول لا تجد مناخاً لتنشأ وتصقل فيه، فسنفقد طبقة كاملة من القادة والمهنيين قبل أن تتشكل أصلاً.
تراجع نوعي في نسب القبول: انهيار لا مجرد انخفاض
من أبرز ما كشفه المقال، هو التراجع المتوقع في نسب القبول في التخصصات النوعية، وفي مقدمتها كليات الطب والهندسة، وهي التي كانت تمثل «قمة الهرم» في التنافس الأكاديمي لعقود طويلة. حيث يتوقع أن تنخفض نسب القبول في الطب إلى (83-85%) مقارنة بـــ (91-93%) في السنوات السابقة، وأن تنخفض في الهندسة إلى (75-78%) مقارنة بـ (85-88%).
لكن هذا الانخفاض ليس مجرد رقم على مقياس المنافسة، بل هو مؤشر على ضعف الإعداد العام في المرحلة الثانوية، وتراجع جودة مخرجات التعليم العام، وانعدام التحفيز الذهني للطلاب بسبب الأزمات المعيشية والنفسية. إنه بمثابة ناقوس خطر يهدد جودة التعليم العالي من الداخل، إذ ستضطر الكليات إلى قبول طلاب بمستوى أكاديمي أقل، دون وجود أنظمة داعمة تعويضية أو برامج تقوية حقيقية. بكلمات أوضح: حين تهتز قاعدة التميز في كليات كانت تمثل الواجهة العلمية للبلاد، فإن ذلك سينعكس مباشرة على مخرجات النظام الصحي والهندسي خلال العقد القادم، ويضعف قدرة الدولة على بناء كوادر مؤهلة لمرحلة إعادة الإعمار والتنمية.
قبول بنسب دون 50%: هل نحن أمام انهيار للحد الأدنى؟
في مفارقة تجسد عمق الأزمة، قد تصل نسب القبول في بعض الكليات إلى ما دون 50%، خصوصاً في الكليات ذات القبول الواسع مثل الزراعة، الاقتصاد، الآداب، وعلوم التربية. هذه النسب – التي كانت قبل أعوام تعتبر خطوطاً حمراء – باتت اليوم خياراً مفروضاً على وزارة التعليم العالي، تحت ضغط نقص المتقدمين وضعف تحصيلهم. وهذا التراجع لا يعني فقط توسيع باب القبول، بل يهدد بفقدان المعايير الأكاديمية الأساسية. فالجامعات ليست أماكن للإيواء، بل مؤسسات لصناعة الكفاءة والمعرفة. وعندما يُقبل الطالب في تخصص اقتصادي أو تربوي أو زراعي بنسبة نجاح دون 50%، فنحن أمام مخرجات هشة، قد تعجز عن المنافسة داخلياً وخارجياً، وتُضعف سمعة الشهادة السودانية، وتكرس مزيداً من الفاقد التعليمي. كما أن هذا الانخفاض في النسب سيؤثر سلباً على التحفيز الداخلي للطلاب، إذ يُصبح الانضمام للجامعة أمراً سهلاً لا يتطلب جهداً حقيقياً، ما قد يؤدي إلى مزيد من التسرب الجامعي، وتراجع الاهتمام بالتحصيل.
خلاصة أولية: تآكل العمود الفقري للتعليم العالي
إن المؤشرات الثلاث المذكورة في المقال ليست مجرد انعكاس لحرب جارية، بل دليل على أن النظام التعليمي في السودان يعاني من شيخوخة مؤسسية، وغياب الرؤية الاستراتيجية، وانفصال كامل بين مخرجات التعليم العام واحتياجات التعليم العالي.
فالهجرة، وتراجع نسب القبول، والانخفاض المقلق في الحد الأدنى للالتحاق، كلها تشير إلى أن التعليم العالي في السودان لا يعيش أزمة مؤقتة، بل يقف على حافة انهيار بنيوي ما لم يتم التدخل فوراً، وبقرارات غير تقليدية، تُراعي الواقع وتستشرف المستقبل.
كيف نقرأ المستقبل من تحت الركام؟
حين تسقط مؤسسات الدولة تباعًا بفعل الحرب والانهيار، يبقى التعليم هو الحصن الأخير الذي نحتمي به من السقوط الشامل. وفي مقاله التحليلي العميق، لم يكتف المهندس المبارك بعرض الأرقام أو تشخيص العلل، بل انحاز للحل، ووضع خريطة إنقاذ عاجلة، واقعية وشجاعة، تعكس فهماً عميقاً لتعقيدات المرحلة واستحقاقات المستقبل.
وفي ما يلي أبرز معالم هذه الخطة، التي تمثل – في جوهرها – مشروعاً وطنياً لاستعادة ثقة الطلاب والأسر في التعليم كمصدر للأمل، لا كمجرد شهادة بلا جدوى:
1. تعديل نظام المنافسة ليشمل 5 مواد فقط: واقعية في التقييم لا تهاون في الجودة.
في ظل الانقطاع المتكرر في العملية التعليمية، والنزوح الجماعي، وغياب المعلمين المؤهلين في بعض المناطق، فإن الإبقاء على نظام التنافس القائم على سبع مواد يمثل عبئاً لا يتناسب مع الواقع. توصية تعديل هذا النظام ليُحتسب من خمس مواد فقط هو إجراء عادل وإنساني، لا يعني التنازل عن الجودة، بل هو تصحيح للمسار وفق الإمكانات المتاحة.
فما يحتاجه السودان اليوم ليس «تفريخ متفوقين على الورق»، بل إعطاء الفرصة لمن صمدوا في وجه الحرب كي يكملوا تعليمهم ضمن شروط واقعية ومنصفة.
2. خفض النسبة الدنيا للكليات الطبية والهندسية: مخاطرة محسوبة أم ضرورة وطنية؟
توصية خفض النسبة الدنيا للقبول في كليات الطب إلى 60% والهندسة إلى 60%، تمثل قراراً جريئاً وغير مسبوق، لكنه لا يخلو من الجدل. ففي سياق الأزمات، قد يبدو هذا الإجراء ضرورياً لاستيعاب مزيد من الطلاب وتغطية الفجوة في الكوادر الصحية والتقنية، خاصة في ظل هجرة الأطباء والمهندسين.
لكن هذا القرار يتطلب، في المقابل، إجراءات مصاحبة صارمة، مثل: تطوير البرامج التعويضية داخل الكليات، تدريب أعضاء هيئة التدريس على التعامل مع تفاوت المستويات، ضمان جودة الامتحانات النهائية كمصفاة للحد الأدنى من الكفاءة. فالتعليم النوعي لا يقاس فقط بنسب الدخول، بل بقدرة المؤسسات على تحويل الفرصة إلى كفاءة حقيقية.
3. فتح باب التقديم لدفعات سابقة: إنصاف جيل تائه بين الحرب والحرمان
ما بين العام 2020 و2023، فقد آلاف الطلاب فرص التقديم الجامعي بسبب تعقيدات الحرب والنزوح والانقطاع.
لذا فإن فتح باب التقديم لهذه الدفعات ليس مجاملة إدارية، بل استحقاق إنساني وعدالي لجيل عُلِّق مستقبله دون ذنب. إتاحة الفرصة لهؤلاء تعني الاعتراف بظروفهم الاستثنائية، واسترداد جزء من الثقة المنهارة في الدولة ومؤسساتها التعليمية.
4. إطلاق التعليم الإلكتروني والمفتوح: كسر الحصار بالمعرفة
مع غياب البنية التحتية في عشرات المناطق، وانهيار منظومة المواصلات، وندرة المعلمين، لم يعد بالإمكان الاعتماد على التعليم التقليدي وحده. لذا جاءت التوصية بتفعيل التعليم الإلكتروني والمفتوح كخطوة ذكية وعملية، تسمح بمرونة الوصول، وتقلل الكلفة، وتفتح آفاقاً للطلاب داخل السودان وخارجه.
لكن هذا يتطلب:
• بنية تحتية رقمية بسيطة وفعّالة.
• تدريب الكوادر على أدوات التعليم عن بعد.
• تطوير محتوى تفاعلي يناسب السياق السوداني.
إنها فرصة تاريخية لتحرير التعليم من قيود الجغرافيا والنزاع.
5. الدعم النفسي والتعليمي للطلاب المتضررين: التعليم لا يزدهر على أنقاض النفوس
في خضم النقاشات حول القبول والمقاعد، غالباً ما ينسى البعد النفسي، رغم أنه الأكثر تأثيراً في دافعية الطالب وقدرته على الاستيعاب. الطلاب القادمون من مناطق الحرب والنزوح يحملون في داخلهم جراحاً لم تُداوَ بعد.
لذا فإن تقديم برامج دعم نفسي، وإرشاد أكاديمي، ومعسكرات تعليمية تأهيلية يمثل خطوة ضرورية لإنقاذ ما تبقى من الطاقة التعليمية لدى هؤلاء الشباب. ليس المطلوب فقط أن نُدخلهم الجامعة، بل أن نُعيد إليهم إيمانهم بأن مستقبلاً ما يزال ممكناً.
مسؤولية وطنية لا تقبل التأجيل
إن هذا المقال بمثابة جرس إنذار مبكر قبل أن يتحول التراجع إلى انهيار، والانهيار إلى تيه لا فكاك منه. إذا لم يتم التعامل مع هذه المؤشرات بجدية، فإن السودان قد يواجه مستقبلاً خالياً من الكوادر الوطنية المؤهلة، ما يفتح الباب واسعاً أمام الانكشاف التربوي والعلمي في مرحلة ما بعد الحرب. الجامعات ليست مباني وشهادات، بل هي محاضن لبناء الوعي، وركائز لإنتاج المستقبل. فحين يتراجع التعليم، تتراجع الدولة، ويبهت الأمل.
ما كتبه المهندس وليد محمد المبارك أحمد لا يجب أن يُقرأ كمقال فني أو إداري، بل كوثيقة إنقاذ وطني. لقد قدّم بالأرقام والحجج ما يكفي لفتح أوسع نقاش وطني حول مستقبل التعليم العالي في السودان، من وزارات الدولة إلى منظمات المجتمع المدني، من الجامعات إلى أولياء الأمور، فالمعركة القادمة لن تكون فقط مع الفقر أو النزوح أو الحرب، بل مع الجهل والتراجع وفقدان الثقة.
فليكن هذا المقال بداية لوضع التعليم في قلب مشروع إعادة بناء الدولة، لا على الهامش. فالسودان لا يمكن أن يُبنى من جديد، إلا من مقاعد الدراسة، ومن دفاتر الطلاب، ومن طموح لا يُهزم رغم الأنقاض.
شارك المقال