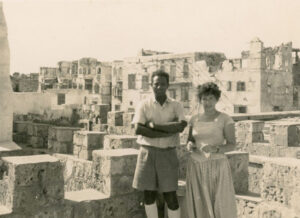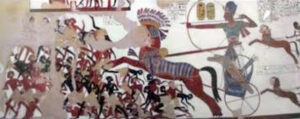محمد الشيخ حسين
mohed1618@gmail.com
• عندما ينتقل المفكر من عامل الفكر ليؤدي دوره على المسرح الحديث. هل يلتزم الصحفي بحرفية الوقائع والأحداث؟ أم له حرية الاختيار بين المواقف والوثائق ليبرز رؤية معينة قد يهملها التاريخ من أجل أن تصل بجماهير القراء المعاصرين إلى ذروة التنوير والتأمل وكشف حقائق جديدة.
ومع كثرة الحديث عن دولة 1956 هذه الأيام تعود الذاكرة السودانية إلى الاستقلال لتنقل هذه الإفادات من البروفسير مدثر عبد الرحيم صاحب الامبريالية والقومية وكتابات أخرى في المسألة السودانية.
وصاحب الإفادات ليس في حاجة للتعريف وحوارنا ينطلق من رؤية المفكر للأعوام التي مضت وفي ذهنه أعواما أخرى تتطلب الجهد والعمل المثابرة. وقبل القراءة نعتقد أن وقوف حوارنا في نقاط بعينها هو ما قصدنا منه أن نصل بجماهير القراء المعاصرين إلى ذروة التنوير والتأمل والحكم، بداية ونهاية، للقراء وحدهم.
في البداية طلبنا من البروفسير مدثر عبد الرحيم أن يحدثنا عن الاستقلال (الحدث التاريخي) وهل كان استقلالاً حقيقياً؟
عند الإجابة عن هذا السؤال تبرز نقطتان:
الأولى تتعلق بنوعية الاستقلال الذي حصلنا عليه والثانية تتعرض إلى المشكلات التي عانينا منها منذ ذلك الحين وصلتها بالكيفية التي نلنا بها الاستقلال، وفيما يتعلق بالنقطة الأولى ليس من شك في أن الاستقلال الذي نلناه واحتفلنا به في يناير 1956م كان من الوجهة القانونية الشرعية استقلالاً تاماً مجمعاً عليه من قبل الشعب داخلياً ومن قبل ممثليه في البرلمان الذين أجازوا القرار الشهير في 19 ديسمبر 1955م، ومعترفا به دوليا من قبل المنظمات الدولية المختلفة ومعترفا به من قبل الدول الأخرى بداية بدولتي الحكم الثنائي.
أما الحديث عن الاستقلال الحقيقي فتلك مسألة نسبية تدعونا دائما لتجاوز المسائل الدستورية بالسؤال عن ما هو بعدها، من قوة الدولة وسيادتها الفعلية أي مقدرتها على اتخاذ القرارات المؤثرة والمنظمة لشئونها الداخلية باستقلال تام عن المؤثرات الأجنبية على إدارة الأمة.
والحديث عن الاستقلال بهذا المعنى لا يمكن أن يُصاغ إلا بصورة نسبية وثمة دولة لا تستطيع أن تفعل ما تشاء مطلقا وهنالك عوامل كثيرة محلية وعالمية تحد من سلطات أي دولة كما تحد من سلطات أي حكومة في داخل أي دولة.
وقد لا ينطبق هذا الكلام على الدول العظمى والمسألة بتفاوت حالة الدولة في إطاره العام.
دول العالم الثالث للأسف دول هشة والسودان كواحد منها تؤثر علية الدول والهيئات العالمية مستغلة ضعفها الاقتصادي والضغط و التأثير على النواحي السياسية والاقتصادية والعسكرية … الخ مما تنعكس آثاره السلبية الخطيرة على السيادة بمعني حرية التصرف والمقدرة على إدارة الشئون الداخلية والتحرك في المجتمع الدولي.

التحرير أم التعمير
رفع الأزهري شعار التحرير قبل التعمير هل كان شعاراً صحيحاً، لأنه لو رفع شعار التعمير ربما تأخر الاستقلال أم أن في الشعار نفسه تكمن بداية مأساة المسألة السودانية؟
هذه العبارة كانت شعاراً قومياً ورفعه الرئيس الأزهري في فترة معينة وفي طور معين من مراحل تقدم البلد، وهي عبارة يمكن بسهولة أن يساء فهمها ما لم نتذكر الإطار السياسي والوضع الشامل الذي قيلت فيه.
وعندما قيلت هذه العبارة كان الاستعمار واقعا مؤلما وكان البعض يروج للاستعمار بأنه مشتق من العمار وكانت حقيقة الأمر أن الاستعمار كان استخرابا وفي ذلك الجو كان الوطنيون مجمعين على أن التعمير والتطوير الاقتصادي والاجتماعي وما إليها من مبررات بقاء الاستعمار كلها دعاوى باطلة ولا يمكن أن تحقق فعلا وبصورة تشبع حاجات الشعب السوداني.
وفي هذا الجو صيغت هذه العبارة (التحرير قبل التعمير) وكان لا بد من رفع هذا الشعار حتى لا تستعمل حجة التعمير بغرض إطالة أمد الاستعمار.
سبب الإخفاقات
الإخفاقات التي شهدناها في حياتنا خلال السنوات الماضية هل يمكن إرجاعها إلى الطريقة التي نلنا بها الاستقلال؟
بدون شك في أن الطريقة التي ينال بها أي بلد استقلاله تؤثر تأثيراً مباشراً على الكيفية التي يتصرف بها قادته في إدارة شؤونه بعد الاستقلال، وقد تبدو هذه الفرضية بصورة مباشرة بين البلاد التي نالت استقلالها نتيجة حروب تحريرية ضارية كالجزائر (مثلاً)
وقد تظهر أحيانا في الدول التي نالت استقلالها بسبب انهيار الدولة المستعمرة كإيطاليا (مثلا)
وهنالك الدول التي تنال استقلالها نتيجة الضغوط السياسية على الدولة المستعمرة من قبل الحركات الوطنية أو من قبل البيئة الدولية أو الطرفين معا.
وفي الحالة الأولى تحل نتيجة للحروب نفسها كثير المشاكل تلقائيا وفي أتونها وبسبها تظل بعض المشاكل.
وفي الحالتين الأخريين، فإن المؤشر هو مسألة اختيار القيادة السياسية وغلبة المواطنة على أي ولاء آخر ومدى قدرة القيادة على تعبئة الشعب لتحقيق التنمية والتحرر الاقتصادي والاجتماعي.
والدول التي تنال استقلالها نتيجة التحرر أغلب الظن أنها أكثر مقدرة على التنظيم وتركيز الولاء ولو أنها ستجابه بقضايا أخرى تتعلق بحقوق الفرد وحريته.
وفي الأحوال الثلاثة فإن الموضوع يتعلق بالعمليات التاريخية المتصلة بكيفية حصول أي قطر على الاستقلال ومقدرة أو عجز القيادات الفردية وإن كانت مؤثرة بحكم التعريف إلا أنها إفرازا للتطورات التاريخية الجارية في البلد.

المثقفون والأصول
حركة المثقفين السودانيين هل افتقرت منذ البدء إلى الأصول الصلبة التي تنتقل بها من أشكال الهلامية إلى التنظيم والممارسات الجماعية؟
هنالك حقيقة أساسية لا تغيب عن الذهن وهي أن القيادة السياسية عجزت عن أن تقود البلاد مستقلة عن الطوائف فضلا عن أنها كانت ناشئة وضعيفة بحكم التعريف ومن حيث العدد وضيق الآفاق الثقافية والفكرية المتاحة والضعف الاقتصادي والسياسي.
عصفت هذه الأنواء بجيل المؤتمر لأن الجيل الذي سبقه (جيل ثورة 1924) قد طمح إلى الفتوة واستخدام القوة في ثورته المشهورة (على عبد اللطيف ورفاقه) هذا الجيل (جيل 1924) فتك به من قبل الانجليز وقلصت المنابع التي نهل منها المثقفون وكثفت المراقبة.
تحت هذه الضغوط لم يكن في إمكان الجيل التالي ولا نتوقع عدلا أن يشبهه بنفس الروح.. الروح القوية منذ البداية .. بل الواقع أنهم كانوا في حالة إغماءة جعلت من الصعب عليهم أن يتحركوا أي تحرك نظرا لشدة الضربة والمراقبة باستثناء مجالي الفكر والأدب ولا سيما الأغاني الوطنية التي كانت تصاغ وتشاع كأغاني خليل فرح.
وعندما انفرجت الأزمة وخصوصا بعد 1936م أصبح من الممكن أن يجاهروا بآرائهم السياسية ويتحدثوا عن السياسة بصورة علنية في هذا الإطار أمكنهم إنشاء المؤتمر ولم يتأخروا كثيرا في الدعوة له.
ومع هذه الانطلاقة النسبية كان عليهم أن يسيروا بشئ من الحذر وان ينظروا حولهم مراراً وعلى هذا النهج سار الكثير من أعضاء المؤتمر ورفض هذا النهج عدد من الخريجين أنفسهم لأن أمزجتهم ثورية مثل أحمد خير، خضر حمد، وآخرون أرادوا أن يتمردوا على الأوضاع ونجحوا في التحرك في اتجاه يمكن أن نقيّمه في إطار الظروف التي عاش فيها وأن نتذكر أن الحركات سياسية كانت أم ثورية لا تولد بين عشية وضحاها وبعد أن نلتمس لهم كل الأعذار والحقيقة أنهم كانوا أبناء ظروفهم وكانت لهم مزايا النشأة السياسية والاجتماعية المكتسبة من المرحلة التاريخية التي عاشوها وكانت لهم سلبيات تلك الظروف والمرحلة.

المؤشرات للمستقبل
من خلفيات سنوات ما بعد الاستقلال هل يمكنك أن تقدم لنا تصورك لمؤشرات آفاق المستقبل؟
عند الإجابة عن مثل هذا السؤال لا بد من التمييز بين ما يشتهيه الإنسان وما يتوقعه في الواقع.
أما آفاق الأمل والتمنيات لا تحدها حدود ولكن يهمنا تقدير الاحتمالات على ضوء الحقائق الواقعة وفي هذا الإطار ونظرا لتجاربنا المرة منها والحلوة منذ الاستقلال يمكن أن نوجز التوقعات (إذا حجبنا الغيب والمفاجآت) على النحو التالي:
أولاً:
تزايد التفاعل بين سكان الأقاليم المختلفة مع التسليم بما قد يفرزه هذا التفاعل المتزايد في المدى القريب من اتجاهات انفصالية تغري بعض الناس بالانكفاء على الذات المحلية أو الضيقة. وأغلب الظن أن يقترب السودان في أواخر الثلاثين عاما المقبلة من التوحد القومي في إطار الثقافة العربية الأفريقية الإسلامية التي صاغت المجتمع السوداني الموحد حالياً والتي تتميز بقدرتها على صياغة المجتمعات بهذه الشاكلة التي تتميز بالانفتاح والبعد عن التعصب.
ثانياً:
ومع تزايد أهمية المدن والحياة المدنية في السودان داخليا وتزايد التأثر والانفعال بحياة العالم الخارجي ولا سيما العالم الصناعي المتقدم والمؤثر على معظم أهل البلد من خلال وسائل إعلام مختلفة يبدو لي أن كثيرا من قيمنا وتقاليدنا ستكون في خطر حقيقي من التآكل آو الاستبدال بأخلاط من القيم وأنماط السلوك الغربية المتصادمة وغير المنسجمة مع بعضها في نفس الوقت ..
وأحسب أن هذا الإضطراب في القيم الثقافية والسلوكية سيزداد مع تزايد تمكن وانتشار وتغلل المزاج الاستهلاكي والتفاخري في الحياة الاقتصادية وهذا بدوره سيفرز تأثيرات سلبية على أداء الناس إفرادا وأداء المؤسسات الرسمية إلا إذا نبعت من داخل مجتمعنا حركات تصحيحية تتميز لا بمجرد ادعاء المقدرة على المزاوجة بين الأصالة والتجدد وإنما بالمقدرة في ذات الوقت على استقلالنا الثقافي والمقدرة في ذات الوقت على الانفتاح الايجابي والفعال مع العالم لدفع حركة التطور بصورة مضطرة ومرضية.
ثالثاً:
لنفس الأسباب المتقدمة مضافًا إليها تزايد الضغط السكاني مع عجز الأجهزة الإدارية في توفير الخدمات.
والخطر الحقيقي يكمن في تدني المستويات الثقافية والفكرية والمهنية ما لم تهيأ الظروف السياسية والاجتماعية التي تمكن الناس من صياغة بعيدة المدى وفعالة لتلافى هذه الأخطار ولا سيما الطاقات والإمكانات الهائلة في السودان لتحقيق النهضة المنشودة ولن تحقق بمجرد إحساسنا بالحاجة إليها أو الرغبة فيها بل تحتاج لتعبئة إرادة الأفراد والمؤسسات والجماهير على مختلف المستويات الحلقية والسياسية والتربوية.
وخلاصة القول إن فرص المستقبل كبيرة ولكن تحديات هذا المستقبل كبيرة ويتوقف الأمر على التوعية والاستجابة ومقدرتنا على الأصالة.
هل يعنى هذا أننا مازلنا في مرحلة البحث عن نظام؟
بكل تأكيد الإجابة نعم وفي ذهني أن هذا البحث يجب أن يستهل بإعداد دستور والتفكير الجاد في جعل اقتصادنا إنتاجيا وفي هذا الإعداد وذاك التفكير يجب أن تكون الوحدة الوطنية النبراس الذي يضئ الطريق للباحثين وهذا مجال رحب أدعى إلى أن يتنافس فيه المتنافسون .. والله الموفق.
«نقلا عن موقع المحقق»
شارك المقال