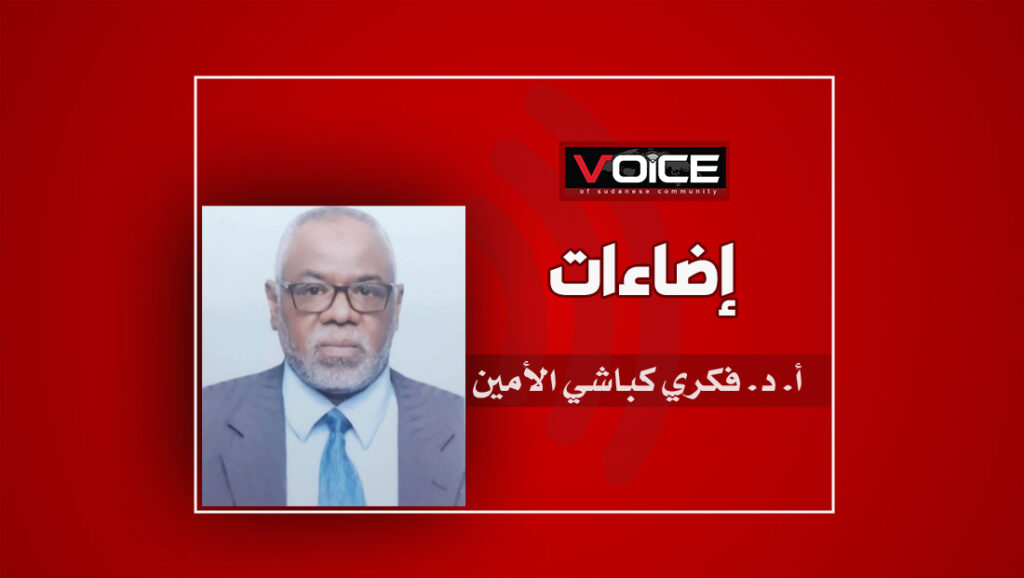
أ. د. فكري كباشي الأمين
خبير اقتصادي
• نشأ «اقتصاد المعرفة» خلال ثلاث تحولات ميّزت تطور المجتمعات البشرية، فمن المجتمع الزراعي إلى المجتمع الصناعي، وصولاً إلى المجتمع المعرفي. ويمكن توضيح ذلك من خلال ما يلي:
التحول الأول: المجتمع الزراعي
وبدأت هذه الثورة أول ما بدأت على ضفاف الأنهار الكبرى في المنطقة القريبة من المنطقة الاستوائية نهر النيل ودجلة والفرات، حيث التربة الخصبة.
التحول الثاني: المجتمع الصناعي أو «اقتصاد الآلة»
إن عملية الانتقال من التحول الأول إلى الثاني (من الزراعة إلى الصناعة) ترجع لعدة أسباب؛ أهمها تضخم عدد السكان في المناطق الآهلة، ومحدودية المصادر الطبيعية، وعجزها عن توفير الكميات الكافية من ضروريات العيش، وكذلك التمايز الشديد للمناطق الآهلة من حيث المزايا الطبيعية المتوفرة، وكذلك ظهور العديد من مصادر الطاقة الجديدة.
فكان ضرورياً اللجـوء إلى عملية التصنيع بدل عمليات الزراعة والصيد، ولذلك استخدمت الآلة، فالآلـة أساس المصنع، والمصنع عمود الصناعة.
التحول الثالث: المجتمع المعرفي أو «اقتصاد المعرفة»
لقد شكلت الحرب العالمية الثانية نقطة التحول الثالث، والذي تمثلَ في الثورة العلمية أو المعرفية. ومن أهم ما ميز هذا التحول، العمل على تحول المعرفة إلى قوة منتجة، وتقلص المسافة الفاصلة بين ميلاد الاختراع وتطبيقه على أرض الواقع، فلم تمضِ سوى خمس سنوات على اكتشاف الترانزستور حتى عم استعماله صناعياً، وفي هذا السياق، كتب «دانييل بيل» عام 1967 يقول: إن متوسط طول المدة بين اكتشاف مبتكر تكنولوجي جديد وبين إدراك إمكانيته التجارية كان ثلاثين عاماً في الفترة ما بين عامي 1880 و1919، ثم انخفض إلى 16 عاماً في الفترة ما بين عام 1919 و1945، ثم إلى 9 أعوام، وكلما مرت السنوات كلما قصرت المدة بين الابتكار والتحول إلى نمط الإنتاج العلمي والتقني، من مرحلة الإبداع الفردي إلى الإنتاج الجماعي خلال القرن العشرين، بمعنى أنه خلال التحولين الأول والثاني كان الأفراد هم أساس الاختراع والابتكار، أما في ظل التحول الثالث، فقد أصبحت المؤسسات والجامعات… إلخ هي الرائدة في إنتاج الصناعات الابتكارية والتكنولوجية، لقد استخدمت عدة مسميات لتدل على اقتصاد المعرفة، مثل اقتصاد المعلومات، واقتصاد الإنترنت، والاقتصاد الرقمي، والاقتصاد الإلكتروني. كل هذه التسميات لتشير في كليتها إلى اقتصاد المعرفة.
وإن حاولنا أن نسقط الأمر على السودان، الذي يعد في الأساس مجتمعاً زراعياً، كما وجدت آثار تدل على أن المجتمع السوداني عرف الزراعة منذ أمد سحيق قد يمتد إلى ما قبل التاريخ، ثم بدأ التحول إلى المجتمع الصناعي. وأن عملية الانتقال والتحول من الزراعة إلى الصناعة في السودان منذ مطلع الستينات وإلى السبعينات، حيث يعتبر أنه بدأ منذ فترة مبكرة مقارنة بدول الجوار مثل دولة إثيوبيا، التي بدأت تتلمس الطريق نحو التحول من الزراعة إلى الصناعة أو الصناعات الزراعية.
ولدينا في السودان العديد من النماذج، وعلى سبيل المثال وليس الحصر، مثل تصدير الجلود المدبوغة وكذلك المصنعة كأحذية كشركة (بـاتا) الشهيرة، والتي كانت مغطية الإنتاج المحلي ويوجد فائض. كذلك صناعة القطن في صورة غزل ومصانع الغزل والنسيج المملوكة لرائد الأعمال خليل عثمان، تقف شاهداً. وحتى صناعة الملبوسات الجاهزة (سلوى بوتيك)، وصناعة الحبوب الزيتية، والعديد من الصناعات التي ازدهرت في فترة مبكرة، قد تكون حققت السبق على كثير من دول الجوار الإقليمي في المحيطين العربي والأفريقي، وكان من المفترض أن يكون السودان – بحكم التطور التاريخي- الرائد في اقتصاد المعرفة، نظراً لعراقة الجامعات والمؤسسات البحثية، خاصة في مجال البحوث الزراعية. ويبدو أن أزمة إغلاق طريق الشمال حققت المفاجأة الكبرى بأن معظم الصادرات السودانية من المواد الخام في صورتها الأولية كالجلود والحبوب الذيتية والقطن، وأعتقد أن هذا الأمر يحتاج لوقفة تأمل، من خلال البحث لمعرفة المعوقات التي أدت إلى توقف عجلة الصناعة وتأخرها. وكذلك تناول أمر ترقية وتطوير الصادرات، أو التطور الصناعي لكافة المنتجات الزراعية، من أجل الاكتفاء الذاتي، وإعداد إنتاج خاص بالتصدير؛ على أن يتم كل ذلك من خلال دراسات علمية رصينة، من قبل الباحثين المتمكنين في الجامعات، وعلى السادة في الجهاز التنفيذي الإقرار بأن ابتعاد المؤسسات البحثية في الجامعات وإعمال العلم في التنمية يمثل نتيجة واضحة وباينة وغير محتاجة إلى اجتهاد كبير لمعرفة الأسباب.
شارك المقال











