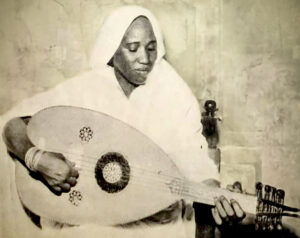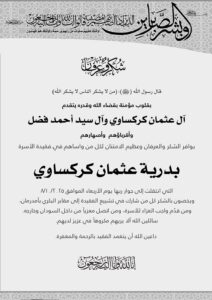أ. د. فيصل محمد فضل المولى
أكاديمي وباحث مستقل
مدخل تأملي: حين يتحول الغناء إلى مرآة وطن منكوب
• في تاريخ الأدب والغناء السوداني، لطالما شكّل الحنين للوطن تيمة مركزية، تُغنّى في الغربة وتُبكى في المنافي، وتُزرع في كلمات الشعراء حين تضيق بهم البلاد أو تبتعد عنهم القلوب. وبين هؤلاء، يبرز اسم الشاعر السر عثمان الطيب، كواحد من الأصوات التي جسدت شجن الغربة السودانية، لا بصخب المأساة، بل بلغةٍ ناعمة، متأملة، نازفة بهدوء.
حين أدّت الفنانة حنان النيل أغنيته “أحكام الزمن”، لم يكن البلد حينها قد دخل نفق الاحتراب الداخلي، ولا كانت العاصمة قد سقطت في يد المليشيات، ولا صار الخروج من السودان مرادفًا للنجاة من الموت. كانت الأغنية حينها صوتًا من الغربة إلى الوطن، تحمل الشوق، والوفاء، والارتباط بأرض الطفولة. لكن هذه الأغنية نفسها، حين يُعاد الاستماع إليها اليوم، في ظل الحرب الدائرة منذ أبريل 2023، تبدو وكأنها كُتبت للحظة نزيفنا الراهن: لحظة فقدنا فيها الخرطوم، وفقدنا فيها السقف، والماء، والمدرسة، والصديق، وحتى القدرة على الرجوع.
في هذه المقالة، نقرأ “أحكام الزمن” قراءة معاصرة، لا بوصفها قطعة فنية منعزلة عن الواقع، بل بوصفها نصًا ينطق بلسان المهجر، والمنفى، والنزوح القسري، ويضعنا أمام وجدان السودان الذي يُستنزف في كل الاتجاهات.
المنفى القديم والمنفى الجديد: من الغربة إلى التشريد
يبدأ النص ببيت يعكس فلسفة الغربة القهرية:
“ساقتنا الظروف يا صاحي
لي دار العذاب والغربة
فارقنا البلد نتباكي
أحكام الزمان صح صعبة”
الحديث هنا عن “الظروف” يبدو بسيطًا على السطح، لكنّه يحمل إدانة ضمنية للواقع القاسي الذي يجبر الناس على الرحيل. في زمن كتابة الأغنية، كان الرحيل إلى الخارج غالبًا مدفوعًا بطلب الرزق أو التعليم أو الخروج من أزمة اقتصادية. أما اليوم، فإن الظروف التي تسوق السودانيين إلى المنافي أكثر دموية وبشاعة. فالناس يُقذف بهم إلى خارج الوطن هربًا من المجازر، والاغتصاب، والنهب، والاعتقال، والموت البطيء في مدينة انهارت كل خدماتها.
لقد سُحِقَت الطبقة الوسطى، وهُجِّرت الأسر من منازلها، وسقطت أحياء بأكملها تحت نار القذائف، وأُفرغت المدارس من الأطفال، وتحولت العاصمة إلى مدينة للأشباح. حين يتحدث النص عن “دار العذاب والغربة”، فإن الصورة أصبحت اليوم واقعية لدرجة الخنق.
الطفولة في النص والواقع: وطن يبدأ من المهد
“من شفع صغار في الدنيا
يا دوب في المهد نتربى
ما فتنا البلد بالمرة
حبها قام معانا وشب”
يعبّر هذا المقطع عن عمق العلاقة بين الإنسان ووطنه منذ الطفولة، فالحب ينمو في الجسد مع اللبن، والهواء، والرمل، والماء. لكن في السودان اليوم، أُقصِيَ الأطفال عن أوطانهم قبل أن يعرفوها. ملايين منهم باتوا بلا مدارس، بلا بيوت، بلا ماء نظيف، ولا حتى ملاذ آمن من القنابل والقناصين. البعض منهم لم يولد في السودان، وُلد في خيمة على الحدود أو في نُزُل للاجئين. والبعض الآخر خرج مع والدته من الخرطوم بعد أن شاهد جثة والده على قارعة الطريق.
في ضوء ذلك، يمكننا القول إن حب الوطن لم يعد أمرًا فطريًا مضمونًا كما كان في القصيدة. بل بات سؤالًا مفتوحًا: كيف سينشأ هذا الجيل؟ وما الذي سيربطه بوطن لم يمنحه غير الخوف؟ ومتى نتمكن من إعادة بناء العلاقة بين الطفل السوداني وأرضه، بعد أن خربت السياسة والعسكر والمليشيات كل شيء؟
القرى التي تذوب في الذاكرة
“بي فوق البحر نتجاري
عاشرنا وبقينا أحبة
حارسين الجبابيد ديمة
نشرب من مياه العذبة
الطاهر جزيرة حليله
نسام العليل فاح هب”
الصورة هنا عن السفر الطوعي، و”نتجاري فوق البحر” توحي بالهجرة المنظمة، برحلة فيها نوع من الأمل والحميمية، حيث الغربة تقرّب بين السودانيين، وتجعلهم “أحبة”. لكن اليوم، البحر أصبح رمزًا للفقد والمخاطرة والتهريب. العبور منه لا يتم بالحقائب، بل بالموت في عرض المياه، في قوارب غير صالحة، مع أطفال ينامون في أحضان أمهاتهم ولا يصحون أبدًا.
أما “مياه العذبة”، فهي اليوم نادرة. عشرات الآلاف من الأسر السودانية تعيش في مخيمات لا تصلها المياه بشكل منتظم. “الطاهر جزيرة حليله” صارت رمزية لجزء من السودان الذي اختفى في الحريق الكبير، حيث لم تعد لدينا القدرة على التنفس حتى نسمع “نسام العليل فاح هب”.
أين هي القبة؟ وأين التبة؟
“نرميها ونقول لي بعضنا
تجمع قلبي فوق التبة”
في الذاكرة الجمعية، كانت “القبة” و”التبة” رمزين للبراءة، للألعاب الشعبية، للمرح البسيط الخالي من الخوف. هذه المشاهد اليوم اندثرت أو تحوّلت إلى رماد. التبة قد تكون اليوم موقع قنص، أو مكانًا لرمي الجثث، أو بقعة اختبأ فيها صبي من قذيفة.
لقد تحوّلت الفضاءات المفتوحة إلى مناطق خطر. حتى الحدائق، والمدارس، والمراكز الصحية لم تعد أماكن آمنة. لقد انكسر الفضاء الرمزي للطفولة، وانكسر معه معنى الحياة اليومية في السودان. ما عاد بالإمكان “نرمي القبة ونضحك”، فالضحك نفسه صار عملًا مقاومًا.
حنين مقيم في الخوف
“نرجع عاد متين لي بلدنا
يفرح عاد قلبنا الحبة
نيلا ولون نخيلها الزاهي
حفاه الأراضي الخصبة”
هذا الرجاء بالعودة، الذي يُغني به كل سوداني في المهجر، لم يعد مسألة عاطفية. صار ضرورة وجودية. لم تعد العودة مجرد “حلم”، بل أصبحت الشرط الوحيد للاستمرار في العيش بكرامة.
لكن “الرجوع” أصبح معقّدًا. فبعض اللاجئين لن يستطيعوا العودة لأن بيوتهم دُمّرت بالكامل. آخرون لا يملكون وثائق. البعض ممن غادروا إلى مصر أو تشاد لا يعرفون إذا ما كانوا سيعودون في العام المقبل أو بعد عشر سنوات. لقد تحوّل السودان إلى ما يشبه الوطن المؤجَّل.
“نيلا” اليوم ملوّث، “النخيل الزاهي” احترق في الجنينة، و”الأراضي الخصبة” في الجزيرة باتت ساحة قتال. ومع ذلك، فإن القصيدة، في إصرارها على وصف الجمال، تذكّرنا بأن السودان الذي نحلم به لا يزال ممكنًا، وأن الذاكرة الجمعية يمكن أن تكون جسرًا للعودة، لا مجرد رثاء لما فُقد.
الشعر كأداة مقاومة وبوصلة مستقبل
حين كتب السر عثمان الطيب “أحكام الزمن”، لم يكن يتنبأ، بل كان يعكس شعورًا عميقًا باللايقين، بالخذلان، بالحياة التي تقودنا إلى حيث لا نريد. لكنه وضع في قلب النص أيضًا مساحة للرجاء، للوصال، للحنين البنّاء. واليوم، حين نُعيد قراءة هذا النص، فإننا لا نراه فقط كأغنية، بل كـ وثيقة وجدانية تُحمّلنا مسؤولية إعادة صياغة الزمن نفسه.
ليس مطلوبًا من الشعر أن يوقف الحروب، لكنه قادر على أن يرمم أرواحنا المكسورة، ويحفظ ذاكرتنا من التآكل، ويعطينا لغة نقاوم بها النسيان، والخذلان، والانكسار.
صوت من الماضي ينطق بالحاضر
“أحكام الزمن” أغنية لم تُكتب للحرب، لكنها تصلح لكل سوداني مزقته الحرب. كل بيت فيها يذكّرنا بما كنّا عليه، وبما يمكن أن نكونه. وبين الخراب والشتات، تبقى هذه الكلمات مثل حَجَر صغير في القلب، نرميه في بركة الصمت، فنسمع صدى أرواحنا تقول: نرجع عاد متين لي بلدنا؟
ربما يكون الجواب معلقًا في زمن قادم. لكن حتى ذلك الحين، سنبقى نحمل هذه الأغنية كما نحمل الوطن في الحنايا — ثقيلًا، حزينًا، لكن حيًا لا يموت.
في واقع تغيب فيه الصور الجميلة، وتضيع التفاصيل البسيطة التي كانت تصنع السودان، تعيد لنا القصيدة شيئًا من الذاكرة المُنقذة. فهي لا تكتفي بإعادة رسم مشاهد الطفولة والحنين والماء العذب، بل تُعطينا نَفَسًا نحتاجه في زمن الاختناق الجماعي. إنها تذكّرنا بأن هناك وطناً آخر، لا يشبه مانراه اليوم في نشرات الأخبار أو على وسائل التواصل — وطنًا يسكننا، لا نحتاج لإذن عبور لنرجع إليه.
هذه الأغنية، رغم بساطتها، تفتح أمامنا أسئلة عميقة:
هل يكفي الحنين وحده لبناء وطن؟
هل نُسلّم ذاكرتنا للألم؟ أم نُحوّلها إلى دافع للشفاء؟
هل نكتفي بالبكاء على الأطلال؟ أم نعيد بناء القبة فوق التبّة مهما كانت الأنقاض؟
الجواب ليس في القصيدة وحدها، بل فينا جميعًا — في طلاب المدارس الذين يتعلمون في الخيام، في النساء اللاتي يطهون على نار الخشب في أطراف المدن، في المثقفين الذين يكتبون من المنافي، في الأطفال الذين لم يعرفوا بلدهم سوى عبر القصص.
إن إعادة قراءة “أحكام الزمن” اليوم ليست فعل حنين، بل فعل مقاومة ثقافية وإنسانية. إنها تذكير بأن ما خسرناه كثير، لكن ما نملكه من ذاكرة وعزيمة لا يزال كافيًا لنبدأ من جديد. وكما عبر الشاعر عن قسوة الزمن، فعلينا نحن أن نكتب، ونغني، ونبني، ونحلم، لنثبت أن هذا الزمن القاسي ليس نهاية التاريخ، بل لحظة في مسار شعب لم ولن يقبل أن يُكسر إلى الأبد.
لذلك، فلنحمل هذه الأغنية كراية، لا كمرثية.
ولنحوّل أحكام الزمن، من لعنة نُرددها، إلى مشروع نُغيّره.
فما ضاع وطنٌ، ما دام فينا من يُغنّي له… حتى لو كان بصوت مكسور.