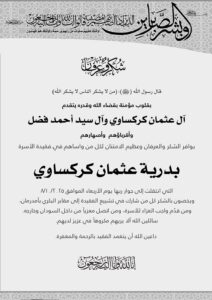يوسف عبدالرضي
شاعر وكاتب صحفي
• في زمن يركض بسرعة الضوء، لا أجد ملاذًا أصدق من الذاكرة. قررت أن أكتب، ولكن لن أتجاوز قرية ود المنسي، ولن أنتقي شخصيات ولا أماكن بعينها. سأكتب كما أتذكّر، كما عشت، وكما بقيت الذكريات محفورة فيَّ. هذه ليست كتابة عن التاريخ، ولا مذكرات، لأن التاريخ يتطلب دقّة وتمحيصًا ومراجع، وأنا لست من مصادر يعتمد عليها، ولم أحتفظ بما يؤهّلني لذلك.
إنها فقط محاولة لتوثيق ما بقي من صور وملامح، قبل أن تذروها رياح النسيان.
في إفريقيا، حين يموت عجوز، فكأنما احترقت مكتبة. هذا القول يلخّص الحقيقة التي نحياها في قرانا. كلما رحلت حبوبة أو جد، ضاع شيء لا يُعوّض من التاريخ، من القصص، من الطقوس، من المعارف الشفوية التي لا تكتبها كتب، ولا تحفظها مكتبات.
وهكذا، فإنني أكتب عن الطفولة… تلك المرحلة التي مهما كانت ظروفها، تحمل في داخلها أشياء جميلة. أشياء تبقى، وتشكّل وعينا الأول، وتؤسس لأخلاقنا وسلوكنا. الطفولة في ود المنسي لم تكن ترفًا، لكنها كانت مليئة بالمعنى.
في قريتي، كانت هناك طقوس اندثرت، وعادات بدأت تبهت، ووجوه غابت، لكن أثرها لا يزال حيًّا في الذاكرة.
أذكر جيدًا تلك اللحظات التي علقت في خيال طفل لم يتجاوز العاشرة، كان يجد المتعة في «المراسيل»، مع أن المسافات كانت طويلة، والطرق ترابية، لكن البساطة كانت سر السعادة.
كم كانت اللحظات عظيمة عندما تناديك بت المنصور قائلة:
• «تعال يا عينيّا، ودي الملاح دا لي أمك تضوقو».
أو حين تسمع صوت جدّك يصدح:
«أمش جيب لي كبريت من الدكان».
ولا شيء يضاهي تلك السعادة وأنت تقوم بتلك المهام الصغيرة، تشعر أنك مهم، أنك جزء من الحياة اليومية.
كنا نجلس على مسافة من الأعمام والخيلان وهم يتسامرون في الجلسات المسائية. كنا نستمع، نراقب، ونتعلّم دون أن نشعر. لم نكن نحتاج إلى معلم ليعلمنا الاحترام، فكل كبير كان «عمّك»، وكل امرأة «أمّك»، وتُحاسب إن لم تحترم ذلك العرف.
أتذكر جيدًا تلك الغضبة التي كانت تأخذنا عندما نُهمَّش من مهمة ما، أو لا يتم إشراكنا في «قِسمة»، رغم أننا نعرف أننا أطفال. كانت مشاعر الكرامة تنمو باكرًا فينا، وكأنها غريزة.
وفي كل سهرة، هناك طقوس:
إذا وجدت يوسف ود حمد، وفكي جبريل، وعز الدين ود أحمد الريح، وأبو تريمة مجتمعين، صباحية ما، اعلم أنك أمام لحظة من ذهب. لا تتجرأ أن تتكلم، فقط اجلس على مسافة قريبة، وأنت «ممسّح بالودك»، واسترق السمع.
حديثهم كان غامضًا أحيانًا، نضحك دون أن نفهم، ثم بمرور الزمن نفهم، ونتبسم كلما تذكرنا.
وإن أحسوا بوجودك، قالوا:
• «ها جَنة، أمش شوف الفطور، قضي!»
ترجع إليهم، وتقول بصوتك الطفولي:
«أمي قالت ليكم فطور الحلة جا… لكن عندها ملاح لوبيا قِرِب».
وهنا، تضحك أم حومد ود أحمد الريح وتقول:
«هَعْ… ساساي للضلع، وأسّاي طربًا باللوبيه ا!»
كأنما هي ترنيمة من الزمن البعيد.
كنا نعيش ببساطة، لكن قلوبنا كانت عامرة بالفرح.
احتفلنا بأبسط الأشياء، وابتكرنا الفرح من اللاشيء.
نساء تلك الفترة، نساء جميلات بالخلق والخِلقة، تركن بصمة باقية فينا لا يمحوها الزمن.
بنتا الريح، أم سترين، وآمنة، كانتا صاحبتي نكتة ومداعبة، وكلمات لذيذة لا تُنسى.
أذكر جيدًا تلك العبارة التي ما زالت عالقة في ذهني:
• «ها السَّعُوب دا!»
لا أعلم معناها الدقيق حتى الآن، لكن أظن أنها تعني «السعن اليابس»… ولو سألتها:
«السعن شنو؟»
حتماً كانت سترد عليك بعبارة فيها مزاح وتحذير.
أما بت المنصور، فكان لها حضور خاص. امرأة جميلة بأخلاقها، لا يُذكر اسمها إلا وقد ارتبطت في ذهني بصورتين:
عندما تكون العربية واقفة في الضل، أعرف أن عندها «بُكا» في معتوق أو اللعوته.
كانت تسرع دائمًا لإكرام «الشفع»، وكان الطعام لا يحلو إلا وهي تقول:
• «كل يا عينيّا».
نحن لم نحضر زمن «الأطفال»… كنا نُسمى «الجهّال» أو «الشفع»، وكنا نحب هذه التسميات، لأنها تحمل حنانًا خاصًا.
الحديث عنهن، عن تلك النساء، لا يكفيه مقال.
لكن كلما سنحت الفرصة، سأكتب عنهن.
فقد رحلت أمهاتنا، واحدة تلو الأخرى، لكنهن باقيات في القلب.
وأنا… أمهاتي كثيرات، من عمّتي فضله واسع، إلى أمي أم الكنن، إلى أمي عائشة جاد الله، التي أسأل الله لها الشفاء العاجل والعمر المديد.
ربما لم تكن المسافات تسمح بالحميمية مع بعضهن، لكن يبقين في القلب… وسيبقين.
وإلى أن نلتقي، إذا كان في العمر بقيّة…
شارك المقال