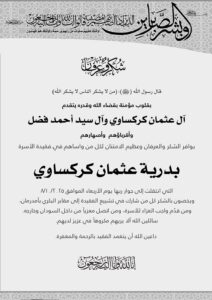د. طارق عشيري
أستاذ العلوم السياسية والدراسات الاستراتيجية في الجامعات السودانية
• منذ فجر الاستقلال، ظل سؤال الهوية في السودان يمثل معضلة كبرى، ألقت بظلالها على مجمل الحياة السياسية والاجتماعية والثقافية. فالدولة التي وُلدت في 1956 بمساحات شاسعة، وتعدد مذهل في الأعراق والثقافات والديانات، فشلت في صياغة مشروع وطني جامع، يحتضن هذا التنوع، ويصهره في بوتقة واحدة، مما جعلها تتأرجح بين صراعات دامية، وحروب أهلية، وانقسامات عميقة.
السياسة الاستعمارية البريطانية المصرية عمّقت الشرخ بين الشمال والجنوب، عبر ما عُرف بـ»سياسة المناطق المقفولة»، التي عزلت الجنوب والمناطق الهامشية عن المركز، وأوقفت التفاعل الطبيعي بين المجموعات المختلفة. هذا الإرث أورث السودان شعوراً بالتمايز والانعزال، وغرس الشكوك في النفوس، بحيث أصبح الولاء للقبيلة أو الإقليم أقوى من الولاء للدولة.
السودان بلد متعدد الأعراق؛ ففيه العرب والنوبيون والنوبة والفور والزغاوة والبجا والدينكا وغيرهم. غير أنّ الحكومات الوطنية المتعاقبة لم تُدِر هذا التنوع كقيمة مضافة، بل اختارت الهوية العربية الإسلامية كهوية رسمية، وهو ما أدى إلى تهميش بقية المكونات. هذا التحيّز صنع شعوراً عميقاً بالإقصاء، وحرم مجموعات واسعة من الإحساس بالانتماء الوطني المتساوي.
النخب التي تولت الحكم بعد الاستقلال لم تنجح في بناء مشروع وطني مشترك، بل استغلت الهوية كسلاح سياسي. فالبعض تمسّك بخطاب «العروبة»، والآخر رفع شعار «الأسلمة»، بينما لم يُعطَ البعد الأفريقي والتعدد الثقافي الاعتبار الكافي. هذا الفشل انعكس في اندلاع الحروب الأهلية في الجنوب سابقاً، وفي دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق، حيث تحولت الهوية من جسر للتواصل إلى وقود للصراع.
إدخال الدين في السياسة مثّل محطة فاصلة زادت الأزمة تعقيداً. فمحاولات فرض هوية إسلامية على مجتمعات تضم مسيحيين وأصحاب معتقدات أفريقية تقليدية غذّت الإحساس بالاغتراب، وأدت إلى تعميق الفجوة بين المركز والهامش.
إعلان قوانين الشريعة في ثمانينيات القرن الماضي، لم يكن مجرد تشريع قانوني، بل كان خطوة سياسية عززت الانقسام بين مكونات المجتمع.
غياب التنمية العادلة لعب دوراً محورياً في إذكاء أزمة الهوية. إذ بقيت الأقاليم البعيدة عن المركز (الشرق، الغرب، الجنوب سابقاً) محرومة من نصيبها في الثروة والخدمات، مما جعل سكانها ينظرون إلى الدولة ككيان غريب لا يمثلهم. ومن هنا نشأت هويات إقليمية بديلة، حلّت محل الهوية الوطنية الجامعة.
ظل السودان طوال تاريخه الحديث ممزقاً بين انتمائه العربي وانتمائه الأفريقي. هذا الجدل لم يُحسم، بل ظل يطفو على السطح في السياسات والعلاقات الخارجية والثقافة والتعليم، مما جعل هوية السودان «مزدوجة»، تبحث عن اعتراف خارجي أكثر من بحثها عن توافق داخلي.
إن جذور الأزمة السودانية ليست مجرد صراع على السلطة أو ثروة، بل هي أزمة عميقة في تعريف الذات الوطنية. فغياب مشروع وطني يقوم على المواطنة المتساوية والاعتراف بالتنوع، جعل السودان بلداً بلا هوية جامعة، مما مهّد الطريق للانقسامات والحروب. الطريق إلى الخروج من هذه الأزمة يبدأ بإعادة تعريف الهوية السودانية على أساس التنوع والاعتراف المتبادل، بعيداً عن الإقصاء والهيمنة، وبناء دولة تستند إلى المساواة والعدالة والتنمية المتوازنة.
رأيي حول الهوية السودانية إنّها واحدة من أعقد الهويات في أفريقيا والعالم العربي، لأنها نشأت في تقاطع طرق حضارية وثقافية كبيرة. السودان بلد متنوع عرقياً، إثنياً، ثقافياً ودينياً، وهذا التنوع كان يمكن أن يكون مصدر قوة ووحدة، لكنه تحول مع مرور الزمن إلى ساحة صراع سياسي واجتماعي، بسبب محاولات فرض هوية أحادية وإقصاء الهويات الأخرى.
الهوية السودانية في نظري يجب أن تُفهم على أنها هوية جامعة، ليست عربية خالصة ولا أفريقية خالصة، بل مزيج حضاري فريد، يعبّر عن الإنسان السوداني بخصائصه المتفردة: اللغة، العادات، اللبس، الغناء، التقاليد الاجتماعية، وحتى روح التسامح والكرم.
الأزمة التي عاشها السودان طوال تاريخه الحديث، مرتبطة بغياب هذا الفهم الجامع، ومحاولة ربط الهوية بتيار واحد (عروبي أو أفريقي أو ديني).
بالمحصلة، الهوية السودانية في رأيي يجب أن تكون هوية سودانوية؛ أي هوية جامعة، متصالحة مع ماضيها، مفتوحة على محيطها العربي والأفريقي، ومرتكزة على قيم الإنسان السوداني.
شارك المقال